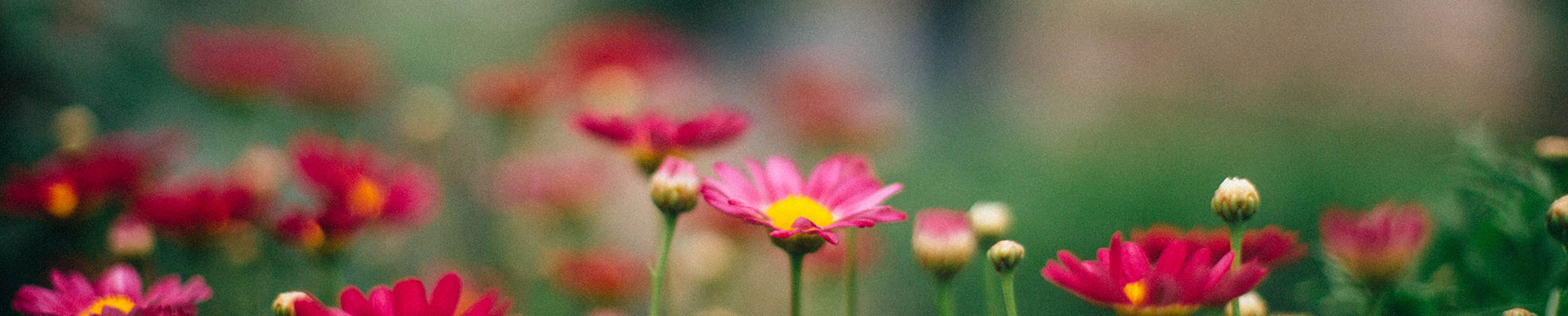
أبعادة العدالة لدى مؤسس الداهشية (2)
العدالةُ في الحكم
بقلم الدكتور غازي براكْس
العدالةُ لدى مؤسس الداهشية ذاتُ ثلاثة أبعادٍ رئيسة، هي العدالة في التعامل بين الناغس، والعدالة في الحكم، والعدالة بين الشعوب. وقد مهدتُ، في العدد السابق، بإيضاح نظام العدالة الإلهية الشامل في فكر الدكتور داهش، ونتائجه الظاهرة في أوضاع البشر، ثم فصلت مفهوم العدالة في التعامل بين الناس مركزًا على ثلاثة أوجهٍ منها تتمثل في عدالة التعاطي بين الرجل والمرأة وبين المرشد الديني والمؤمن، وبين المستثمرين والزبائن، ومبينًا أن العدالة في التعامل تقوم على أساسٍ عام هو الصدق بمعناه الواسع الذي يشمل الاستقامة والأمانة والإخلاص فضلاً عن الصراحة.
وفي هذا المقال سأتناولُ المفهوم الداهشي للعدالة في الحُكم من خلال الأنظمة السياسية، وسلطات الحُكم الثلاث، وأنظرُ في أساليب العقوبة، وواجب الثورة على الحكام الفاسدين.
الأنظمة السياسية
منذ صيف عام 1969 ، بدأ مؤسس الداهشية رحلاته حول العالم بغية تعرف الشعوب عن كثب في معالمِ حضاراتها، كما في عاداتها وأخلاقها ومحاسنها وسيئاتها؛ فزار مُعظمَ الدول في آسيا وإفريقيا وأُوروبا وأمريكا الشمالية، ودون رحلاته في سلسلة "الرحلات الداهشية حول الكرة الأرضية" في 22 مجلدًا. ومن خلال تعاطيه مع الأفراد والجماعات حيثما ذهب، تحصلت له خبرةٌ أيدت نظرته الثاقبة الصائبة المبنية على معرفته الروحية الخارقة. وفي مطلع عام 1982، إذْ كان في فندق بدفورد بباريس، كتب كلمةً انطوت على خلُلاصةِ نظرته في الأنظمة السياسية المهيمنة على العالم. وقد جاءَ فيها: في عصرنا الحالي لا تسمعُ إلا بالنظم الديمقراطية، والدكتاتورية، والرأسمالية، والاشتراكية، وسواها وسواها من المضحكات المبكيات على اختلاف اشكالها وألوانها واتجاهاتها. وقد سلبت من الإنسان روح إنسانيته بعدما أوقعته في شباكها اللعينة الكاذبة، وأسرته، فإذاهُ آلةٌ مسيرة غير مخيرة. لقد اصبح خاليًا من التعاطف والتواد والتراحُم والشعور الإنساني المتبادل بين الإنهسان وأخيه الإنسان.
فإذا لم ينبذ الجميعُ هذه العقائد الإلحادية القذرة، فسيبقون راسفين في قيودهم الشيطانية التي تشد على أعناقهم لتوردهم موارد التهلكة.
إن العودة إلى الدين هي طريقُ الخلاص للجميع، ففيه يجد الإنسانُ راحته وأمنه، وفيه يجدُ قلبه وقد اطمأن، وروحهن وقد استقرت.
إن الدين هو الطريق الوحيد الذي يقودُ إلى واحةِ الأمان والطمأنينة. فعليكم بالعودة إليه والسير في طريقه المستقيمة، لكي يكون معنى لحياتكم واستقرار لوجودكم الذي عصفت به المادية عصفًا مبيدًا.
فالحياةُ بدون القيم الروحية السامية جحيم مخيف رهيبٌ بنتائجه المزلزلة.
ماذا يمكننا أن نستنتج من موقف الدكتور داهش السابق من الأنظمة السياسية
المعاصرة، إذا استلهمنا نظرته الروحية الشاملة التي استمد منها موقفه؟
أولاً – إن الأنظمة السياسية لا معنى لاختلاف تسمياتها إذا اتفقت في نتائجها الوخيمة على الإنسان.
ثانيًا: لا يكون الإنسانُ إنسانًا إلا بقدر ما يتمتع بروحٍ إنسانية تتجلى في "التعاطف والتواد والتراحُم والشعور الإنساني المتبادل".
ثالثاً: البشرُ إخوةٌ في أسرةٍ واحدة، ويجبُ ألا يفصل بينهم لون أو عرقٌ أو معتقد أو قومية.
رابعًا: إن للأنظمة أشكالاً براقة تجتذب الإنسان في مراحل زمنية معينة، لكن هذه الأشكال البراقة ليست إلا شباكًا تأسره وقيودًا تكبل حريته الروحية، فيصبح عبدًا للنزعات المادية أو القومية أو العرقية. وبدل أن يساعد النظام الإنسان على تناميه وتفتحه الإنساني، يخنقه ويزرع الشقاء في نفسه.
بناء على ذلك يمكن أن يقاس صلاح نظام ما بقدر ما تتهيأ فيه ثلاثة عناصر هي الحرية والعدالة والروح الإنسانية. ولئن تهيأت الحرية والعدالة نسبيًا في بعض الأنظمة المعاصرة، فإن الروح الإنسانية مفقودة منها جميعًا فما ضمان إدخال الروح الإنسانية إلى النظام السياسي؟ في رأي مؤسس الداهشية الضمان الوحيد لذلك هو العودة إاى الدين؛ لا إلى قشور الدين وأعراضه المتمثلة بطقوسه وشعائره أو حدوده الاجتماعية التي أملتها الظروف المحيطة بنشأة الدين، بل إلى جوهره المتمثل بالقيم الروحية السامية. فالقشور والأعراض هي التي تفرق دينا عن آخر، والمغالاة في التشبث بها تؤدي إلى عصبيةٍ عمياء، طالما أضرت بالدين والإنسان، وطالما أشعلت الفتن والحروب؛ في حين أن الجوهر الروحي واحدٌ في الأديان كلها.
إذًا لا يدعو الدكتور داهش إلى جعل دينٍ معينٍ يسيطر على الدولة، فالدين الواحدُ، من حيث هو تنظيم بشري، ليس بإمكانه السيطرة على دولة ما إلا بأعراضه. وهذه الهيمنة، إذ حدثت، تجعل الحرية والعدالة في خطر، والمؤمنين بسائر الأديان والعقائد في مستوى أدنى. وبدل الأخوة الحقيقية الموحدة والمطمئنة، يقوم سيد ومسود، ومستثمر ومستثمر، ويشيع الشعور بالحرمان والظلم لجى الأقليات أو المستعفين، وهذا ينفي الحرية تدريجيًا ويقضي على العدالة والأمان.
خلاصة القول إن ما يدعو إليه الدكتور داهش هو جعل القيم الروحية أساسصا حيًا في كل نظام سياسي. والقيم الروحية نجدها في جوهر الأديان جميعًا فإذا خلا منها دين، فهو يبطل أن يكون دينًا حقيقيًا لفقدانه الهداية الروحية.
وفي نظام سياسي أساسه القيم الروحية، لا يكون الحاكم ولا المحكوم أسيرين للنزعة المادية التي تستهدف كنز الثروة على حساب حرمان الآخرين، ولا رهن النزعة المادية التي باسم الحرية تبيح كل محرمٍ وكل شهوةٍ بهيميةٍ مجاملة لكل حركةٍ تحررية إباحية متطرفة لا يفيدها وازعٌ ولا رادع.
وبما أن الأنظمة السياسية المعاصرة قد تساوت في سلبها "من الإنسان روح إنسانية"، فمن البديهي أن تصبح المفاضلة، لدى مؤسسة الداهشية، مقصورة على مدى توافر مقومات الحرية والعدالة في النظام. وعلى هذا الصعيد، سبق أن رأينا أن الديمقراطية الأمريكية كانت تستهوي مؤسس الداهشية منذ أكثر من خمسين سنة، أي مذ وضع كتابه "مذكرات دينار" في أوائل عام 1946.
وجدير بالذكر أن مفهوم الدكتور داهش للنظام السياسي العادل هو قريبٌ من فهوم المهاتما غاندي في الغاية التي يجب أن يهدف إليها، وهي حماية حقوق الإنسان الأساسية والعمل على تنميته الروحية. كذلك يلتقي مع أفلاطون وأرسطو في أن بناء الدولة يجبُ أن يقوم على الفضيلة، وعلى تشجيع المواطنين على طلبها وممارستها في تعاملهم. وبذلك يختلفُ مفهومُ الدكتور داهش للنظام السياسي اختلافاً أساسياً عن مفهوم الحكم الماكيافلي القائم، لا على الفضيلة والقيم الروحية، بل على المراوغة والبطش والقوة، واستخدام أقذر الوسائل وصولاً إلى الغاية.2
سُلُطاتُ الحُكمِ الثلاثاء
إن ما عاناهُ مؤسسُ الداهشية من ظلم طاغيةِ لبنان شحذ رأيه المبدئي الحاسِمَ في رفضِه لكل سلطةٍ مستبدة، لأن الاستبداد يؤدي غالبًا إلى ظلم الرعية. فالرئيس المستبد يجرفُه الصلفُ والتجبر إلى الطغيان، والطغيان يعني تخطي القوانين والدستور إن كان ثمة وجودٌ لها. وهذه التجربة تمثلت واقعيصا في ما يسمى بـ"ديمقراطية" لبنان عهد بشاره الخوري (1943 – 1952) الذي ما زال اللبنانيون يعانون عواقبه الوخيمة، لأن بذور الفساد التي زرعت منذ نصف قرن ما زالت تنمو وتعطي ثمارها المرة. فرئيسُ السلطة التنفيذية الذي يتجاوز صلاحياته، ويضرب بالدستور عرض الحائط، لا يكون رئيسًا ديمقراطية حقيقيًا، بل رئيسُ مستبد في نظام ديمقراطي لم تطبق مبادئه.
كذلك السلطة التشريعية إذا لم تؤد دورها مثلما يجب، تصبح مجرد واجهةٍ كاذبة لحكمٍ ديمقراطي كاذب.
فمجلس الأمة يجب أن يكون مستقلاً برأيه، معبرًا عن مصلحة الشعب، وصائنًا للحريات التي يضمنها الدستور، وليس خانعًا خاضعًا لنزوات الرئيس التنفيذي.
كما إن السلطة القضائية إذا لم تؤد دورها مثلما يجب، تغدو وسيلة قمع للحريات ووسيلة تعذيبٍ وإذلالٍ للمواطنين. وهذا ما وقع فعلاً في لبنان عهد بشاره الخوري الذي جعل القضاءَ أداةً طيعةً لتنفيذ مآربه الشخصية ومصالحه العائلية.
يقول مؤسسُ الداهشية في رسالته الأولى إلى الدكتور حسين هيكل، رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس الحزب الدستوري في الأربعينات:
إن الدستور اللبناني، يا أخي، أشبهه ببيتِ عنكبوت واهي الخطوط لا يقوى على مجابهة النسيم الخفيف خوفًا من تمزيقه، بل ملاشاته وذاك آثاره دكا. ومن العارِ أن نقولَ إننا شعبٌ ديمقراطي دستوري ما دُمنا لا نطبقُ القولَ بالفِعل، وما دامَ في لبنان ظلمٌ خطيرٌ هائلٌ كهذا.
كما إن المؤسف والمخيفَ جدًا هو عدمُ اهتمام النواب برفعِ حيفٍ صريحٍ كهذا! واأسفاه!
وبعد كل ذلك يتبجحون بالقانون، والدستور، والعدالة!...
حديثُ خُرافةٍ يا أم عمرو...
إنها كلماتٌ جوفاءُ لا معنى لها(... 9 ما دامَ القانونُ لا يطبقُ إلا بطريقةٍ كيفيةٍ تجر وراءها المآسي والكوارث وأخطر الأحداث.
أما السلطة القضائية في البلدان الراقية فقد أعلن الدكتور داهش بعض مهامها في رسالته الثانية التي رد فيها على رسالة الدكتور حسين هيكل المؤخرة في 9 أوغسطس (آب) 1951:
في كل البلدان الراقية يكون القضاء سياج الحريات المهددة من الحكام والمتنفذين، ويقف في وجوههم شاهرًا سيفه ذا الحدين لبتر رغباتهم ورد كيدهم إلى نحرهم، وانقاذ من يريديون افتراس حرياته، ودوس حقوقه، والاعتداء على حقه بباطلهم:
إذًا الديمقراطية لا تستتم معناها إلا إذا كانت السلطات الثلاث منفصلة، مثلما هي الحال في البلدان الراقبية، وقادرة على تنفيذ مهامها فغي حدود الصلاحيات الدستوريو المعطاة لها. أما أن يتضمن الدستور بنودًا تبقى حبرًا على ورق، أو لا ينفذ منها إلى ما يوافق مصلحة الرئيس التفنيذي، ففي هذه الحال لاغ معنى الدستور اللبناني تلقي التبعة على رئيس الجمهورية في حال خرقهالدستور، وتوجب محاكمته أمام "المجلس الأعلى". لكن "المجلس الأعلى" المنصوص عليه في المادة الثمانين من الدستور لم يرَ النور، ولم يجرؤ أحد من النواب على المطالبة بتنفيذ بنود الدستور كاملة.
نموذج الحاكم الفاضل
يقول الدكتور داهش، بلسان "الدينار" بطلِ قصته الفذة "مذكرات دينار".
دهشت كثيراً عندما شاهدتُ البساطة التي تمت بها مقابلتنا لجلاة الملك فيصل الأول (1883 – 1933 )، الديمقراطي الصحيح وابن الشعب، هذا الذي التفت حوله القلوب تفتديه بالمهج والأرواح، هذا الملكِ الذي يسير بين أفراد شعبه دون حاجةٍ لحراسته لأنه ليس له عدو يخشى منه على حياته الغالية على قلوب العرب.
من هذه الفقرة نستنتجُ عدة أمور:
الحاكمُ الديمقراطي، برأي الدكتور داهش، ليسَ من المحتوم أن يكون في نظام جمهوري. فرئيسُ جمهورية قد يكون حاكمًا مستبدًا مستبدًا، دكتاتورًا، وملكٌ قد يكون ديمقراطيًا صحيحًا. فالديمقراطي هو من يشعر أنه فردٌ من الشعب، يتحسس حاجات أبناء الشعب، ويشاركهم في ىلامهم، ويشعر بحرمانهم بحيث لا يكون له عدوٌ في الشعب، فيسير بين الناس دون حراسة. وهذا يُذكرنا بالخليفة العادل عمر بن الخطاب. فحيثما يشيعُ العدلُ وينتفي الظلم، يطمئن الناس، وتتجه قلوبهم إلى الحاكم.
لكن مثل هذا الحاكم، ملكًا كان أم رئيسًا تنفيذيًا منتخبًا، سواءٌ اختاره الشعب مباشرةً أم اختاره المجلس التمثيلي، لن يكون "ديمقراطيًا صحيحًا وحاكمًا فاضلاً ما لم يتمتع بنبلِ النفس وحميدِ الخصال؛ وهذا يوجبُ الترفعَ عن كل ما يغري من وسائل فيها كسبٌ لمغانم شخصية أو عائلية أو حزينة أو فيها حتى مجالٌ للتسلط على الناس. ولا يتم ذلك إلا بتواضُعٍ فطري في الإنسان. فإذا استحال على الحاكم أن يكون مثل غاندي، الإنسان الكامل، فيجب أن يتحلى، على الأقل، بالتواضُع والشعور الإنساني الصادق. فمن العسير جدًا أن يكون حاكمٌ "ديمقراطيًا صحيحًا" من غير أن يكون فاضلاً بمعنى من المعاني. فأن يعيش الحاكمُ عيشًا أرستقراطيًا باذخًا مُغرقصا في الرفاهية والترف، بينما يكون كثيرون من شعبه غارقين في الفقرة والبؤس، يُنافي روحَ الديمقراطية الصحيحة.
هذا يؤدي بنا مجددًا إلى ضرورة أن يكون نظامُ الحكم مبنيصا على القيم الروحية التي ينطوي عليها جوهرُ الأديان جميعًا.
لكن للحاكم الديمقراطي صورةٌ أخرى لدى الدكتور داهش، إنها صورة سعد زغلول (1857 – 1927)، رئيس الوزارة المصرية في العشرينيات من فترة الانتداب البريطاني الصعبة على مصر.
فمن خلال ما كتبه عنه الدكتور داهش في "مذكرات دينار" نستنتجُ أن قوة سعد زغلول مستمدة من حب الشعب له، ومن معالجته الأمور بحكمةٍ سياسيةٍ وروح وطنية حقيقية، كما من شجاعته في مواقفه ضد المتسلطين الإنكليز، وثباته في جهاده رغم العراقيل والمصاعب الكثيرة.
والشجاعة في مواجهة الأزمات مع الحكمة السياسية من أهم مزايا الرئيس نلاجح. وبهاتين المزيتين يمتدح الدكتور داهش الرئيس جون كِندي ولا سيما في معالجته قضية الصواريخ السوفياتية في كوبا.
واجباتُ السلطات العادلة تجاه الشعب
لقد رأينا أن النظام الصالح، في رأي مؤسس الداهشية، يمكن أن يقاس صلاحه بقدر ما يتهيأ فيه ثالوثُ الحرية والعدالة والروح الإنسانية، وأن أسس هذا الثالوث قائمةٌ في القيم الروحية السامية التي ينطوي عليها جوهر الأديان السماوية كلها، دونما تفريق بينها.
وبناءً على هذا الأساس الروحي تترتبُ على السلطان العادلة عدةُ مسؤولياتٍ تجاه الشعب:
أولاً – بما أن الحياة والحرية منحتان إلهيتان، وجبَ على الدولة العادلة، استنتاجًا، أن تصونَ سلامة الأفراد وتحافظ على حرياتهم، وتدفعَ كل خطرٍ أو ضررٍ قد ينهدد حياة المواطن أو ممارسة حرياته. ]أنظر أبعاد الحرية لدى مؤسس الداهشية"، صوت داهش"، عدد آذار (مارس) 1997[.
ثانيًا- صيانةُ الحياة والحريات، استنتاجًا، توجبُ على الدولة العادلة أن تسنَّ القوانين التي تضمنُ تلبية الحاجات الأساسية التي بدون إشباعها يُهددُ وجودُ الإنسان ماديًا أو معنويًا فالحاجاتُ الماديةُ الأساسية هي المأوى والمأكل والملبس والصحة، والحاجاتُ المعنوية التي بدونها لا يكونُ الإنسانُ إنسانًا هي الثقافة.
ولكي يستطيع المواطنون أن يقوم كل منهم بواجبه ودوره في تلبية حاجاته الأساسية المادية والمعنوية، يترتب على الدولة العادلة أن تضع أمامهم فرصًا متكافئة ليعملوا، ويحصلوا من أعمالهم ما يسدُّكلفة تلك الحاجات الأساسية. وإذا تعذر على فئةٍ من المواطنين لأسباب قاهرة، أن يسدوا حاجاتهم الأساسية بأنفسهم، فعلى الدولة العادلة أن تستلهم "الشعور الإنساني المتبادل". و"القيم الروحية السامية" في العطف عليهم ومساعدتهم.
وهذا الأمر يستلزم سن قوانين إنسانية، وقوانين تضع حدودًا لجشع التجار والمستثمرين، بحيث لا تكون الحرية الاقتصادية وسيلة لقتل الضعيف وتكثير الفقراء، وتوسيع الهوة بين الأثرياء جدًا والمعدمين. يقول الدكتور داهش، إذ يلاحظ فرقًا كبيرًا في ثمن سلعةٍ بين نيويورك وفرجينيا: "إنها سرقةٌ كبرى! في مثل هذه الحالة يجبُ على الحكومة أن تحدد الأرباح لهؤلاء التجار الجشعين". وكثيرةٌ هي تعليقاته على جشع التجار الأشعبي في رحلاته، حتى إنه يجعل هذا الجشع الحرام سببًا من أسباب الحروب التي تنكبُ الأغنياء أكثر مما تنكبُ الفقراء، فيوقل: "هي عدالةُ الله هذه الحروب الضروس التي تُفني الزرع والضرع فلو لم يستحق الناس هذه النكبا المزلزلة. لما أدبهم الله بنسبة استحقاقاتهم".
وبكلمة أخرى إن النظام الاقتصادي المنبع يجب ألا يُبعدَ الإنسانَ عن إنسانيته ويفقده جوهرة. فإذا كان هم الإنسان الأول التركيز على جمع المال وإنمائه، يُصبح قلبه حيث كنزُه، وتبتعدُ عاطفته حتى عن أسرته. وهذا الإدمانُ في تكديس الأموال، إذا أصبح غاية، يخدرُ ضمير الإنسان، ويدفعه إلى الجشع وبالتالي الظلم.
وفي مثل هذا النظام الرأسمالي الذي لا يضبطُه ضابط، يُصبحُ العمالُ والموظفون أنفسُهم مهددين أيضًا بالابتعاد عن الغاية الروحية، إذ يجعلون أصحاب رؤوس المال مثلهم العليا، يحتذون خطاهم، ويفرغونَ أنفسهم من الشعور الإنساني. وهذا يقودهم، في أكثر الأحيان، إلى التخلي عن عملٍ يحبونه ويجدون فيه عزاءً وتحقيقًا لذاتهم وتعبيرًا عن شخصيتهم، من أجل عملٍ آخر لا يحبونه، ولكنه يكون مصدر مالٍ أكثر لهم. والغايةُ الماليةُ قد تطيحُ بهم خارج الطريق القويم، فيلجأون إلى المحرمات والأعمال غير المشروعة، لأنها تدُّر عليهم مالاً أكثر في طريق أقصر. والمفاسدُ والشرورُ التي يتمخصُ بهما المال إذا أصبح غاية الإنسان العُظمى، أي معبودَه، عرضَها مؤسسُ الداهشية في كثيرٍ من كتاباته.
كذلك إذا حاصرَ الجهلُ فئةً من المواطنين، فإن مجالُ حرياتهم يضيق، كما يضيقُ مجالُ عملهم، وتكافؤ الفُرَص ينتفي، إذْ ذاك، أمامهم. بل إن الحرية الحقيقية في الاغختيار والتمييز بين الصالح والطالح، والخطأ والصواب، والحق والباطل، تُصبحُ بحُكمِ الملغاة.
ولذا شدد مؤسس الداهشية، في كتاباته كما في أحاديثه بمجالسه الخاصة، على أهمية العلم وجلال العقل وضرورة الثقافة وتوفير المدارس؛ وقد أيدَ أقواله بأعماله فأنشأ أكبر مكتبه خاصة في البلاد العربية (حوالى ربُع مليون كتاب)، وأنشأ متحفًا فنيًا يكاد يُضارع المتاحف الدولية الكبرى (وهو قائم في مدينة نيويورك). والثقافةُ الضرورية تشتملُ على مد المواطنين بالعلوم والآداب والفنون. فالعلومُ تُساعدُ على تنمية المدارك العقلية وتصويب المنطق، والآدابُ تُساعدُ على تنمية نزعات الخير وتهذيب النفس، والفنون تُساعدُ على تنمية حِسِّ الجمال لدى الإنسان ليُصبح قادرًا على إبداع الجمال أو تذوُقه، وعلى استشفاف مظاهر الجمال الروحي في كل إبداعٍ جميل، طبيعيًا كان أم إنسانيًا؛ ذلك بأن في كل جمال حقيقي ملمحًا من ملامح الألوهة يجذبُ الإنسانَ إلى فوق، إلى مصدر الحقِّ والخير والجمال.
ثالثًا- يتوجب على الدولة العادلة أن تختار ذوي الأخلاق الحميدة والنفوس النبيلة لتسنم المناصب الرفيعة. فالجدارةُ الثقافية والخبرة لا تكفيان وحدهما لتولي المنصب الرفيع؛ ذلك بأن أصحاب النفوس اللئيمة والأخلاق الوضيعة، إذا جعلتهم الظروفُ يحتلون المناصب العالية، لا يمكنهم أن يكونوا عادلين، لأنهم بتأثيرٍ من طبيعتهم الرديئة سيتصرفون. ومن واجب الحكام ألا يُفسِحوا الفُرَصَ أمام أمثال أولئك اللؤماء، لينزلوا الظلم بالناس. ويرى الدكتور داهش أن في رأس أولئك الموظفين القناصل والسفراء وممثلي الدول على مختلف الأصعدة. فالممثل مرآة لحكومته وأمته. ولذا يجب أن يكون من الطبقة الرفيعة في أخلاقه وآدابه كما في علومهن ومقدرته. فإذا لم تكن تربيته عالية، وتصرفاته نبيلة، وأقواله صادقة، سيرته ميوله الوضيعة وغاياته الشخصية الدنيئة.
كذلك من واجبات الحكومة أن تُطارد الفوضويين واللصوص والمجرمين وتطهر البلاد من شراذم الفجار والفاسقين، وتضع حدودًا خلقية للحرية حتى لا يكون مناخها المبارك موبوءًا بالجراثيم النفسية الفتاكة.
أما السلطة القضائية فيجبُ ألا تميز بين إنسان وآخر من حيث الغنى والفقر، أو الوجاهة والوضاعة، أو قوة النفوذ السياسي وضعفه؛ فجميعُ المواطين يجبُ أن يكونوا سواسية أمام القانون. والصورةُ الواضحة في كتابات الدكتور داهش في صورة العدالة في لبنان في العهد الخوري مقارنة بالعدالة في أمريكا. فالقاضي في لبنان هو رهنُ نزوات الرئيس التنفيذي وأعوانه، يجعلُ الأبيض أسود والأسود أبيض، يهشم القوانين ويرقصُ على أشلالها، يحكمُ حكمًا صارمًا على من يسرقُ الرغيف من أجل سد جوعه وجوع أطفاله، بينما يُشاركُ سارق الألوف والملايين في مغانمه الحرام؛ يتزلفُ للمرأة النافذة ويتملقُها، بينما يراودُ الفقيرة الضعيفة عن نفسها وبيتزها؛ فلبنان كان منكوبًا "بقضاةٍ مسخرين لارتكاب الآثام وطمسهم للحق وإعلائهم للباطل"12 أما القضاء في أمريكا فيقول عنه: "إن أغظم عظيم يتساوى ]فيها[ مع أحقر حقير، فلا سائد ولا مسود في كافة أرجاء البلاد...".
وفي رد على مقال كتبه الأديبُ اللبناني، القاضي راجي الراعي عام 1948، يحث فيه اللبنانيين على الرجوع إلى لبنان، يقول الدكتور داهش:
أيها (القاضي الراضي) الذي لا أدري
\كيف لم تبكَ (العدالة) المؤدة بإرادة (الغاصب)، بعدما شاهدته من الأحكام الجائرة.
والأمور القضائية (اللاعادلة)، وأنتَ ربُّها وربيبها، وأنتَ الناظرُ من وراء (روبك)،
ثوبك القضائي الأسود،
تلك المهازل التي تمثل كل يومٍ
بل كل ساعةٍ بل كل دقيقة،
والعدالة التي تنحرُ ليل نهار على وضح النهار لأجل تنفيذ رغبةى المسيطر،
وأنت الذي عرف وتأكد مقدار الأحكام الجائرة التي لفظها زملاؤك القضاة تحت سمعك وبصرك:
كيف يا (راجي) لا تريدني
أن أثمل من العظمة الأمريكية، هذه البلاد التي ولدت فيها أنت،
والتي هي مهد للحرية الفكرية!
نعم، أيها (القاضي العليم)،
لقد سقتني أمريكا خمرتها بكؤوسها العسجدية، فسجَدتُ أمامَ عدالتها الحقيقية، وبتُّ أندِّدُ بظُلمِ الباغية وارتكاباته الجنكيزخائية
أساليب العقوبة
يشير مؤسس الداهشية إلى أمرين مهمين يتعلقان بتطبيق العدالة هُما: ماهية الدافع إلى المخالفة والسجون.
ففي رأيه أن الدافع إلى الجنحة أو الجريمة يجب أن يكون له وزنٌ في تقرير نوع العقوبة. فاللصُ الذي يسرقُ بدافع الدناءة وحب الإيذاء يجبُ أن لا تساوى عقوبته بعقوبة الذي يضطر اضطرارًا، مثلاً، إلى سرقة صغيرة ليبعد شبح الموت عن ولده المريض؛ ففي الحال الأخيرة يجبُ اعتبارُ الحاجة الملحة المقرونة بعاطفة شريفةٍ هي الحافز على السرقة؛ كما يجب ألا تساوى عقوبة اللص المحترف بعقوبة تعلك التي تبتاعُ ما هي بحاجةٍ إليه وتنصرف بدون دفع الثمن من جرأة شرود ذهنها واضطراب نفسها.
وتطبيق القوانين في المحاكم كما بأيدي رجال الأمن يجب أن يقترن بالعطف والشفقة على الفقير والضعيف، لا سيما إذا كان المخالف غير مُدمن للإجرام أو المخالفة.
الأمر الثاني هو السجون وما يعاني المساجين فيها. وقد أُتيح المؤسس الداهشية أن يدخلها بريئًا، ويعاني، كما يعاينُ، الأهوال فيها. ففي 28 آب (أوغسطس) 1944 اعتقله زبانيةُ الجحيم اللبناني، وبدون محاكمة زجوا به في "سجن الرمل" اثني عشر يومًا، وبعدها أبعدوهُ قسرًا إلى دمشق فحلب فإعزاز على الحدود السورية التركية حيثُ أمضى أربعة أيام، قادوهُ بعدها إلى الحدود التركية ليعرضوه إلى القتل برصاص الحامية هناك. غير أن الله أنقذهُ وأعادَهُ سرًا إلى لبنان بعد شهرٍ واحدٍ من أقصائه. وقد فصل رجلُ الروح والخوارق مراحل المأساة التي عاناها وفنون التعذيب الوحشي الذي قاساهُ، من ضربٍ ولكم وشتمٍ ولذعٍ بالسياط... في كتابه "بريء في الأغلال أو يوميات سجين الغدر والخيانة ". ولم تنسه آلامه أن يصف ما كان المساجين المساكين يلاقونه هنا وهناك من فتكِ رجال الشرطة الأجلاف بهم، وأن يصف حياة المساجين البائسة التاعسة.
وكان أول ما صدمهُ في "سجن الرمل" غرفة الأحداث الجانحين، وذلك يوم الجمعة، في أول أيلول (سبتمبر) 1944. رآهم شبه عُراة، ضائعين، مهملين، تغمرهم القذارة؛ فتألم أشد الألم، وسجل ملاحظاته علىت قصاصاتٍ من الورق كان يُدونُ انطباعاته عليها خفيةً.
وفي اليوم الثالث من الشهر المذكور كتب قائلاً في صدد حال الأحداث: "إن السجون جعلت للإصلاح والتهذيب". ثم كتب:
من المعلوم أن السجون إنما وُجدت للتأديب، وليس للتعذيب.
فالداخلُ إلى السجن، مهما كان شأنه، يدخلونه رأسًا إلى الغرفة الخامسة. فترى فيها الشاعر والأديب، والتعاجر والعامل، والحمال وبائع السوس ، والنشال والفحام، وسالب الناس وقاطع الطريق، وشتى أصحاب المهن والحرف. وهذا خطأ فاحش من المسؤولين وممن بأيديهم مقاليد الأمور.
فالواجب والحكمة يقضيان على أرباب الأمر أن يفرزوا كل فرد مع فئته. فلا يجوز، مثلاً حشر الأدباء والشعراء في غرفة واحدة مع اللصوص والقتلة. وقس على ذلك.
فالفوضى ضاربة أطنانها بصورة مخيفة. والحابل تراه مختلطًا بالنابل. والعياذُ بالله!
هذه هي كلمتي أضعها في كتابي هذا كي تبلغ من يهمهم أمر الإصلاح. هذا إذا كانوا يريدون الإصلاحَ لا الفوضىى والانتقام.
إن هذا الأمر لرهيبٌ إذا كان ذلك الشاعرُ أو الأديبُ من المجرمين حقيقة؛ فكيف إذا كان بريئًا، ولعله يريدها أصحابُ المناصب زُجِّ بمَن قادهُ سوءُ مصيره بين أيديهم، فدفعوهُ هم بدولرهم إلى هذه الغياهب الدائمة العذاب.
ثم من الواجب أن تكون هناك أماكنُ خاصة يوضع فيها المتهمون دون أن يختلطوا بالمجرمين، حتى إذا ما دانهم القضاء، وقيلت فيهم كلمةُ الفصل النهائية، إذ ذاك يتصرف بهم الظالمون كيفما يشاؤون وتشاءُ رغباتهم وميولهم الانتقامية.
ومَن يُنعمِ النظرَ في الملاظات السابقة يُدرِضك أن مؤسس الداهشية إنما أعطاها منطلقًا من قاعدة العدالة ومن مبادئ عِلم النفس الإجرامي. فالسجونُ التي يجب أن تكون للتهذيب والتأديب، جعلها الحكام الوصوليون للانتقام والتعذيب، وحشروا فيها الأبرياء مع المجرمين، والمتهمين المنتظرين صدورَ الأحكام مع المحكوم عليهم، غير مكترثين بالآلام والجروح النفسية البالغة التي يحدثها السجنُ الاعتباطي في النفوس الحساسة أو البريئة وفي 8/9/1944، أي اليوم السابق لإبعاد الدكتور داهش قسرًا عن لبنان، عثر حراس "سجن الرمل" على منشار في فراش أحد المساجين، فسكبوا على جسمه صفيحة ماء، وجلدوه جلدًا هائلاً، ثم وضعوه في زنزانةٍ منفردة. فهال الأمر رجل الروح، فكتب معلقًا: هل بلغت القسوةُ والفظاعة بهؤلاء درجة يأنفُ أن يأتي بمثلها الوحوش!" ثم أردف قائلاً: " أيجري مثل هذا ونحن في عصر الحرية والنور! أيجري مثل هذا ونحنُ في القرن العشرين!"
وكأنما يريد أن يثبت أن حُكام تلك الدول الغاشمة وموظفيها الممالئين إنما يعيشون بأجسادهم في القرن العشرين، في حين أن عقولهم وطباعهم ما زالت تنتمي إلى عصور الهمجية. كذلك يستشف من تعليقاته أنه يجعل الدول الراقية المتبجحة، عهدئذٍ، بأنها تحارب من أجل تحرير الناس من الخوف والظلم والعوز ومن أجل تطبيق شرعة حقوق الإنسان – يجعلها مشاركة في المسؤولية عما يجري في البلدان المتخلفة وسجونها من استباحةٍ لكرامة الإنسان وللأعراف الدولية.
أخيرًا يجدرُ بالذكر أن عقوبة الإعدام محظرة في العقيدة الداهشية بناءً على أمر روحي أساسُه أن واهبَ الحياة وحده له حق استردادها. وإذا كان لا بد من عقوبةٍ قصوى، فلتكن السجن المؤبد مقرونا بالتهذيب والإصلاح الروحي المبني على إيضاح ناموس السببية الروحي.
الثورة على الحكام الفاسدين ضرورةٌ محتومة
اقتراف الحاكم للظلم رأسُ المفاسد التي تستدعي الثورة عليه. عام 1933، كتب الدكتور داهش "حلم غريب" وقد بناهُ على تورية، إذ جعل ديموقليس، الخطيب، يخطب في الشعب معلنًا نبوءته لما سيقع للحكومة. ومن الواضح أنه كان يقصدُ الدولة المصرية في العهد الملكي وما ارتكبته من مظالم. كان المؤلف عهدئذٍ، في الرابع والعشرين، والرسالة الداهشية لم تؤسس ولم تعلن بعد؛ ومع ذلك فنظرتُه الروحية الخارقة كانت واضحة. مما يقولُ على لسان ديموقليس:
يا مَن بيدِكُم مقاليدُ الأمور،
إن الشعبَ اختاركم
لتحكموا بينه بالعدل أحكامًا عادلة،
لا أن تكونوا جلاديه(...)
أنظروا إلى التاريخ القريب،
لا، بل إلى (الثورة الفرنسية)
التي التهمت الأخضر واليابس(...)
أخبروني أين هو الباستيل،
رمزُ الجبروت والقوة الغاشمة؟(...)
أيتها الحكومة! ايمعي (نبوءتي) الصادقة:
"إن الظلم والإرهاق اللذين تزرعينهما اليوم، ستحصدينهما غدًا: ثورةً وانقلابًا.
وفي امبراطورية روسيا المسكينة، لكِ خيرُ شاهد...".
ولا تقتصرُ مفاسدُ الحكام الذين يستحقون طرد الشعب لهم على الظلم فحسب، بل تشملُ أيضًا، برأي مؤسس الداهشية، عدة أمور، منها: الفسق، السرقةُ من خزينة الشعب، استغلال النفوذ للاستفادة المالية، تقريبُ الحاكم لأقربائه حتى لو كانوا أغبياء، وتحكيمهم برقاب الناس، خرق الدستور بتجاوز الفصلاحيات المصوص عليها في بنوده، تسخيرُ القوانين وتأويلها لمصلحته الشخصية أو مصالح أعوانه، تزويرُ الانتخابان التدخل في أحكام القضاء، سجن المناوئين أو غتيالهم الخ... كل من هذه المفاسد تستحق الطرد، وقد جمعها بشارة الخوري كلها في شخصه.
يرى الدكتور داهش أن "التاريخ يعلمنا أنه ما من ظالم غاشم إلا ولاقى شر الجزاء الرهيب..." وعلى الصعيد الروحي، يستشهد بقول المسيح:
"بالكيل الذي تكيلون يكال لكم ويزاد". وهو يذكر المظلومين بـ"أن الحق يؤخذ ولا يستجدى"، وبأنه "ما من حق ضاع ووراءه مطالب، لأن صاحب الحق لا يعدم نصيرًا؛ وإن عدمه كان الله نصيره".
وفي العقيدة الداهشية أن على الداهشيين أن يكافحوا الظلم بجميع الوسائل، وأن الثورة على الحكام الطغاة أو الفاسدين واجبة، وأنه إذا حدث مثل تلك الثورة، تكون إصبع الروح القدسية هي التي حركتها، ليستقيم ميزان العدالة الروحية الشاملة.
ولكن يجب الانتباه لأمر في غاية الأهمية هو أن الثورات بحد ذاتها لا تكون بالضرورة عاملاً للتقدم الحقيقي في المجتمعات البشرية؛ والتاريخ حافلٌ بالأمثلة على الفظائع التي تتمخضُ الثورات بها. حسب القارئ أن يعتبر بذيول الثورة الفرنسية والثورة البلشفية، وهما أعظمُ ثورتين في التاريخ. لكن الثورات وسيلة بشرية ضرورية يتخذها مجرى العدالة الإلهية. والأخذُ بمنهج غاندي السلمي في الثورة على المظالم والمفاسد هو الأفضل. ووحدها تعاليمُ الأنبياء والهُداة يمكنها أن تغير المجتمع تغييراً إيجابيًا وتدفعُ به صعدًا في معراج الرقي الروحي، إذا اعتنقها الناسُ صادقين، فأثرت في سيالاتهم (أي طاقاتهم النفسية) وغيرت نزعاتهم؛ (إن الله لا يُغيرُ ما بقَومٍ حتى يُغيروا ما بأنفسهم) (سورة الرعد:11)
والحكمُ أو السيادة كالثورة بين يدي الإنسان، قد يكون تجربة له كما قد يكون استحقاقًا. فإما أن ينجح فيكون عادلاً وفاضلاً، فيكافأ، وإما أن يفشلَ فيظلم ويأتي الشر، فيعاقب عقابًا شديدًا.
وفي رأي مؤسس الداهشية أن مَن لا يستطيعُ إسماعَ صوته في وطنٍ وئدتِ العدالةُ فيه وافترسَهُ الظلم، فهجرتثه إلى بلادٍ تُصانُ فيها الحريات أولى به. يقولُ في مقالٍ كتبه عام 1948، وقد أشرنا إليه سابقًا:
إنني لن أشتاق إلى وطنٍ تنحرُ فيه الحرية، وتذبح الحقيقة، وتُداسُ بين ربوعه العدالة، وتُهشم بين سمعه وبصره الكرامة، وتكبلُ بين جدران سجونه القاتمة الحريةُ الفركية بزج أدبائه وشعرائه وأبريائه مع محترفي الإجرام لأنهم جاهروا بحرية أفكارهم التي تشجبُ جرائم المالكين سُعداء لزمنٍ محدود".
من كلمات الدكتور داهش
- إن العودة إلى الدين هي طريق الخلاص للجميع ففيه يجد الإنسان راحته وأمنه، وفيه يجد قلبه وقد اطمأن، وروحن وقد استقرت.
- ومن المعلوم أن السجون إنما وجدت للتأديب وليس للتعذيب.
- الحياة بدون القيم الروحية السامية جحيم مخيف رهيب بنتائجه المزلزلة.
- صاحب الحق لا يعدمُ نصيرًا؛ وإن عدمه كان الله نصيره.
- إن السجون جُعلت للإصلاح والتهديب.
- الحقُ يؤخذ ولا يستجدي.
الدكتور داهش والفنَ
طوني شعشع
شغل الدكتور داهش منذ أمدٍ بعيدٍ، وما يزال، أقلام الدراسيين والأدباء والصحافيين، فكان موضوعًا لمقالاتٍ ودراساتٍ ومصنفاتٍ كثيرة تناولت سيرته وأدبه وفكره. إلا أن ثمة بعدًا بارزًا من أبعاد شخصيته لم يحظ منهم بالعناية الوافية، ولم يتعد كلامهم عليه الإشارات السريعة؛ نعني به البعد الفني.
ولعل السبب في مجانبتهم إياه أن مؤسس الداهشية لم يفرد مؤلفًا مستقلاً يعرض فيه نظرته إلى الفن أو الفنانين أو المدارس الفنية، بل نثر آراءه في مواضع شتى من مؤلفاته، وبخاصة في سلسلته الشهيرة "الرحلات الداهشية حول الكرة الأرضية" – الأمر الذي يستدعي تقصيها وتصنيفها واستخراج الدلالات منها. زد أن أكثر تلك الآـراء قد ظهر متأخرًا، ومنها ما لم يصدر بعد.
ولعل السبب أيضًا غفولُ الباحثين عما للفن من شأنٍ في حياة الدكتور داهش، أو إيلاؤهم إياه قيمةً دون قيمته الحقيقية، يسوقُهم إلى ذلك أن أثره في الشأن الأدبي غيره في الشأن الفني؛ فهو في الأول مبدعٌ، وفي الثاني جامع. وجلي، بعامةٍ، أن ما يبدعُه الإنسان ألصَقُ بنفسه مما يقوم بجمعه، فإذا الأنظار تتجه إليه أولاً. ولكن يجب ألا يستهان بما جمع فهو قد يرفدُ الباحث بما يُعينه على استجلاء الأثر الأدبي، دع أنه صادرٌ عن نظرةٍ خاصةٍ يمكن الاهتداء إليها بعد استقرائه كله. على أن غرضنا في هذه الدراسة مقصورٌ على مقام الفن في حياة الدكتور داهش، أولاً، ثم على نظرته إليه، ثانيًا. ولا يفوتُنا أن ثمة موضوعاتٍ أخرى متصلة بهما تقتضي معالجةٌ مستقلة، منها موقفه من الفنانين والمدارس الفنية، ومنها آراؤه في المتاحف الفنية التي زارها.
مقام الفن في حياة الدكتور داهش
يرجع شغف الدكتور داهش بالفن إلى مرحلةٍ باكرةٍ من عمره. فهو يقول: "منذ طفولتي وأنا أتوق لمشاهدة أي شيء يمثله الفن، سواء أكان لوحةً زيتية أم مائية أم بالباستيل، كما أرغب رغبةً عارمة بالتماثيل الفنية..." ويؤكد ذلك في موضعٍ آخر، فيقول: "فأنا أحب الفنون الجميلة منذ نعومة أظفاري". وللقارئ أن يسأل: كيف تأتي لطفلٍ نشأ في بيئةٍ فقيرة لا تفتقر إلى الثقافة الفنية فحسب، بل إلى الثقافة عمومًا، كما أن عهده بالمدارس لم يتجاوز أشهر أ – كيف تأتي له أن يشغف بالفن ويرغب فيه "رغبة عارمة"!"
هل سر ذلك ميل فطري متأصل في كيانه، على نحو ما عبر هو نفسه عنه؟ فهو يقول: "فحب الفنون الجميلة يسري في دمائي..." ولكنه يذهب إلى أبعد في وصف علاقته بها فيقول: "فـ]الفن[ لي كالروح للجسد". والحق أن هذا القول غني بالدلالات. فإذا صح أن علاقة الروح بالجسد علاقة جوهرية، وأن ما ينشأ عن اتحادهما ذات واحدة متكاملة القوى، فلا أبلغ من هذه الصورة لبيان مبلغ الاتحاد القائم بينه وبين الفن! وإذا كانت الروح علة دوام الجسد وعلة حياته، فقد لزم أن الفن علةُ دوام الدكتور داهش وعلةُ حياته. تُرى هل في هذا القول مغالاةٌ أدبية؟
لم يكن الدكتور داهش بغافلٍ عما يعتور الحياة الدنيا من شقاء وشرور؛ وهذه مؤلفاته الأدبية تنصحُ بالبرم بها. فإذا لم يكن الفن ما سوغ له البقاء على قيد الحياة، فقد كان، ولا ريب، عاملاً رئيسًا في تلطيف شفائها وتجميل قبحها.
وما دام الأمر كذلكن فليس غريبًا أن يكون شغفُه به لا حدود له. يستشهدُ الدكتور داهش بقول الإمام علي بن أبي طالب: "منهومان لا يشبعان: طالبُ علمٍ، وطالبث مال". ثم يُردِف قائلاً: "وأزيدُ عليهما ثالثًا، فأقول: "وطالبُ فن" – الذي هو أنا. فإني، وأيم الحق، لا يمكن أن أشبع نهمي من الفن إطلاقًا". ويقول له الدكتور جورج خبصا، رفيقه في رحلته الأولى حول العالم عام 1969: "أنتَ لا يمكن أن تُشبع نهمك من التحف واللوحات الزيتية". ولما برر تأخره عن موعدهما معًا بأنه تاه عن الفندق، قال له الدكتور خبصا: "أنت لم تته عن الفندق، بل الكنوز الفنية هي التي جعلتك تتيه...".
هذا الشغف اللامحدود بالفن كيف تجلى في حياة الدكتور داهش؟
1 – اقتناء المصنوعاتة الفنية:
لقد تجلى، أولاً في سعيه الحثيث الباكر إلى اقتناء المصنوعات والمنشورات الفنية حتى إنه لا يجد حرجًا في القول إنه وقف على ذلك عمره كله: "لقد صرفتُ أعوامَ عمري بأكملها باحثًا منفيًا وجامعًا للكنهوز الفنية النادرة". أما شروعه تجمع اللوحات الفنية فيجعله في عام 1930، أي في مستهل عقده الثالث. ومما نُقل عنه أنه شاهد في إحدى المجلات. وهو بعد حدثٌ، صورة لوحةٍ بريشة الفنان الفرنسي ج. ف. روتج G.F.Rotig تمثل أسدين متحفزين متربصين بقطيع غزلان، فاقتطعها منها، واحتفظ بها نيفًا وعشرين عامًا. وفي مطلع الخمسينيات. أرسل الصورة المقتطعة إلى الفنان الفرنسي نفسه طالبًا إليه رسمها له ثانية، ففعل.
ولقد أثر عن الدكتور داهش أنه كان رحالة لا يستقر له في وطن قرار. طوف ف شتى أقطار العالم وفي راس أهدافه اثنان: الأول زيارة المتاحف الفنية والتمتع بما فيها من معروضات والثاني ابتياع ما أمكنه من اللوحات والصنائع الفنية. فهو يقول: "إنني أسافر بقصد زيارة المتاحف ومشاهدة الكنوز الفنية المحفوظة فيها... وكل ما يمت إلى الفن بصلة أود مشاهدته، وأرغب في اقتنائه". ومَن يطالع سلسلة مؤلفاته "الرحلات الداهشية حول الكرة الأرضية"، يتبين له أن ذينك الهدفين قد تساوقا في رحلاته الأولى، ولكنهما تفاوتا في رحلاتن المتأخرة، فغلب الثاني الأول حتى كاد يستقل بالرحلة المتأخرة: "أمضيتُ هذه المدة الطويلة ]80 يومًا[ في البحث عن اللوحات الزيتية النادرة والتماثيل الفنية الجميلة. وابتعتُ عددًا كبيرًا منها...".
ويمكن تعليل ذلك بأنه في رحلاته المتأخرة قد زار بلادصا سبق أن زارها مرارًا وتمتع بمشاهدة متاحفها حتى بات في غنى عن تكرار زيارته إياها.
أما إذا اتفق أنه لم يزر ذلك البلد أولاً، فإنه لا يتوانى عندئذٍ عن زيارة متاحفه، وكأنه في إحدى رحلاته الأولى. ويمكن تعليل ذلك أيضصا بأن شغله الشاغل في أخريات أيامه بات إغناغء المتحف الداهشي" بلوحاتٍ وتماثيل جديدة. لذلك اقتصر في رحلاته المتأخرة – إلا نادرصا – على زيارةى المتاجر الفنية وصالات المزاد لابتياع اغلمصنوعات الفنية. وإنه لحسن بنا الوقوف قليلاً عند هذا "المتحف"، لأنه في رأينا أستطع تجل لشغف الدكتور داهش بالفن.
2 – المتحف الداهشي
لا نعلم يقينًا متى روادت مؤسس الداهشية فكرة إنشاء متحف خاص، لكن الثابت أنه باشر تنفيذها جديًا منذ أواخر الأربعينيات، وذلك في أثناء احتجاجه القسري ببيروت إثر الاضطهاد الجائر الذي أنزله به رئيس الجمهورية اللبنانية بشاره الخوري (1943 – 1952)، وما نجم عنه من انتزاع جنسيته اللبنانية اعتسافًا. وقد دام ذلك الاحتجابُ ما يُنيف على ثماني سنوات (منذ أواخر عام 1944 إلى أوائل عام 1953، حيت استرد جنسيته السليب)، ثم عقبه احتجابٌ إرادي – إذا صح التعبير – دام حتى عام 1958.
ثلاثة عشر عامًا من الاحتجاب أتاحت للدكتور داهش أن يراسل آلاف الفنانين والمتاجر الفنية في مختلف أقطار العالم بحثصا عن الصنائع الفنية. لنسمعه يقول: "يومذاك]عام 1949[كنتُ في منزل الأخ جورج حداد، عديل الشيخ بشاره الخوري، رئيس الجمهورية اللبنانية، ومنه كنتُ أراسل الآلاف من الفنانين وغالريهات الفن المختصة ببيع اللوحات الزيتية ومكتبات الكتب النادرة، بينما كانت الحكومة اللبنانية تظن أنني قد رحلتُ من عالم الأرض إلى عالم الخلود".
على أن الدكتور داهش لم يكفَّ، بعد خروجه من احتجابه، عن مواصلة بحثه عن التحف الفنية، سواءٌ بالمراسلة أو بالسفر، حتى آخر لحظةٍ من حياته.
لقد تسنى له أن يجمع حتى عام 1976 ما يناهز "2500 لوحةٍ زيتيةٍ رائعة ومئاتٍ من مختلف أنواع التماثيل الفنية الثمينة، الرخامية والبرونزية والخشبية والعاجية... ولما اشتد أوارُ الحرب اللبنانية عامذاك، استطاع إنقاذ "هذا التراث الجبار" بنقله إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث أتيح له عام 1995 أن يعرض في متحف قائمٍ بقلب مدينة نيويورك، أطلق عليه اسم Dahesh Museum .
لقد كان "المتحف الداهشي" أحد أحلام الدكتور داهش الرائعة. ولشد ما كان يتمنى أن يراه بعينيه وقد أنشئ. ولعله كان مرتابًا من تحقق أمنيته، فقال في 18 نيسان 1976: "تعرى هل سيتاح لي أن أعرض اللوحات في متحف أطلق عليه اسم "المتحف الداهشي" في نيويورك؟ إن هذا الحلم رائع، حلم فاتن أخاذ، إذا تم. ولكن دونه صعوباتٍ كبيرةً... فهل يقدر لي في حيات أن أشاهد هذا المتحف، أم إنها أضعاث أحلام وأخيله أوهام؟".
3 – الإخراج الفني لمؤلفاته:
لم يقتصر شغف الدكتور داهش باغلفن على اقتناء كل صنيع فني في سبيل إنشاء "المتحف الداهشي"، بل تعداه إلى إنتاجه الأدبي أيضًا. كان حريصًا على طبع مؤلفاته طباعة فنية مزينة بلوحاتٍ تناسب النصوص، منها لوحاتٌ عالمية مشهورة، ومنها ما كان يُملي موضوعه على الفناني. يقول الدكحتور داهش بهذا الصدد: "أنا أطبع مجموعة كتبي طبعًا فاخرًا، ليس للربح المادي إطلاقًا، بل حبًا بالفن والأناقة".
وبحسبنا أن نقف ههنا قليلاً عند كتابين له تميزا بطباعتهما الفنية الأنيقة حتى ليصح القول إنهما أثران أدبيان متحفيان. أما الأول، فكتاب "ضجعة الموت"، باكورة مؤلفاته المطبوع، وقد وقف على طبعه في القدس عام 1936. لنسمعه يحدثنا عنه عام 1980، حين دفع مؤلفه "قيثارة الآلهة" إلى الطبع:
"في مطلع عام 1936 طبعتُ كتابي "ضجعة الموت" بمطبعة شنلر الألمانية بالقدس، وكانت حينذاك أهم مطبعةٍ في الشرق.
وكنت قد عثرت على فنان إيطالي اسمه موريللي بالقاهرة، فكلفته أن يرسم لي رسوم كتابي "ضجعة الموت". والحقيقة أنني لم أعجب بمقدرة هذا الفنان، وكنتُ أود أن أعثر على فنانٍ يفوقه بالإبداع.
وقد خرج كتابي "الضجعة" بحلةٍ أنيقة قشيبة مدهشة. والحق الذي يجب أن يقال إنه بعد مرور أربعةٍ وأربعين عامًا على طبعي لهذا الكتاب لم يطبع كتابٌ آخر سواه يكون بمستواه الفني بين مئات الآلاف من الكتب التي طبعت بجميع البلاد العربية. إذ طبع بأغلوان أربعة طباعة أنيقة للغاية. وقد خطه الخطاط المشهور نجيب الهواويني، والخطاط محمد حسني. والورق صقيل، ومن النوع الممتاز للغاية. وتجليده فني، وأناقته مثلى".
أما الكتاب الثاني فالجزء الأول من "جحيم الدكتور داهش" الذي ألفه عام 1942، وفيه يصف خمسين دركًا من دركات الجحيم مفردًا أربع سداسيات مسجعة لكل منها. وقد طلب إلى الفنان الروسي كوروليف أن يرسم لكل سداسيتين لوحةً مستوحات منهما. وهكذا، فقد حظي كل درك بلوحتين معبرتين عما فيه من صنوف العذاب. كما قام الخطاط نجيب الهواويني أيضًا بخط الكتاب. وقد أصدرته "الدار الداهشية للنشرط بنيويورك عام 1989 في طبعةٍ ثانيةٍ مجلدة ومزينة بـ 140 لوحة في قطع عملاق (42 سم × 32 سم).
نظرةُ الدكتور داهش إلى الفن
1 – النقل عن الطبيعة:
يبدو واضحًا أن الدكتور داهش، في نظرته إلى الفن، أقرب إلى النظرية الأفلاطونية الآرسطية القائلة إن الفن محاكاة الطبيعة Mimesis فهو يقول: "الفنانون ينقلون مواضيعهم عن الطبيعة. فالطبيعة التي خلقها الله لا يجاريها مجارٍ. إنها من صنع الله، وكفى". وعندما يطالعه في الطائرة مشهدُ غروب الشمس، يصفه وصف لوحةٍ فنية حية، ثم يعقب عليه بالقول: "ولا حاجة بين إلى القول إن هذه النيران التي كانت تبدو للعيون الناظرة ما هي إلا وهج الشمس الجانحو للمغيب وقد رسم هذا التابلو السحري الخيالي. فيا لقدرة المبدع!".
يفهم من هذين النصين أن الفنانين يتطلعون إلى تقليد الطبيعة، صنيعة الله. فكأنه تعالى الفنان الأعظم، وكأنهم، إذ يبدعون، يحاولون مجاراته تعالى في فعل الخلق. إلا أنهم، أوتوا من موهبةٍ وبراعة، مقصرون عن ذلك جبرًا. ذلك أن في أشياء الطبيعة من الخصائص والملامح والدقائق ما يستحيل على الفنان الوقوف عليها كلها أو نقلها إلى صنيعة. ثمة أطراحٌ في كل محاكاة، أي عجزٌ عن المجاراة التامة. ولعل السبب الكياني الأخير لذلك كمالُ المبدع، ونقصُ المقلد.
وعليه، فيقدر ما يكون الصنيعُ الفني أقرب إلى الطبيعة وأشد نبضًا بالحياة، يكون أدنى إلى الكمال وأعظم قيمةٌ فنية. يعجب الدكتور داهش، مثلاً، بلوحةٍ تمثل شابًا في مقتبل العمر، فيقول: "أنتَ تحسبُه حيًا تنبضُ الحياةُ فيه، وتاسرك نظراته الحية فتظنُ أنه يكاد أن يخاطبك!" وتروقه لوحة تمثل منظرصا طبيعيصا فيه "بحيرة تكاد تروي غليلك من مائها السلسبيل!" ويؤخذ بتمثال إلهةٍ "لا يمكن أن يكون أبدعُ أو أروع منه... كأنها امرأةٌ يسير الدم في شرايينها..." والأمثلة على ذلك كثيرة.
إلا أن مفهوم النقل أوسع من مفهوم التقليد؛ فهو يحتويه ويتجاوزمه في الآن نفسه. التقليد أقرب إلى النسخ. وهما (أي النسخ والنقل) يختلفان في جملة أمور.
يختلفان أولاً في حدود المطابقة. ذلك أن النسخ يستوجب التطابق التام بين المنسوخ والمنسوخ عنه. والدكتور داهش يستخدمه في معرض كلامه على نسخ اللوحات الفنية. أما النقل فيفيد، أيضًا، معنى الاقتباس من غير اشتراط التاطبق التام. ثمة قدر من الحرية في النقل لا يجوزه النسخ. إلا أن ذلك القدر محدود بهوية المنقول عنه. قد يقتبس الفنان صورة من الطبيعة، ويتصرف بها، فيبتكر صورًا جديدة ليس لها على الأرض ما يقابلها، ولكن في حدود لا يجوز تعديها لئلا ينقلب النقل إلى تشوبه.
دعْ أن النسخ ينفي – أو يكاد – كل أثر ذاتي في المنسوخ. أما النقل فيتسع له، ولكن في حدود أيضًا. ولعل حمل النقل ههنا على معنى الترجمة – وهي من معانيه في اللغة العربية – يزيدُ الأمر وضوحًا. ذلك أن الناقل (أي المترجم) لا يسعه إلا أن يبث شيئًا من ذاته في النص المنقول، وبخاصة إذا كان أدبيًا، وقد يتصرف به. لكنه ملزمٌ، في شتى أحواله، بالتقيد بالمعاني المنقولة خشية أن يتهم بالتحريف.
تخلصُ من ذلك كله إلى أن نظرة الدكتور داهش إلى الفن لا تقتصر على الاتجاه الكلاسيكي الأكاديمي – على عظيم شأنه عنده – بل تشتمل أيضًا على الاتجاهات الفنية المعتدلة، كالاتجاه الانطباعي مثلاً. كما إنها لا تنحصر في الموضوعات المستمدة من الحياة الواقعية، بل تتعداها إلى الموضوعات الفردوسية والميثولوجية وسواها.
2 – النفاذ من الطبيعة إلى ما بعدها:
بيد أن الأشياء في الطبيعة، كما يرى الدكتور داهش مجاريًا أفلاطون، ظلال أو أوهام تقوم حقائشقها في غير عالم الأرض. ومن كلماته بهذا الصدد: "نحن ظلال سرعان ما تمر في وادي الحياة وتتلاشى. ومنها: "جميعُ ما تقع عليه العين وهم من الأوهام". فهل يذهب مؤسسُ الداهشية مذهب فيلسوف الأكاديمية القاتل إن الصنيع الفني ظل الظل، يندرج في المرتبة الثالثة من مراتب الوجود؟
ليس في كتابات الدكتور داهش ما يشير إلى ذلك. والأغلب، في رأيه، أن الفنان الأصيل إذ يحاول محاكاة شيء ما إنما يحاول النفاذ منه إلى حقيقته في عالمٍ ثانٍ – وقد يقوم بذلك من غير علمٍ به. يؤيد ذلك، عنده، أن الذات الفنية في كيان الفنان – إذا صح التعبير – تنتمي، في الأصل، إلى عالمٍ مادي يفوق الأرض درجةً روحيةً – وهذا ما سيأتي إيضاحه. فهو يولد على الأرض وفي نفسه تهجع صور عالمه العلوي. فإذا نقل عن الطبيعة شيئًا ما خلع عليه ما ماثله من تلك الصور، فجاء صنيعه أقرب إلى ما هو عليه في عالمه. ذ
ويندرج في هذا السياق ما يمثل العوالم الفردوسية في الصنائع الفنية – وقد كان مؤسس الداهشية مولعًا بها، فكان يطلب إلى الفنانين أن يرسموا له ما كان يتمثله منها. وتعليل ذلك عنده أنه كان يعاني على الأرض غربة روحية، كأنه في "منفى"، فلا يني يحن إلى موطنه في عالمٍ آخر: "أنا غريبٌ في هذا العالم. وكم أحن إلى تلك الساعة التي أعود فيها إلى وطني الحقيقي!" ولكن ما وطنه؟ وأين يقوم؟ هوذا يحدثنا عنه: "هناك وراء المجرة الأزلية تتهالك المسافات وتفنى الأبعاد. فمن كتب له أن يجتامها، يجد فردوسًا عجيبصا كونه الله لمختاريه الأبرار الأطهار. فإلى هذه الفردوس الدائم المتع والبهجات سأعود". فكان الدكتور داهش، إذ يشاهد الموضوعات الفردوسية في الآثار الفنية، "يتذكر" وطنه الفردوسي البعيد على نحو ما يفهم أفلاطون بالتذكر Reminiscence .
3 – مقومات الصنيع الفني:
إذا صح أن النقل عن الطبيعة أصلُ الصنيع الفني، فما هي مقوماته الجوهرية؟
يقول الدكتور داهش في معرض موازنته بين متحفي واشنطن واللوفر: "هذه اللوحات العظيمة هي تراثٌ للإنسانية يتناقلها الخلف عن السلف لنرى ما بلغه الفن من رقي وما سجله من حوادث تاريخية بارزة نستطيع مشاهدتها عيانًا بأسلوبٍ حي فيه متعة، وفيه جمال، وفيه حقيقة ما أجدرها بالبقاء في عالمٍ كل ما فيه صائرٌ إلى زوال".
ينطوي هذا النص على فكر متعددة، منها نظرية النقل، وإنسانية التراث الفني، والتطور الفني عند الشعوب. إلا أن ما يهمنا فيه الآن مقومات الصنيع الفني، وهي ثلاثة: المتعة، والجمال، والحقيقة. ولما كانت المتعة حالة نفسية تنشأ من الإحساس بالجمال أو من سواه، فقد أمكن حصر المقومات هنا باثنين فقط: الجمال والحقيقة.
والحق أن الاقتران بين مفهومي الحق يقة والجمال في فكر الدكتور داهش ليس شأنًا عارضًا؛ فهما متلازمان. فهو يقول في توطئة كتابه "ضجعة الموت": "مَن أدرك سر الجمال، فإنه قد خطا خطواتٍ واسعةً في فهم أسرار الأزل والخلود.... ومَن كان بعيدًا عن حب الجمال، فإنه لا يفقه معنى الحياة، ولا النهاية المجهولة". ويصور لنا في كتابه "الإلهات الست" شابًا حزينًا تتجلى له فينوس، إلهةُ الجمال، وتحاول إغراءه بمباهج الدنيا، فيعرض عنها ناشدًا الحقيقة المفقودة على الأرض. ويطول الحوار بينهما بلا طائل. وأخيرًا تعلن إلهةتُ الجمال يأسها من إدخال البهجة إلى قلبه. ثم يموت الشابُ ويتجسد في فردوس النعيم حيث يجتمع "بـ(الحقيقة) التي كان يبحث عنها، فإذاها وقد اتخذت لها جسد فينوس المبدعة الفتنة والمذهلة الأنوثة".
يتحصل لنا مما تقدم أن بين الحقيقة والجمال، في فكر الدكتور داهش، وشائحج قوية: فإدراكُ كُنه الجمال مدخلٌ رئيسٌ إلى معرفة الحقائق الميتافيزيقية، أو الحقيقة الروحية بمعنى عام، حتى إذا بلغها طالبثها في العالم الثاني، وجد أنهما (أي الحيقة والجمال) واحد. وعليه، فمن لوازم هذه النظرة الميتافيزيقية أن يندرجا في مقومات الفن الأساسية. ولكن ما معناهما في الصنيع الفني؟
يمكن تعريف الحقيقة، عند الدكتور داهش، في المجال الفني بأنها دلالة الأثر الفني على واقعةٍ محسوسة أو تاريخية أو أسطورية... من غير أن ينطوي مفهوم الدلالة على معنى المطابقة. ذلك أنها (أي المطابقة) تختلف في مجال الفن عما هي عليه في مجال العلم. ولذلك، صح الترادف في مجال الفن بين الحقيقة والمعنى، فلا ينطبق على الأثر الفني معيارُ الخطأ والصواب انطباقه على الواقعة العلمية. فإذا قلنا إن صنيعًا فنيًا يشتمل على حقيقةٍ ما، فمفادُ ذلك أنه ذو معنى أو مدلولٍ أو موضوع.
وبتعبيرٍ آخر نقول: ينجطوي الصنيعُ الفني، في رأي الدكتور داهش، علت خصائص فنية من جهةٍ، وعلى موضوع أو مدلولٍ من جهة ثانية.
وعنده أن شأن الموضوع أو المدلول في الأثر الفني لا يقل عن شأن التقنية الفنية حتى إنه لا يتردد أحيانًا في تقديم الأول على الثاني. فقد يتفق أن يكون الأثر الفني ذا قيمةٍ فنية واضحة، ولكن موضوعه لا يروقه. يزور ذات يوم مبنى في باريس تُعرَض فيه اللوحات المعدة للبيع بالمزاد، فيقول: "وقد شاهدتُ اللوحات بقاعة هذا المبنى الفسيح ولم أعجب بأية لوحةٍ على الإطلاق. فاللوحات فنية، ولكن مواضيعها لم ترقني قط".
أما الجمال في الفن فيمكن فهمه، عند الدكتور داهش، من خلال الاقتران الذي يقيمه بين فن الموسيقى وفني الرسم والنحت. فهو عندما يتحدث عن إعجابه بلوحاتٍ للفنان ليسون فريدريك، يقول: "في هذه اللوحات قوة فنية بادية للعيان؛ فهي موسيقى للبصر ومتعة منشية". وفي معرض إعجابه بالتماثيل المنصوبة أمام مدخل قصر بطرس الأكبر بلينغراد، يقول: "وأمام مدخل القصر نصبت عشراتُ التماثيل الفنية المذهلة، وجميعها موشاةٌ بالذهب الخالص، وتنبثق المياه من أفواهها، فتؤلف سمفونية بصرية لا مثيل لها". فما معنى قوله: "موسيقى للبصر و"سمفونية بصرية"؟
لعل أبرز مقومات الجمال في الموسيقى أن يتوافر فيها تآلفُ الألحان، وإلا انقلبت إلى جلبة أو ضوضاء. وعليه، فلا بد من توافره في الأثر الفني المرئي، أيضًا، كيما يتصف بالجمال. تروق الدكتور داهش إحدى اللوحات في المتحف الوطني بطوكيو، فيقول: "إن هذه اللوحة تزخر بالحيوية والانسجام...". ومما يقوم عليه الانسجام التناسب والتكامل في الأثر الفني عمومًا. ومنه، أيضًا توزيع الألوان في اللوحة الفنية: "وقد وزع الفنان ألوانه على لوحتع بطريقةٍ جاءت آيةً في الفن والإبداع".
يلزم مما تقدم أن للعقل أثره في كل صنيعٍ فني، وأن للجمال الفني – مثله في ذلك مثلُ الحقيقة – شروطًا موضوعية تتجلى في ما يدعوه الدكتور داهش "الفن الأصيل". وهي لا تخضع للأهواء والميول، ولا تؤثر فيها عوامل غريبة عنها. الإجماع على الباطل، مثلاً، لا يقلبه حقًا. كذلك الأمر، فإن إجماع الناس أو اتفاق أكثرهم على ما لا تتوافر فيه شروط الفن لا يجعله فنًا، وإن جارتهم في ذلك السلطة السياسية. وليس غريبًا، وقد رى الدكتور داهش أن الاتجاه الفني السريالي يقلب المفاغهيم، ويعصف بها عصفصا مأكولاً، أن يحمل عليه حملةنً غايةً في العنف حتى إنه لم يتورع عن الحكم عليه بأنه "جنون العصر..." وذلك بالرغم من طغيان أسماء "كبيرة" كبابلو بيكاسو Pablo Picasso وبول كلي Paul Klee وسواهما"، وبغلرغم من هيمنة ذلك الاتجاه على عصر "أصبحت المقاييسُ فيه منكسةً رأسصا على عقب".
في ضوء ذلك كله ندرك لماذا يؤثر الدكتور داهش الفن الواقعي إيثارًا مطلقًا. لنسمعه يقول في لهجة الجازم الواثق من نفسه: "إن الفن الحقيقي هو "الرياليسم" – أي الفن الواقعي. فأنت ترى لوحةً تمثل حقلاً تملأه أزهارُ البرية السحرية أو تشاهد لوحة تتويج الإمبراطور نابليون بونابرت... إنها لوحة واقعية لا خلاف عليها. بينما إذا صورها أحدُ السرياليين اليوم، فإنه يضعُ شحطاتٍ ونقاطًا وخرابيش، ويقول لك إنها تمثل الإمبراطور نابليون ومَن معه. حقًا إنها مهزلة لا تعلوها مهزلة. وللغاسف ثمة من يصدقها ويؤمن بحقيقتها، وهي وهمٌ بوهم، بل أُضحوكةُ الأضاحيك".
ولكن يبدو أن الدكتور داهش يفهم بالفن الواقعي أكثر مما تعنيه المدرسةُ الواقعية. فهو عندما يقول: "أنا مغرمٌ" بل مدلهُ بحب اللوحات الزيتية ذات الموضوعات الواقعية"، لا يعني فقط الموضوعات المقتبسة من واقع الحياة الأرضية فحسب، بل الموضوعات التي تحمل دلالة ما سواءٌ أكانت مقتبسة منه أم لا. يؤكد ذلك إعجابه بفنانين ينتمون إلى المدسة الانطباعية والمدرسة الرومنطيقية وسواهما. زد إعجابه الشديد باللوحات ذات الموضوعات الأسطورية، وقد حفل بها "متحفه".
ولكن هل اقتصرت مقوماتُ الصنيع الفني عنده على عنصري الحقيقة والجمال؟
إذا كان الفنُ مجاراة القوة المبدعة في فعل الخلق، فلا عجب أن يعد الدكتور داهش الفن العظيم البالغ الإبداع "فنًا علويصا". فهو يقول بعد زيارته متحف فيلا بورغيزي بروما: "لقد بهرنا من روعة الفن العظيم الذي لا يعلو عليه إبداع مطلقًا... تستمتع بروعته العيون، وتجتليه النواظر وهي خاشعة لهذا الفن العلوي الذي يأخذ بمجامع القلوب". وعليه، فلا بد من أن ينطوي "الفن العظيم" على عنصر علوي لا يثير في النفس المتعة الفنية فحسب، بل الخشوع أيضصا. ولكن ما هو هذا العنصر العلوي؟
يقتضينا الجوابُ عن هذا السؤال الرجوع إلى عقيدة الدكتور داهش الروحية، وبخاصة نظرية السيالات فيها. ولا يتسع المقام ههنا لتفصيل الكلام عليها، دع أنه ليس من اليسير توضيحها. بحسبنا القول إن السيالات، في العقيدة الداهشية، أشبه بالنفوس الجزئية المنبثقة من الروح الكلية عند افلوطين. إلا أنها لا تنبثق من روحٍ كلية مجردةٍ واحدة، بل من أرواحٍ متعددة تقوم في عالمها المفارق. وتختلف السيالاتُ، بعضها عن بعض، بالوع والدرجة. كما إنها تتوزع في شتى العوالم المادية، المعروفة والمجهولة، فتحل في الأجسام والمواد على اختلافٍ في العدد. فكأنها (أي السيالات) أشعةٌ مختلفة منبثقة من شموس متعددة، تنفذ إلى المنازل والكهوف والإوار، وتتعاقب عليها، لكنها تظل موصولة أبدًا بمصدرها. على أنه لا يمكنها أن تعاودَ الاندماج به إلا إذا بلغت من الصفاء ما يؤهلها لذلك.
وما العنصر العلوي في البآثار الفنية العظيمة سوى أثرٍ من آثار نوع من السيالات يدعوه الدكتور داهش "سيال الفن"؛ وقد زود به الفنانون. هذا السيال ينتمي، في البأصل، إلى عالمٍ أو عوالم تفوق الأرض درجة روحية، وفي قصة "الحلم الهابط إلى أرض البشر" ما يوضح ذلك.
يستفاد من هذه القصة أن ثمة كوكبًا يدعى "كوكب النور الوضاء" وفيه "نقطن أرواح عباقرة الموسيقيين الذين تركوا لعالم الأرض تراثًا إلهيًا من الأنغام". كما إن ثمة كوكبًا يُدعى "كوكب الخلود الباهر" وفيه "تقطن أرواح الأدباء والشعراء". وعندما تعتزمُ أحلام، بطلة القصة، مغادرة عالمها العلوي إلى الأرض لتولدَ فيها، يرافقها أحد الملائكة، ويزودها "بسيالاتٍ من الموسيقيين والأدباء وأرباب الفنون الجميلة". ويُقال لها إنها عند بلوغها فتوتها لا بد من أن تشعر برغبةٍ مُلحة في الموسيقى والأدب. لكن جسدها الترابي يحول دون تذكرها سر تلك الرغبة البعيد.
وقياسًا على ما سبق يمكننا القول إن للرسامين والنحاتين عوالمهم العلوية’ وإن الموهوبين منهم على الأرض مزودون بسيالاتٍ منها تتجلى آثارها في صنائعهم الفنية، وتحمل المرء على الخشوع أمامها. وهذا ما يسوقنا، أخيرًا إلى السؤال الآتي: هل للفن غرض خلفي عند الدكتور داهش؟
لا يبدو إطلاقًا أن للفن عنده غرضًا تبشيريًا أخلاقيًا مباشرًا. بحسبنا أن نعرض موضوعات اللوحات والمنحوتات في "متحفه"، فتتحقق من ذلك. ثم إنه (أي متحفه) يكاد يخلو من معروضاتٍ ذاتِ موضوعاتٍ دينية. على أن هذا لا ينفي أن يكون لذلك العنصر العلوي أثره غير المباشر في تهذيب النفس والسمو بها فوق مستوى الأرض، ولعلهما الغرضُ الأخير لكل صنيعٍ فني أصيل.
تلك كانت دراسةٌ موجزةٌ في بعض الجوانب الفنية من حياة مؤسس الداهشية وفكره. ولسنا ندعى أننا استوفيناها. فإن ما قمنا به جهد أول في هذا المضمار، له ما لكل جهدٍ أول من فضل الريادة، وعليه ما عليه من عثراتها أو غفلتها. وإلى ذلك كله، فالدراسة أقربُ إلى التأمل الشخصي منها إلى المعالجة الأكاديمية العلمية.
أبعادُ العدالة لدى مؤسس الداهشية(3)
العدالة بين الشعوب
بقلم الدكتور غازي براكس
بدأتُ، في العددين السابقين من "صوت داهش"، بإبراز نظام العدالة الإلهية الشامل الذي بُنيت عليه أبعادُ العدالة كلها في المفهوم الداهشي؛ وبعده تناولتُ العدالةَ في التعامل بين الناس مبينًا أبرز أوجُهها أي عدالة التعاطي بين الرجل والمرأة، وبين رُعاة الدين والمؤمنين، وبين المستثمرين والزبائن؛ بعدئذٍ عالجتُ العدالة في الحكم موضحًا رأي مؤسسٍ الداهشية في الأنظمة السياسية، وفي سلطات الحكم الثلاث، وأعطيتُ نموذجًا مُعاصرًا للحاكم الفاضل، ثم أوضحتُ واجباتِ السلطات العادلة تجاه الشعب، ورأي الدكتور داهش في أساليب العقوبة كما في ضرورة الثورة على الحكام الفاسدين. أما فيب هذا العدد فسأتناولُ المفهومَ الداهشي للعدالة بين الشعوب، وبه أختمُ أبعاد العدالة لدى مؤسس الداهشية.
الحروب: أسبابها وعواقبها البوخيمة
تطبيقُ العدالة، في رأي الدكتور داهش، يجب أغلا يقتصر على العلاقات القائمة بين السلطة الحاكمة والمواطنين في دولةٍ ما، بل يجبُ أن يسود العلاقات بين الدول، فلا يبقى في العالم شعوبٌ مسيطرة مستعمرة وشعوبٌ مسودة مستعمرة. وفي كتابات مؤسس الداهشية كثيرةٌ هي الإشاراتُ إلى الكوارث والويلات التي تتمخض بها الحروب. ومآسي الحرب العالمية الثانية يجدُها القارئ منتثرةً في قطعه الوجدانية، بدءًا من مطلع عام 1941. ففي "استقبال عام 1942" يقول:
لقد جال الحديدُ في العام الماضي، فهدم البنيان ودك أسس العمران،
وأطلق شياطينه المرعبة تفتكُ بأشلاء الإنسان!.. وبين هذا وذاك كنتَ تسمع أنينَ
البائسين.
وصراخَ الثكالى والميتمين... والحرب الهدامة تضحك من هذا،
وتقهقهُ من ذاك...
ولهيبها الجهنمي يزدادُ استعارًا...1 وتقهقهُ من ذاك...
ولهيبها الجهنمي يزداد استعار...
وفي "استقبال عام 1945"2 يتعجب من رجال الحرب وهم "يمثلون ويرقصون" على أنقاض عالم مهدم فقد فيه الأمن، وقامت في كل بيتٍ مناحة، وعم الشقاء، وتصاعد عويلُ الثواكل إلى أبراج السماء، وهيمن البؤس والهلع...
وأسبابُ الحروب، في رأي الدكتور داهش، تعودُ جميعها، في نهاية التحليل، إلى المطامع الأشعبية، مهما حاول القادةُ أن يموهوها بإلباسها شعاراتٍ وغاياتٍ شريفة3. والتاريخُ يؤكد رأيه. فالحروبُ الصليبيةُ نفسها كانت تعبئ وتحركُ جنودها المغانُم المنتظرة. حتى مجاري العنجهية العنصرية أو العقائدية تصبُّ في مطمع الاستيلاء على مزيدٍ من الأراضي والمغانم. وأبرزُ مثل لذلك ادعاء هتلر أنه أشعل الحرب العالمية الثانية دفاعًا "عن الحق الصريع... وعن العدالة المهيضة الجناح"، في حين أن الحقيقة العارية أعلنها بقوله أيضًا "إنه لا يقبل أن يسام الشعبُ الألماني عذاب الحرمان في مجاله الحيوي... وإنه لن يرضخ لما تريد بريطانيا فرضه من السيطرة على العالم وحصولها على حصة الأسد".
لكن دافع المطامع قد يتعزز أحيانًا بردةِ فعلٍ انتقامية، ذلك بأ، لكل شعبٍ نفسية أو سيكولوجية خاصة تحددها عدة عوامل، منها التاريخية والحضارية والبيولوجية والبيئوية. وهذا ما حدث للشعب الألماني في نهضته السريعة بعد الحرب العالمية الأولى، وإيقاده الحرب العالمية الثانية. يقول الدكتور داهش موضحًا هذا الأمر بلسان جلبرت، أحد أبطال قصته:
إن الأمة الخاسرة تحمل في نفسها حقدًا هائلاً، وتصبرُ على جرحها المُميت كالأسد الجريح. وتمضي الأعوامُ وهي تنتظر الفرصة المؤاتية كي تنقض على الدولة التي أصابت منها مقتلاً؛ تلك الدولة التي أذلتها في كبريائها، وحطمت من عنفوانها، وهزأت بها أمام الدول الأخرى. وعندما تدقُ الساعة، تَثِبُ وثبةَ الأسد الصحيح المعافى، وتعمل أنيابها القاطعة وبراثنها الحادة في جسد الدولة التي أذلتها، فتقطع أوصالها، وتسكر من خمرة دمائها. وهكذا تعودج فتثأرُ لما أصابها منذ أعوام، طالت أم قصرت.
وتدورُ عجلة الدهر القلب، فيرتفع ميزانُ القدر، فتعودُ هذه الدولةُ للانتقام والثأر؛ وهكذا دواليك.
ويكاد يكون مستحيلاً إقناعُ شعبٍ مقهورٍ مدحور باعتناق مبدأ السلام والتخلي عن العنف، ومصالحة حاضره مع ماضيه، لأن نفسية الشعب تبقى مطعونةً، مكبوتة الألم والشكوىا حتى تحين الفرصة التي تسمحُ بالتفريج عما كان مكبوتًا، فيكونُ رد العنف بالعنف، والحرب بالحرب، لأن الماضي الجريح الطعين يبقى ماثلاً في الحاضر.
الاستعمارُ وضرورةُ مقاومة مظالمه
أبرز مؤسس الداهشية مظالم الاستعمار ومساوئه في معرض حديثه عن غطرسة الإنكليز في الهند ومصر.
فمن أمثلة المظالم التي انطوى عليها تطبيقث القانون الإنكليزي على الهنود: منعهم من ركوب الدرجة الأولى في القطارات، ومنعهم من رد الاعتداء ونحماية النفس، وضياعُ حقهم في كل قضيةٍ بين هندي وإنكليزي، وسجنُ الأبرياء وقتلهم لأنهم هنود، وسلبث الشعب من كل حرية حقيقية؛ وعلى الصعيد الاقتصادي، تحطم الصناعات اليدوية الحيوية كالغزل والنسيج، وتمخص ذلك بالمجاعات؛ إذ كان ملايين الهود يغزلون وينسجون في أكواخهم، ويعتاشون من الصناعات الصغيرة قبل احتلال الإنكليز لأرضهم. وقد زاد مصيبتهم هذه ألمًا أن كثيرين من سكان المدن الهنود تحولوا إلى سماسرة وعُملاء للإنكليز الذين كانوا يمتصون دماء الجماهير الضعيفة8
أما مصر فقد شهدت أيضًا من غطرسة الإنكليز ما شهدته الهند. والدكتور داهش سلط الضوء في مرحلة احتلالهم لمصر، على حادثة مصرع ْدار الجيش المصري وحاكم السودان العام، السير لي ستاك، وعلى ما تمخضت به من ذُيول تدمغُ الحكمَ الإنكليزي بوصمة الظلم المُستنكر. فقد اغتنم الإنكليزُ فرصة مقتل السردار (وقد يكونون وراءها)، فخرقوا الدستور المصري الذي ينص على أن ملك مصر هو القائد الأعلى للجيش، فعزلوا الضباط وفق هواهم، وأخرجوهم من السودان معتبرينه ملكًا لهم، ضاربين عُرضَ الحائط باتفاقية 1899، واحتلوا جمارك الاسكندرية، وأخذوا البريء بجريرة المذنب، حتى بدا وجههم في أبشعِ ما يكونُ من صلفٍ وتجبر واحتقار للشعوب9.
إن الظلم – سواءٌ أوقعه حاكمٌ وطني على مواطنيه أو حاكم أجنبي على شعبٍ مستغل أو مستعبد- يبقى منكرًا مقاومته واجبة، بل في رأي مؤسس الداهشية، "إن الشعب الذي يقبلُ مثل هذه المعاملة المهينة ولا يثور، هو شعبٌ ميت لا يستحق الحياة"
وثورةُ الشعب المستعبد على ظالمه هي حق مقدس تباركه السماء وتؤيده. يصفُ الدكتور داهش انتفاضة الهنود في بومباي وإحراقهم البضائع الأجنبية رمزًا لرفضهم سلطة الإنكليز بقوله:
لكن مواكب إحراق البضائع الأجنبية استمرت، وجعل الهنودُ يجتمعون في الميادين العامة، ويشعلون النيران في الثياب والسلع الأجنبية، والأناشيد ترتفع إلى عنان السماء، والأضواءُ ينعكسُ نورها الأحمرُ على الوجوه والبيوت... وكأنما هو لون الغضب المقدس، الغضب الوطني، غضب الأمة التي سُلبت حقها، وديست كرامتها، وفُرض عليها الفقرُ والجوع.
وعلى أن مقاومة الغاصبين والمستعمرين، إن تكن ضرورية، في رأي مؤسس الداهشية، فالعنف لا يراه أفضلً وجوهها. وقد عرض أسلوبين للمقاومة في الهند ومصر.
فالهند أتيح لها رجل روحاني عظيم استطاع بسمون نفسيه، وثباته في جهاده، ونور عقله الصافي أن يحررها من ربقة المستعمرين، وذلك بسياسة العصيان المدني وعدم التعاون التي بثها في نفوس الهنود. لكن طريقة اللاعنف التي أراد المهاتما غاندي أن ينهجها الشعب، فيرد العنف باللاعنف، فلا يؤذي رجال الأمن أو الموظفين، بل يتحمل الإيذاءَ والإرهاق والإهانة بدون تذمر، هذه الطريقة المثلى لم يقدر المجاهدون الهنود على اتباعها، لأنهم عجزوا عن إلجامِ جموح عواطفهم ونزواتهم والسيطرة على انفعلاتهم؛ الأمرُ الذي جعل غاندي فرضُ الصوم على نفسه، "كعقوبةٍ للعنف الذي ارتكبه الشعب، وتطهيرًا لنفسه، وتقوية لروحه التي يجب أن تلاقي آلامًا أكثر ما دام الجهادُ هكذا محفوفًا بالعنف، وما دام المجاهدون غير قادرين على ضبط عواطفهم وتنفيذ مبدئهم".
وقد أكبر الدكتور داهش موقف غاندي، وأجل شخصه ومجده رافعًا إياه إلى مرتبة الإنسان الكامل الذي حقق سموه بإرادته الجبارة وجهاده لجواذب الدنيا ومغريات الجسد، فاستحق أن يكون مقاربصا للأنبياء.
أما مصر فقدج أتيح لها قائدٌ كبيرٌ استطاع أن يعالج الأمور بحنكةٍ ومرونةٍ وحكمةٍ هو سعد زغلةل. فهون وإن لم يستطع أن يسمو بنفسه إلى المرتبة التي سما إليها قديسُ الهند، فإنه داناهُ في معالجته الحكيمة للأمور الشائكة. يخاطبُ مجلس الأمة، على أثر مصرع سردار الجيش وثوران عنجهية المندوب السامي البريطاني، فيقول:
"... أرطو الأمة جمعيها أن تدفق في الحالة الحاضرة تدقيقًا عميقًا، وأن تتأملها من كل وجوهها، وأن تحترس كل الاحتراس من الاندفاع وراء الأهواء والانفعالات التي لم تكن نتيجة تدبر في الحال وتأمل فيها، لأن المواقف دقيق جدًا، وأقلب حركة طائشضة تكلفنا أكلافًا باهظة. فعلينا أن نتذرع بالصبر، وأن نلزم جانب السكينة، وأن نثبت للناس أجمع أننا أمة حكيمة، تعرفُ كيف تضبط نفسها وقت الشدة، وكيف تلين لظروف وتشتد لظروفٍ أخرى، فنعرف العالم أجمع أننا عالمون بحقيقة موقفنا، وأننا نحاول أن نصل إلى غايتنا بوسائل الحكمة والرزانة، بالوسائل المشروعة، لا بوسائل الحكمة والرزانة، بالوسائل المشروعة، لا بوسائل الخفة والطيش... فالزمن أمامنا طويل، وحياةُ الأمم طويلةٌ، وإننا إذا لم نحصل على مقصدنا اليوم، فسنحصل عليه غدًا. ويجب أن نجعل دائمًا نصب أعيننا أن من الواجب علينا ألا نُمكن الخصوم منا، وألا نجعل لهم سلطانًا علينا ولو بظاهرٍ من الحق. ويجب علينا أن نجردهم من كل سلاح بالحق، وأن نسلح أنفسنا دائمًا بالحق وباللياقة...
الحرب... أكبر خدعة"
الشعب الذي لا يكون فيه رأي عام ستنير يمحص أعمال الحكام وقراراتهم، ويراقب تصرفاتهم، وينتقد أخطاءهم لا يمكن أن يستفيد من نعمة الحرية التي يكون راتعًا فيها. ولذلك يرى مؤسس الداهشية أن علىت العقلاء في كل قومٍ أن يحبطوا مساعي القادة والسادةس لإيقاد الحرب، وذلك بمناقشة آرائهم الثورية. وفضح التمويه الذي يلبسونه شعاراتهم الوطنية التي يلهون بها نفوس الشبان ويغررون بهم دافعين اياهم إلى أتون الحروب. فالمغانم والمكاسب التي يحلم بها القادة من انتصارهم "لا تساوي قلامة ظفر أحقر جندي يسقط في معركة يشنها دون أن تحقق آماله بعد انتهاء الحرب ووضع أوزارها". وآمال كل جندي ومواطب تكون معلقة على وعودٍ عرقوبية يجود بها القادة عليهم لتخديرهم، من تأمين العدل والرفاهية والسعادة للشعب، وإعلاء الحق، وضمان الحريات والحقوق الإنسانية للعالم... فالحروب "أكبر خدةعة"، وهي "إثمٌ رهيب فادح لا يغفرُ الله لمن ارتكب جريمته".
فبعد أن تكون الحربُ قد حولت العمران إلى أنقاض، ويتمتِ الأطفال ورملت النساء، ينتظر الشعب المرهق بالفقر والمآسي أن يحقق القادة وعودهم له، فإذا "الرخاء الذي أصبح لديه يقينًا لكثرة ما ردده الساسة على مسامعه، قد استحال إلى جوع جارف يحتل المدن والقرى، ويفتك بالعباد أكثر مما فتكت الحرب الجنونية بجيوشها اللجبة. ويبقى القوي قويًا يسيطرُ على الضعفاء كعهده السابق4ز والغني يمكث متحكمًا بالفقير مثلما اعتاد قبل الحرب الضروس".
ويرى الدكتور داهش أن الشعارات والدعايات الكاذبة لم تتغير في جميع الحروب الحديثة. ولعل أكثرها تأثيرصا في الأعصاب ما يتعلقُ بالوطن والوطنية، وواجب الدفاع عن أرض الجدود المقدسة؛ فهي تعمي الشعب عن رؤية أي حق مقدس غير حقه هو. وهذه العصبية القومية العمياء إذا شُحنت بعصبيةٍ عقائدية سياسية أو دينية، حولتِ الشعبَ إلى وحشٍ ضار يفتك بالآخرين بلا تردد أو رحمة. يقولُ الدكتور داهش في سُداسيةٍ بعنوان "أسطورة (في سبيل الوطن)".
أيها الأبطالُ الذاهبون طُعمة الأطماع والأهواء من أبناء المنافع
لقد خدعوكم وإلى الحرب دفعوكم طعامًا لنيران المدفاع
ثُم قالوا: إننا فِدَى الوطن وعنكم نُدافع...".
ورجل الروح الخارق يرى أن وطنه الحبيب ليس في هذا العالم الشرير المدنس، بل هو في ملا الأرواح القدسية الطاهرة. وهو يناشد كل من تاقت نفسه إلى الكمال الإنساني أن يجعل قلبه وكنزه لا في وطن أرضي لا بد من أن يزول، بل في وطن سرمدي.
وإذا أخذنا بعين الاغعتبار الفلسفة الداهشية القائلة بالقمص الذي يستتبع أن كل إنسان يمكن أن ينتمي إلى عدة أوطان في دورات حياتية متعاقبة، بل قد يصبح في دورة لاحقة ابن وطنٍ قد حاربهُ في دورةٍ سابقة، فيمكننا أن نفهم مهازل الحروب والعصبيات القومية أو العراقية أو القعائدية التي تثيرها. يقول الدكتور داهش بلسان روح جلبرت، أحد الجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى:"
لقد اجتمعنا هنا (أي الأرواح)، وكونا أسرةً روحيةً واحدة؛ فأعداءُ الأمس الذين كانت تغمرُ قلوبهم الكراهية، أصبحوا أصدقاء اليوم، تعمرُ أرواحهم المحبة الحقيقية.
فالألماني والبريطاني والفرنسي والتركي والبلجيكي واليوغسلافي والبلغاري والروسي والزنجي والأميركي والاسترالي وغيرهم من مختلف الجنسيات التي فرضتها غايات الأرض فرضًا علىا الأمم – أصبحت، الآن، تنتمي إلى جنسية روحية واحدة، بعد أن بذت أضاليل الأرض وسخافات الحياة.
فهنا لا سائد ولا مسود، لأن قانون السماء قد وحد بين الجميع. والحقيقة الإلهية كشفت عن أعينهم غطاءً الجهل، فاصبحوا يخجلون مما كانوا يقومون به في عالمهم المشق من الجحيم".
إن النص السابق لجيدرٌ بأن يستوقف ذوي البصائر النيرة؛ فما إن انتهت الحربُ الباردة بانهيار الاتحاد السوفياتي وتفاءل الناس بالخير والسلام حتى اندلعت نيرانُ العصبيات القومية منذرة بشر مستطير، ففي ظرف بضع سنوات وقعت حوالى خمسين حربًا إتنية سقط فيها مئاتُ ألوف الضحايا، وشرد عشرات الملايين، وازداد خطرُ انتشار الأسلحة النووية بين الشعوب بازدياد الفوضى فيها، وتعاظم أمرُ الغلاة في الأديان جميعها حتى كأنها خلت من روح الهداية وداخلتها روحُ الضلال.
إذًا الحربُ منكر يجب على العقلاء أن ينبذوهُ ويسفهوا بالحجة الدامغة مروجيه، لأن الحروب لا تتمخض إلا بالخراب والويلات على الظافرين والخاسرين، ولأنها نفي لناموس المحبة الشاملة التي أرادها الله، من خلال رسله جميعًا، في الناس.
لكن هذه القاعدة لها استثناء واحد فقط هو الدفاع عن النفس. فمثلنا أن الفرد يحق له أن يدافع عن نفسه دفاعًا مشروعًا ضد مغتصب أو معتدٍ، هكذا يحق للشعب أن يذود عن أرضه إذا تأكد له أن شعبًا عدوًا يعتزمُ اغتصابها. يقولُ الدكتور داهش بلسان جلبرت:
إن الدفاع عن الوطن فرضٌ مقدس إذا حاول العدو اغتصابه لاستعماره وإذلال شعبه الأبي. فالدفاع عن أرض الجدود والآباء أمانة قلدتها السماءُ أعناقنا، وأوكلت أمر الدفاع عنها لنا ولأولادنا.
فالتراجع عن الواجب عارٌ لا تمحوه عابراتُ الأعوام. هذا إذا تأكدنا أن العدو سيخترق حرمةَ حدودنا كي يستعمرنا ويسرِبلنا بعار عبوديته الذليلة التي لا تطاق.
السلام العالمي والعالم الواحد
يقول مؤسس الداهشية على لسان جلبرت:
إن على ساسة العالم، في أربعة أقطار المعمور، أن يبنوا (عالمًا واحدًا)، إذا رغبوا في أن يسود السلام العام أرجاء هذه الكرة اللعينة.
أما الطريق الموصلة إلى هذا الهدف الجليل، فيمكن اختصارها بالأمور التالية:
أولاً، ضرورة تأمين إجماع الدول، ولا سيما الكبرى منها، على تحقيق هذا الهدف. وهذا يقتضي أن يعمل الواعون المخلصون بمساعدة الأمم المتحدة، على نشر ثقافةٍ تستهدفُ إقناع الرأي العام في كل دولة أن الأرض عالمٌ واحد ذو مصير واحد، وأنها وحدة متكاملة، لا جزءَ منها بوسعه ن يعتزل عن الأجزاء الأخرى مستغنيًا عنها ومكتفيصا بذاته، مهما أذخر من القوة. ولذا فإن الخطر على القوميات أو الثقافات في تصارعها، مهما يكن مقلقًا ومؤلمًا، فإنه يبقى دون الخطر الأعظم على الأرض كلها من جراء حربٍ نووية قد يفجرها العصابيون من الحكام الطامعين أو الحاقدين أو الموتورين، أو من أخطار فلكية إفنائية قد تفاجئ كوكبنا الصغير، واحتمالاتها العلمية كثيرة، أو من أخطارٍ عامة ناتجة عن انتشار الأوبئة بسبب التعلوث العام في المياه أو الهواء، أو بسبب المجاعات المروعة التي تصيب الملايين كل عام في إفريقيا وىسيا، والتي قد يحولها جفاف شامل غير منتظر إلى كارثة عالمية.
ثانيًا، أن يقتنع ممثلو الأمم بأن الدول يجب أن تكون عالمًا واحدًا، لا ثلاثة عوالم، شرقية وغربية وغير منحازة، كما كانت الحال قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، ولا عالمين، عالم السادة الأقوياء وعالم التابعين الضعفاء مثلما الحالة اليوم؛ بل عليهم أن يقنعوا بأن البشر كافةً أسرةٌ إنسانية واحدة، فيعملوا بإخلاص من أجل خير هذه الأسرة؛ والكبير فيهم يكون كالأب المسؤول عن خير أبنائه، أبٍ محب شفيق غير متسلط لا يفرق بين ابنٍ وآخر، ولا يتحيزُ لواحدٍ دون آخر.
ثالثاً، طرح الأطماع جانبًا من الجميع في سبيل سعادة الأسرة الإنسانية"، والتنازل عن كل مطمعٍ قومي يؤدي إلى إثراء شعبٍ على حساب شعبٍ آخر. وعلى الواعين في كل أمة أن يعوا أن القومية مرحلةٌ في المسيرة التاريخية الحضارية وليست المحجة الأخيرة. فالمجتمع البشري تطور من كيان العشيرة فالقبيلة إلى كيان المدينة – الدولة فالأمة – الدولة؛ ولا شيء يمنعُ من أن يتابع تطوره إلى أسرة دولية تكون الأرضُ كلها بيتًا لها. والمرحلةُ الأخيرةُ بدأت ملامحها تظهرُ في الأفق العالمي مع انتشار الأفكار والقيم المختلفة لدى الشعوب طرًا وتقاربها وتفاعلها، وذلك بوسائل الإعلام الحديثة الشاملة، ومنها "الإنترنت" والأقمار الصناعية. كذلك تكاثر نشوء المنظمات العالمية المهتمة بشؤون العالم كله تكاثرًا لم يعهده التاريخ من قبل؛ منها "منظمة حقوق الإنسان" ومنظماتُ السلام العالمي، فضلاً عن "البنك العالمي" ومنظمة "اليونسكو" وكثير غيرها مما هو داخل الأمم المتحدة أو خارجها.
رابعًا، أن يضع ممثلو الدول "قانونًا عالميصا شاملاً، يدخلون فيه الدول الصغرى التي تنقادُ إلى آرائهم"؛ وهذا يقتضي أن تتصرف الدول الكبرى بحكمةٍ ومحبة وإخلاص لخير الإنسان حيثما كان، فتحترم حق تقرير مصير الدول لنفسها، كما تحترم ثقافاتها وعقائدها اغلدينية وتقاليدها وأعرافها وقيمها، الأمر الذي يؤدي إلى جعل الدول الصغرى تثقُ بالدول الكبرى فتنقادُ لها مثلما ينقادُ الابنُ لوالده المؤدبِ المحب الحكيم، علمًا بأنه لا يجوزُ، في أي حال، فرضُ إراد الكبير على الصغير فرضًا.
خامسصا، أن"يوحد ممثلو الدول أهدافهم السامية ومثلهم العليا". وليس هذا الأمر عسيرصا إذا تفهم الجميع خصائص الحضارات المختلفة وخصائص أديانها؛ فمن القواسم المشتركة بينها يمكن استنتاج القيم والمثل العليا التي يرضى بها الجميع. فالفضيلة نوةَ بها الهداة والرسل والحكماء جميعًا، وكذلك العدالة والحرية. لكن الديمقراطية ونظام الحكم ليس محتومًا على جميع الشعوب أن تنظر إليهما من خلال منظورٍ واحد؛ فقد عرف التاريخ ملوكًا ديمقراطيين ورؤساء جمهورياتٍ مستبدين (أنظر "العدالة في الحكم" في العدد السابق). والوعي السياسي الثقافي مختلفٌ بين شعبٍ وآخر؛ فيستحيلُ افتراضُ مستوى النضج الروحي الفكري الواحد حيثما كان. أما الغطرسة، وادعاءُ العصمة أو الكمال فأمر
"ممقوت" ممجوجٌ لدى أكثرية الناس، وإن تظاهروا بالخضوع له أحيانًا.
إن الدكتور داهش يرى أن هذا الهدف الجليل ليس مستحيلاً لكنه صعبُ التحقيق في هذا العصر، لأن المطامع المادية ما تزالُ هي التي تحرك الشعوب وتملي عليها أهدافها، وتخطط سياستها الداخلية والخارجية. أما الشعارات التي يطلقها زعمءا الدول من حين إلى آخر، منذ تأسيس الأمم المتحدة، من مثل الرغبة في بناء عالمٍ حديدس تسوده العدالة والطمأنينة، وتعمُه الحرية، وينتفي فيه العوز والخوف والإكراه إلخ... تلك الشعارات التي أطلقها ونستن تشرشل وروزفلت في أوائل عام 1946، وما زال الرؤساءُ يكررونها بصيغٍ مختلفة أكثر من نصف قرن، برهنت الأحداث التاريخية أنها مجرد كلام يطلق في الهواء أو يبقى حبرًا على ورق، لأن النيات غيرُ صافية والقلوبَ غير صادقة.
يختصر رجل الروح والخوارق رأيه في اجتماعاتِ الأمم المتحدة منذ تأسيسها بقوله على لسان "الدينار"، بطل قصته الفذة "مذكرات دينار".
إنني أرى ما لا ترونه، يا معشر الساسة، وأعرف ما لا تعرفون، يا أرباب الدهاء والسياسة. فالغيبُ قد تكشف لي بدائع أسراره.
والإلهام تدفقت على روائع أنواه(...)
لقد رأيت نير القوي يطق أعناقكم،
وسيف الجباريكم أفواهكم،
وقنابله الفتاكة تردم دياركم وتحصد أورىاحكم،
وما هذا المؤتمر إلا مؤامرة أبيتم إلا إدخال بلادكم ضمن دائرتها، وتقديم أنفسكم المخدوعة قربانًا على مذبح شهواتها(...)
فالنياتُ، يا ساسة، لن تصح ما دام هناك مناجمُ تحتوي أجوافها على معادن الألماس والفضة والذهنب والبلاتين. ولن تصفو ما دام هنالك آبارُ النفط والزيت والبترول(...)
- قابين، قابين! أين هو أخوكَ هابيل، يا قايين؟
- لا أعلمُ أين هو. فهل أنا حارسٌ عليه وأمين؟(...)
- يا مَن بأيديكم القواتُ المادية،
- ويا من تسيطرون على الطاقة الذرية،
- ويا من تدعون بحبكم للبشرية،
- إذا كان السلام يغيتكم، والحق ديدنكم،
- والعدالةُ أُمنيتكم،
- فهاتوا البرنان على صدق نيتكم.
- هاتوا، يا أقوياء، وأشهدوا الكون على تضحيتكم...
- أعيدوا لكل ذي حق حقه، وحرروا المستعبد من رقه، والمغبون من غبنه، ومكنوا رب البيت من بيته؛ فربُّ البيتِ أدرى بالذي فيه، بظواهره وخوافيه.
ولكنكم قلبتم الآية، وعكستم الحقائق، وأضعتم الغاية. فأصبح رب البيت يئنُّ تحت نير الغُرم، وأنتم، أيها الأقوياء، تتمتعون بالغنم(...)
وما دمتم مجتمعين لتقرير صرح سلام عالمي تسودُه العدالة الشاملة، فلماذا – يا ليتَ شعري! – شحذتم خناجركم، وحمل كل منكم غصن زيتون في ميناه، وشهر خنجره المرهف الحد بيسراه متحينًا الفرصة كي يغمده في ظهر زميله الجالس بقربه وينتهي من أمره؟
إنني أؤكد لكم أنه لا المؤتمراتُ، ولا القراراتُ، ولا المداورات، ولا المناوراتُ تستطيع أن تمنع وقوع حرب فناء ثالثة.
فما دامت شياطين "اطماعكم لا تزالُ قاطنة في أعماق أفئدتكم، ومستقرة في تلافيف أدمغتكم، وساريةً في كريات دمائكم، وهاجعة في ضلوعكم وأحشائكم، وملتصقة في كيانكم منذ تكوينكم... فليست بعيدةً تلك الساعةُ الرهيبة التي تهيئون بها معداتكم، وتتمون بها استعداداتكم...
وإذ ذاك تنطلق تلك الشياطين الجهنمية من عقالها، وتخرجُ فدائح أثقالها، كي تدمر الأرض وما فيها وتردمها بمن فيها.
إن نهاية تصارع المطامع للسطرة على الأرض، يراها الدكتور داهش يخسران الأرضِ كلها في حربٍ فنائية شاملةٍ لا تبقي ولا تذر، وقد تكون أقرب إلينا مما نتصور.
لكن أليس من حل؟
بلى، إنه في العودة إلى تعاليم السماء ممارسةً، والتمسك بالقيم الروحية التي من أجلها اضطهد الهداةُ والمرسلون والأنبياء. إنه الإيمان بوحدةِ الأديان الجوهرية، وبالإخاء الإنساني الشامل. إنه الشعور بالعطف والشفقة على الفئات الضعيفة أو الفقيرة داخل الدولة الواحدة، كما على الشعوب الضعيفة أو الفقيرة، في أسرة الدول، وبواجب مساعدتها لإقالتها من كبواتها. فلو كانت روح الدين السمحة في المسيحية والإسلام وفي سائر الأديان ما تزالُ معافاةً فعالةً، لما حمل الأوروبيون شارةَ الحب والفداء، شارةَ الصليب، على صدورهم ليجتاحوا الشرق الأوسط ويقتلوا ويفتكوا ويدمروا باسم الصليب، ولما عادوا في العصر الحديث إلى استعمار الشعوب وامتصاص قواها؛ ولما حدثت المجازر بين الكاثوليك والبروتستانت كما بين السنة والشيعة، والسيخ والهندوس، والمسيحيين والمسلمين واليهود. لكنه فراغُ الأديان من نسغها الروحي الحقيقي – النسغ الذي من أجل نشره وتعزيزه في العالم هبطت الرسالاتُ السماوية وكان الهداةُ والحكماء – هو الذي جعل الجميع يعبدون المال، وينسون وصية سيد المجد، فيحركهم الجشعُ إلى السيطرة فالحروب، وهو الذي جعل الباحثين الذين غاب الله من قواعدهم العلمية أو من ضمائرهم يرون الدين مجرد دينامية اجتماعية عمياء تمتطيها المحركات الاقتصادية والسياسية وردود الفعل القومية والإتنية لمزيد من السيطرة الإقليمية أو العالمية.
وفي هذا التصادم القومي أو الحضاري الفارغ من جوهر الحضارة لن يكون الفوزُ، في المدى البعيد، لأية دولة. فالجميع، في ظل الغمامة النووية، سيقومون بانتحار جماعي. ومن هو الأكبر اليوم سيحل به ما حل بالأكبر قبله منذ ألفي عام. فروما التي كانت تترنح الأرض تحت أقدام جحافلها أصبحت مقطعة الأوصال، مرملة ميتمةً ترثي أبناءها. ولا يغين عن البال، إذا كنا مؤمنين بوجود عدالة إلهية، أن الثواب والعقاب يقعان على الشعوب والمجتمعات مثلما يقعان على الأفراد. فالدولة الفاسدة الباغية ستلاقي جزاءها، والدولةُ الجشعة المتغطرسة ستقلبُ على رأسها، ويأكلُ الآخرون لحمها.
أما إذا كان الحقُّ هو رائدَ الشعوب, والفضيلةُ هي نهجها، فلاغ خوفَ على الدول فُرادى ولا خوفَ على الأرض.
فالأرض التي كونها الله، والخيراتُ التي ملأ بها أرجاءها، تستطيع أن تغرق كل حي على ظهرها، وتكفيه مؤونة الاعتداءات؛ هذا إذا سلمتِ النيات، وأخلصت القلوب، وإذا طردنا منا شياطين الأطماع التي تقطن في داخلنا مثلما تقطن الأفعاي في الشقوقو النخاريب.
وريثما تتقارب سيالات البشر، عبر العصور الآتية، في مستوياتها وتوجهاتها، في مداركها ونزعاتها، فتقوم حضارةٌ واحدة تسوسُها حكومةٌ حكيمةٌ عالميةٌ واحدة، فعلينا أن نبقى مرددين: (يا أيها الناسُ، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليمٌ خبير)، و(لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا، ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة، ولكن ليبلوكم في ما أتاكم، فاستبقوا الخيرات، إل الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفو).
السببية الروحية في مجرى الأحداث العامة
في ضوء المفاهيم الداهشية (3)
بقلم الدكتور غازي براكس
خط الهداة الروحيين
لكن هل يعني انحطاط سيالات العبرانيين الروحية (أي مداركهم ونزعاتهم) الذي شهد عليه أنبياؤهم، وم اسببه من تدهورٍ لحضارتهم أن الأرض خلت بعدهم من الهداية الروحية، وأن الله سخط على البشر جميعًا بسخطه عليهم؟
لا. ففي النظام الإلهي الذي تكشفت عنه التعاليمُ الداهشية أن السيالات الراقية تترحُ، في مثل هذه الحالة، من الشعب الذي كف عن استحقاقها إلى الشعب الذي يكونُ أجدر بها ومؤهلاً لاستقبالها والعناية بها. فالبشرُ، وإن تعددت شعوبهم، ينتمون إلى أصلٍ واحد، إذ إنَّ سيالاتهم متشابكة أصولها في آدم وحواء، ومتشابكة فروعها في مختلف الشعوب المتناسلة من ذراريهما بصورة تخفى عنهم.
لذلك شهد التاريخُ بداية نهضتين روحيتين جديدتين، إحداهما في العالم الآسيوي، والأخرى في اليونان. فما بين القرنين الثامن والثاني (قم) وضعت في الهند كتب الهداية الروحية الهندوسية، وخاصة "الأوبانيشاد" Upanishad" ثم "الباغافاض غيتا" Bhagavatgita التي تُشكل القسم الأوسط من ملحمة "المهابهاراتا" التي تشكل القسم الأوسط من ملحمة "المهابهاراتا" Mahabharata. وفي القرن السادس (ق م) ظهر فارهامانا Vardhamana المشهور بلقب ماهافيرا Mahavira (البطل الكبير)، وهو مؤسس "الجاينية" Jainism؛ كذلك ظهر بوذا Buddha، الهادي العظيم. وفي القرن السادس (ق م) ظهر هاديان روحيان في الصين هما لاوتسو Laotzu وكنفوشيوس Confucius . وسرعان ما امتدت أفكارُ هؤلاء الهداة من الهند والصين إلى البلدان المجاورة. وفي القرن السادس (ق م) أيضصا ظهر أورفيوس وفيثاغورس في اليونان، ثم سقراط في القرن الخامس، وما لبثت تعاليمه أن انتشرت من خلال كتابات تلميذه أفلاطون. من هؤلاء انتقل الزخم الحضاري الروحي الجديد، في خطين خلقيين وعقليين متوازيين، إلى ملايين من الناس لم يهبط فيهم نبي ولا نزل وحي.
لكن أولئك الهداة الروحيين لم تكن تحييهم إلا سيالاتٌ روحية تابعة للأنبياء أنفسهم؛ والفارق الوحيد بينهم أن الهداة الروحيين لم ينحدروا مباشرةً من الخط الإبراهيمي؛ ولذا كانوا جميعصا مدفوعين ومُسيرين بإلهامهم السامي وسيالاتهم الراقية، من غير أن يهبط الوحي الإلهي عليهم، ذلك الوحي الذي كان مؤيدًا أحيانًا بالمعجزات، والذي كان يبدو أنه محصورًا بنسلِ إبراهيم المباشر لسببٍ علمُه عند الله.
المجتمع الهندي القديم وكتبه المقدسة
إن العدالة الإلهية، وفقًا للتعاليم الداهشية، مقرونةٌ دائمًا بسببية روحية، أي إنها تقضي بأن تكون أوضاع الشعوب الحضارية (الدينية والخلقية والثقافية والسياسية والاجتماعية) نتيجة لمجمل أعمالها وأفكارها ونزعاتها واتجاهاتها، في أجيالها الحاضرة وكذلك السابقة. وما حصله المؤرخون والباحثون من استنباشهم الصعب لتاريخ الهند القديم الغامض، العائد إلى الألف الثاني والألف الأول قبل المسيح، يرد سكان الهند الأصليين إلى عدة أغصول، أهمها: أقوامٌ من المغول استوطنوا شمال الهند؛ وقبائل معروفة بالدرافيديين Dravidians كانوا يستوطنون جنوب الهند؛ وكانت بشرتهم سوداء، أو مائلة إلى الدكنة، والراجح أنهم نزحوا من إفريقيا؛ وكانوا يتكلمون لغاتس مختلفة كثيرة، أما حياتهم فبدائية، تقوم على الصيد وجني الثمار من الأشجار وحبك القصب؛ وأقوامُ الهارابا Harappa الذين استوطنوا وادي الإندوس حيث تمتد باكستان اليوم، كما غرب الهند، وكانوا الأكثر تقدمًا في مظاهر المدنية والعمران.
ثم بدأت تصل إلى الهند موجاتٌ من الآريين Aryans الذين احتلوا ايران القديمة (فارس) واستمر تدفقهم منها في حقبة طويلة بين الألف الثاني والألف الأول قبل المسيح. فأنزلوا مجازر بالسكان الأصليين، واستعبدوا كثيرين منهم، وبخاصة قبائل "الداساس" Dasas الدرافيديين، ذوي البشرة الدكناء والمعاطين الصيد أو الأعمال الوضيعة بنظر المحاربين الغزاة.
ويظهر من الآثار الباقية أن الآريين أدخلوا معهم معتقدات دينية متأثرة بعقائد البابليين، ولا سيما ما ظهر منها في ملحمة "جلقامش". كذلك يبدو أنهم استوطنوا آسيا الصغرى وبلاد الإغريق على الأرجح. وبناءً على أصولهم الألسنية المتقاربة تمت تسمية لغاتهم بالهندية – الأوروبية indo-European تمييزًا لها عن السامية وغيرها.
والسؤال الذي يستوجب جوابًا في هذا المجال هو: من هم أولئك الآريون، ومَن هم الدرافيديون الذين استعبدَ معظمهم، واستمروا يشكلون طبقات دُنيا برضاهم واقتناعهم الديني طوال أربعة آلاف سنة، مثلما سنرى؟
التاريخ لا يجيبُ عن هذا السؤال, ولا المؤرخون والباحثون. لكن ما دام البحث يستوجبُ أن يكون لكل حال أو حدث سببًا روحيًا، وفق المبادئ الداهشية، فما عسى يكون السبب؟
ذكرتُ، في بحثي عن السببية الروحية في مجرى الأحداث العامة (صيف 2005)، أن إبراهيم الخليل أوحي إليه بأن نسله "سيكونون غرباء في أرضٍ غير أرضهم، فيستعبدُهم أهلُها ويعذبونهم أربعمئة سنة"، ثم يخرجون من أرض العبودية. وهذه النبوءة تحققت. وقد أوضحتُ تطور الأحداث التي أدت في توالي حلقاتها إلى تحققها، من بيعِ أبناء يعقوب لأخيهم يوسف، حسدًا له، ثم ارتفاع شأن يوسف لدى فرعون، وقصد إخوته مصر للحصول على الطعام في أثناء سنوات القحط، وأخيرًا إقامتهم هناك، ليستعبد المصريون ذراريهم بعد وفاة يوسف عقابًا لهم. في هذا الضوء، قد يكونُ ثمة سبب روحي، في اساس البناء الاجتماعي الهندي في بداية الألف الثاني (ق م)، أدى إلى نتائج تحولت بدورها أسبابًا.
يؤكدُ علماء اللغات أن اللغات الهندية – الأوروبية (التي منها الفارسية والهندية السانسكريتية Sanskrit واليونانية واللاتينية وما اشتق منهما) تختلف في أصولها كثيرصا عن اللغات السامية، مثلما يستحيل إعاة عائلة اللغات الدرافيدية إلى عائلتي اللغات المذكورة، إذ إنها تختلفُ في أسسها عنهما. وبينما كانت السامية منتشرة في الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربية، واللغاتُ الهندية – الأوروبية منتشرة في أوروبا ثم في إيران والهند، كانت اللغاتُ الدرافيدية منتشرة في جنوبي وشرقي إفريقيا وفي الهند قبل دخول الآريين إليها، الأمرُ الذي يدل على أن الشعوب الناطقة بتلك اللغات تعودُ إلى أصول بشرية مختلفة ترقى إلى آلافِ السنين قبل المسيح. فهل تعودُ إلى سام ويافث وحام بعد أن تفرقت ذراريهم؟
ولكن كيف حدث أن استعبد الآريون الدرافيديين ولا سيما قبائل "الداساس" منهم، وغيرهم من عشرات القبائل السوداء التي كانت مستوطنة ربوعَ الهند، ثم اقتنع هؤلاء بوضهم دينيًا من غير إحداث أي تمرد طوال أكثر من أربعة آلاف سنة!
يقول السيد المسيح: "لا تسقطُ شعرةٌ من رؤوسكم إلا بإذن أبيكم السماوي". ويقولُ القرآن الكريم: (إن الله لا يظلم الناس شيئًا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون) (يونس:44)
عقيدة "الداساس" وكثير من القبائل الدرافيدية كانت متمحورة حول تقديس عضو التناسل Lingam الظاهر في آثارهم الباقية من رسم ونحن. وهذا التمحور لا بد من أن يكون صادرًا عن هاجسس جماعي متسلط لا شعوري منشأه سيالات أصحابه.
أما الآريون فمعتقداتهم اختلطت، مع مرور الزمان، بالعقائد الدرافيدية، وبدل أن تجذب السيالات العليا السيالات الدنيا حدث العكس.
وقد ظهر التفاعل المتبادل في أناشيط "الفيدا" Veda (1017 نشيدًا)، وخاصًة في كتابي "الأثارفا – فيدا" Atharva-Veda و"الريغ – فيدا" Rig- Veda. وتاريخ نشأتها مختلف فيه، لكنه قد يكون قبل دخول الآريين الهند، أي في الألف الثالث؛ ونهاية وضعها يرجح أنها كانت حوالى العام 600 قبل المسيح. والمجموعة الأولى منها، التي من الراجح أنها الأقدم، حافلة بالشياطين وفنون التعذيب، وبأنواع السحر والتعاويد والتعازيم ضد الحيات والأمراض إلخ. وفي المجموعة الثانية تظهرُ عبادةُ الإله الواحد مع الآلهة المتعددة. وبصورة عامة، تتضمن أناشيدُ "الفيدا" أدعيةً تكادُ تقتصر على طلب تأمين الحاجات المادية، من تمديد العمر إلى تأمين الغذاء والمسكن والحماية وإكثار النسل... الأمر الذي يكاد يلاشي الروحانية الحقيقية. وهذا يدل على أن المؤمنين بأناشيد "الفيدا" لم يكونوا، بصورة عامة، يسعون إلى الخلقيات والحكمة، بل للقوة المادية وملذات العيش، حتى انحصر مفهومُ الرذيلة لديهم بأمورٍ قليلة. أما التقشف والزهدُ بالدنيا فلم يكن لهما أتباع.
ويبدو أن الهنودَ الآريين ومن سبقهم من عشرات القبائل التي استوطنت الهند انعكست أوضاعهم الخلقية والسيكولوجية في أناشيد "الفيدا". ففي أواخرها إشارةٌ إلى أن أربع طبقات انبثقت من جسد الإله براجاباتي Prajapati: العليا طبقه البراهمة، التي تضمن الكهنة ومعلمي الدين، انبثقت من فمه. و"براهمان" مشتقة من "براهما" Brahma التي تعني المعرفة السحرية أو الإلهية. يتلوها طبقة "الكشاتريا" Kshatriyas التي تشمل الارستقراطيين والمحاربين، وقد انبثقت من ذراعي الإله. والطبقة الثالثة "الفايشيا"Vaishyas التي تضم التجار، وقد انبثقت من فخذيه. وأخيرصا طبقة "السودار"، التي تجمع الحرفيين من صناع ومزارعين ودباغين وغير ذلك، انبثقت من رجليه. والطبقات الأولى يعتبر أفرادها مولودين ولادتين، ولذلك يحق لهم قراءة "الفيدا" والدخول إلى المعابد، وهو حق حرمت منه طبقة الـ"سودرا".
فضلاً عن ذلك عرف المجتمع الهندي طبقة "المنبوذين"، الذين توجب عليهم عدم الاختلاط بأفراد الطبقات الأربع خوف تنجيسهم، وخدمتهم في كل الأعمال الوضعية، كتنظيف بيوت الخلاء وطمر جثث الحيوانات الميتة، والامتناع التعام عن التعلم ولا سيما قراءة "الفيدا" بل حتى سماعها.
وهكذا كان المجتمع الهندي مؤمنصا بسببية روحية تمثلت نتائجها في أوضاعه وطبقاته التي استحقها أفراده بناءً على أعمالهم ورغباتهم واتجاهاتهم في تقمصاتهم السابقة.
وأرجح الظن أن الغزاة الآريين تأثروا تأثرًا بالغًا بنفسية المستوطنين السابقين لهم وبخلقياتهم، مثلما تدل عليه معتقداتهم في أناشيد "الفيدا"؛ فانجذبوا إلى ملذات العيش والجسد والقيم المادية.
وهذا من ناحية. من ناحية أخرى، يبدو أن نشوةت النصر رنحتهم، فاغتروا، وما لبث الخمولُ أن سيطر عليهم، وقعدت بهم همتهم. ولا عبرة ببعض الحروب القبلية التي كانت تنشبُ فيما بينهم أحيانًا. ولم يطمحوا إلى الارتقاء الحضاري في نظامهم الاجتماعي الذي كان يتراوح بين الملكية القبلية والجمهورية القبلية. يقول فيلسوف التاريخ أرنولد تويني: "يبدو أن النجاح يجعلنا خاملين أو راضين بأنفسنا أو مزهوين مغرورين". وإنها لحقيقة تكشفت لتوينبي في كثيرٍ من مراحل التاريخ. ولا شك بأنها تنطبق على هذه الحقبة من تاريخ الهند.
إن التعاليم الداهشية تحترم حرية الاعتقاد مهما تكن عقيدةُ الآخرين، استنادًا إلى أن كل عقيدة صحيحةٌ بالنسبة لمستوى سيالات المؤمنين بها، أي مستوى مداركهم ونزعاتهم واستعداداتهم. لكن الحضارة مرآةٌ للنفوس، ونتيجة لسيالات أبنائها. وليس من حضارةٍ يتم انحطاطها بفعلِ قوىً خارجية عنها إلا ظاهريصا. ففكرةُ الأقدار الخارجية التي تسيطر على مصير الأفراد والشعوب من غير إرادتهم وهم صرفٌ ليس فيه أثرٌ من الحقيقة. فسيكولوجية الهنود، سواءٌ المستوطنون الأصليون أو الغُزاة، جعلت منهم مجتمعًا ريفيصا مستسلمًا للخيال والأوهامِ والأحلامِ والملذاتِ الحسية، وميالاً للخمول والاستكانة. وهذا ما استخلصه المؤرخُ والباحثُ الألماني ماكس ملر Max Muller من دراسته للكتابات السانسكريتية القديمة. ولم يكن رأي المؤرخ البريطاني جايمس مل بعيدًا عن هذا الإستنتاج في حكمه على الثقافة الهندية بأنها تعتمد اللامعقول وتنافي التقدم.
كذلك استخلص الفيلسوف الألماني هيغل (1770 – 1831) من دراسته تاريخ المجتمع الهندي أن الحقوق والواجبات فيه ليست للإنسان، بل للطبقات. مثاله "أن الشجاعة ليست فضيلة، بل هي فضيلةُ الكشاتريا (طبقة المحاربين)". وبناءً على العقيدة الدينية التي رسخها البراهمة في عقلية الشعب، مضت آلافُ السنين، ولم يفكر أحد في الثورة لتغيير النظام الطبقي، لأن العقيدة الدينية التي كبل الشعبُ بها لا تسمح بذلك، فكل إنسان محددة طبقته إلى ما لا انتهاء؛ بل إن الطبقات الأربع الآنفة الذكر مقسمة بدورها إلى حوالى ثلاثة آلاف طبقة، وأكثر من 2500 طبقة فرعية، كل منها يتراوح ما تضمه من بضع مئات إلى عدة ملايين. حتى المنبوذون لهم طبقات كثيرة. وكل من هؤلاء وأولئك يحافظ جميع أنساله على العمل الذي تعاطاه الجد الأكبر؛ وندرَ أن حدث تغيير.
والمنبوذُ إذا شربَ من بركة ما فهو يُدنسها، ويجب تكريسها مجددًا. وإذا سمع أو قرأ "الفيدا" فيجبُ أن يُسكبَ في أذنيه زيتٌ محرق. فطبقهُ المنبوذين، بالرغم من كثرة أفرادها، لا تؤلف جزءًا عضويًا متممًا للمجتمع الهندي، فهي منفصلة عنه، ووظيفتها خدمةت أعضائه. وكان ملايين المنبوذين يعيشون في أكواخٍ خارج حدود المدن والقرى، ويأكلون لحم الضأن والخنزير والدجاج مما يعتبر منجسًا للطبقات الأخرى. فهم عبيد لسائر الطبقات.
أما البارهمة فكل منهم أحتلته الألوهة؛ ولذا فالواجب يقضي بالركوع أمام البرهمي إذا صدف أن مر بأحد من سائر الطبقات، ومخاطبته بعبارة "أنت الله". وقد خص البراهمة بعدة امتيازات؛ منها واجبُ الطبقات الأخرى أن تقر بطهارة مولدهم، والإخلاصُ والتبرع لهم، وعدم إيذائهم، وإعفاؤهم من الضرائب. وكانوا لا يحاكمون على أي عملٍ ارتكبوه، لأن الصواعق، في عقيدتهم، تنقضُ على الحاكم. فالبراهمي أكثر تمجدًا من الملك نفسه وعليه ألا يفكر بمساعدة أحد من الطبقات الدنيا حتى إن يكن في خطر. لكن يحق له، بعد أن يتزوج امرأةً من طبقته، أن يختار من شاءَ من النساء اللواتي يرغبُ فيهنَّ ثم يطلقهن متى أراد. وبصورة عامة يوصف البراهمة بأنهم، باستثناء قراءتهم لأناشيد "الفيدا"، لا يتبعون إلا غرائزهم، أكلاً وشربًا ونومًا وإشباع شهوات.
لكن الهداية الروحية الحقيقية لا تقوم بمجرد أن تقوم طبقةٌ من رجال الدين وتعلن أن الألوهة متجسدة فيهم. فـ"أناشيد الفيدا" التي طورها البراهمة مدى مئات السنين لم تكن تعاليم هداية روحية حقيقية، وكان غرضُها ترسيخ نفوذهم وتوسيع امتيازاتهم في المجتمع الهندي. تُرى، ألا تتدخل العناية الإلهية، بعد قرون كثيرة ازدادت فيها غطرسة البراهمة ومظالمهم، وتفاقم شقاءُ "المنبوذين" والمساكين، فتجري العدالة بعقاب أولئك، والرحمة بإنقاذ هؤلاء، وهكذا تتجسدُ السببية الروحية في التاريخ؟
بدءًا من القرن الثامن (ق م) أخذت خلاصة الحكمة الهندية السامية تظهر تدريجيًا إزاءَ أناشيد "الفيدا"، ليستقر بناؤها في القرن السادس (ق م) بما سمي الـ "الأوبانيشاد". إنها، من جهة، خلاصة حكمية لأفضل ما ورد في "الفيدا"، ومن جهة أخرى، تعميقٌ فلسفي لتفسير الكون، وانتقال من تعدد الآلهة إلى وحدة الألوهة. ويقوم جوهر تعاليمها على تأكيد الوحدة الجوهرية بين الخالق (براهمان) والنفس (أتمان) والطبيعة. وبينما كان الكتاب الرابع من "الفيدا" كتاب ممارسات وطقوس دينية شكلية وسحرية، من شأنها التاثير في إرادة الآلهة أنفسهم بفعل التعازيم والذبائح، إلى حد إجبارهم على استجابة طلبات المصلين، إذا بنصوص "الأوبانيشاد" (النثرية والشعرية) تستنكر الرسوم المدفوعة للكهنة، وتقاوم بقوة الطقوس والتضحيات التي تشببها بالمراكب غير الأمنية، ذلك بأن من يعتمد عليها يحكم على نفسه بالهرم والموت المستمرين، لأن الخلود لا يمكن كسبه بمثل هذه الطرق. فالخلاص من التقمصات إنما يكون بالخلاص التام من الرغبات الدنيوية، فإذا ذاك يحدث الاتحاد مع الروح الكلي "كما الأنهر الجارية تتوارى في البحر فاقدة أسماءها وأشكالها، هكذا الإنسانُ الحكيم، بعد أن يتحرر من اسمه وشكله، ينطلق ليندمج بالكائن الإلهي الذي هو فوق الكل". ( ).
وباستتمام "الأوبانيشاد" صيغتها بدأت في الهند تباشيرُ عهد روحي جديد دان ببنائه لحكماء كثيرين خلال عدة عصور. وليس عجيبًا أن تتلاقى أفكارُ "الأوبانيشاد" الفلسفية الهادية وأفكارُ سقراط وأفلاطون التي ظهرت بعد حوالى قرن؛ فالسيالاتُ الروحية تنتقل من بلد إلى آخر، ومن شخص إلى آخر، وفق نظام إلهي دقيق، حينما تحينُ ساعةُ الهداية والاستحقاق. ففي "الأوبانيشاد" يظهرُ نمط أفلاطون الفكري في التمييز بين المعرفة الأبدية والمعرفة الزمنية. والمعرفة الأبدية الحقيقية تعني الحرية الحقيقية، لأنها تحرر الذات من الرغبات الأرضية وشهوات الجسد.
لكن بالرغم من تمام "الأوبانيشاد"، لم يكن سهلاً أن تستقيم الهندوسية عقائديًا وتطبيقيًا، بعد انحرافها مدى أكثر من ألف سنة، في أثنائها ترسخت الطقوس الشكلية وفروض الذبائح، والعادات والتقاليد والطبقية، ولا سيما نفوذ رجال الدين وعيشهم في البذخ والخمول. أقول هذا بالرغم من ظهور العملين الرائعين "الرامايانا" و"الماهابهاراتا" التي بلغت ذروتها الروحية في جزئها الأوسط "الباغافاض جيتا" (نشيد الرب)، بعد عدة قرون (بين القرن الثالث والثاني قبل المسيح). وبما أن غرض البحث اغلجاري يقتصر على إبداء السببة الروحية الكامنة وراء الأحداث العامة، فإني أترك البحث في هذين العملين إلى حيث أبحث في وحدة الأديان الجوهرية.
ويبدو أن العناية الإلهية اتخذت خطين لإنقاذ المستحقين، الراغبين في الارتقاء الحقيقي من الهندوس: خطًا يستهدف تصحيح معنى الروحانية الحقيقية من حيث السلوك، وآخر يستهدفُ تصحيح المعرفة الروحية، وإزالة الطبقية بعملية اندماج ديني جديد. الخط الأول شق طريقه ماهافيرا، والثاني غوتاما بوذا.
أما ماهافيرا فقد ولد في أسرة ثرية تنتمي لطبقة "الكشاتريا" المحاربين؛ وكان والده حاكمًا. وفي حوالى الثلاثين من عمره، انتحر أفراد أسرته جميعهم بالموت جوعًا تخلصصا من العودة إلى الحياة وفق عقيدة آمنوا بها، وقد أسسها حكماءُ قبل أربعة عصور. فرفض الشابُ، إذ ذاك، أساليبَ العيش الدنيوي السائد، وخصوصًا في طبقة "البراهمة" التي تستغل وتظلمُ سائر الطبقات لزيادة ثرائها وترفها، وتخلى عن كل ملابسه إلا ما يستر العورة وجعل يجول في غرب البنغال متقشفًا، ساعيًا للمعرفة ولتطهير نفسه. وبعد 13 عامًا من إنكار الذات، انضم إليه جماعة من التلاميذ، وسموه "جينا" (الغالب)، أي الأخي من كبار الحكماء الأربعة والعشرين الذين جعلتهم أقدارهم التي استحقوها أن يظهروا في أزمنة منظمة ليُنيروا شعب الهند. وقد أنشأ ماهافيرا نظامًا للرهبان، وآخر للراهبات. وعند موته في عمر الثانتية والسبع7ين، بلغ عدد تلاميذه 14 ألف.
ومن أهم تعاليم "الفيدا" ليست موحاة، وأن النفوس العاقلة تحتل كل شيء، حتى الالحشرات والهواء والماء والنار. أما التقمص فيسري نظامه على الكل/ ولا يخلص منه إلا أرواحٌ سامية كاملة نقية تحيا أشبه بالآهلة في عوالم قصية., وبلوغ هذه العوالم اغلروحية يستحيل تحقيقه إلا بالتقشف الكامل، والامتناع عن السرقة والكذب والملذات الحسية بما فيها شهواتُ الجسد، وعدم إيذاء حتىى الحشرات التي عليهم أن يُزيجوها برفق من طرقهم عند المسير، وعدم قتلِ الحيوان أو أكل لحمه، أو إتيان العنف بأي وجه؛ وهو ما أخذ به غاندي الذي يعتبره الجاينيون واحدًا منهم.ولكن الخاصة التي تنفرد بها الجاينية هي اعتقادها أن الكون أزلي، وليس له خالق وأن التحولات التي تحدث فيه تعود إلى قوى من ضمنه. فضلاً عن ذلك فهي تبشر بالتسامح الديني، وتقف من سائر الأديان وقفة غير نقدية. وهم يكرمون قديسهم ويمثلونهم بالأيقونات، لكنهم لا يعتبرونهم بمستوى الأرواح الإلهية.
لكن معضلة "المنبوذين" ونظام الطبقية وتجاوزات رجال الدين البراهمة لم تحلها الجاينية، إذْ كان تأثيرها ضعيفًا في المجتمع؛ الأمر الذي مهد الطريق لنشوء حركات فلسفية، تشكيكية وإلحادية، عُرِفت بـ"ناستيك". وكان أصحابها يجتمعون في القاعات داخل القصور حيثُ يمنح الأمراءُ، أحيانًا، الغالبين منهم في النقاش جوائز، كما يجولون في الشوارع والغابات، وخصوص2صا شمالي الهند. وجوهرُ فلسفتهم كان يقومُ على أن المعرفة محصورة بما تقره الحواس؛ وأن الدعوة إلى الفضيلة خطأ، لأن غاية الحياة هي الحياة والاستمتاع بها، ولذا فليس من ضرورة للسيطرة على الغرائز والأهواء. يقول ديورانت عن هذه الجماعة التي تكاثرت في القرن السادس: "لق4د أضعفت سيطرة البراهمة على عقلية الهند، وأحدثت في المجتمع الهندي فراغًا كاد يقتضي نمو دينٍ.
وكان على صواب، لأن العناية الإلهية، حيال هذا الفراغ، لا بدن من جهة، من أن تُعاقب المسرف في نعمائه، ومن جهة أخرى، من أن تُرسِلَ هاديًا روحيًا ينيرُ الطريق إلى خلاصٍ حقيقي.
وإذا بذلك الهادي بوذا العظيم. ولا حاجة للتفصيل في تربيته الملكية المترفة. فالمهم، في هذا المجال، أنه، بعد أن سمع نقاش المشككين والملحدين، في بلاط والده كما في أماكن أخرى، وأدرك أن الهند تائهة، شعرَ أن عليه أن يؤدي رسالةً روحية متعددة الأهداف. من أجل ذلك بدأ بالتقشف الصارم، لا يتناول من الطعام إلا حفنة منه كل يوم، وجعل ينام على الشوك وبين الجثث، واجتث شعر رأسه ولحيته... حتى غدا ذابلاً نحيلاً جدًا. أخيرًا، رأى أن جهوده التقشفية لم تفده لبلوغ المعرفة الصحيحة، بل أشعره التقشف المسرف بنوعٍ من الادعاء والكبرياء. فتخلى عنه واعتزل متأملاً بأسباب الحزن والألم والمرض والهرم. والموت. فرأى أن كل ذلك سببه عودة الولادة بعد الموت، وحدوثُ الخيبات بعد الرغبات والاطمئنان... فتأكد له أن تكرر الولادة في الأرض هو الشر كله.
لقد ركز بوذا تعاليمه على الخلقيات، بالدرجة الأولى، على الحب والرحمة وإنكار الذات والشفقة، وكذلك على الامتناع عن الأذى وشهوة الجسد والتناسل، والكذب والسرقة. أما الطقوس وشعائرُ العبادة واللاهوت والميتافيزيقا فلم يهتم بها؛ حتى اللانهاية والأبدية والسماوات كان يرفضً البحث فيها، لأنه لا يفيدُ ارتقاء الإنسان ولا يمنحُ النفسَ سلامًا، إنما يزيدُ النقاش حدةً، وربما يولدُ عداوة. وكان يتهكم على كمهنة الهندوس، وعلى ادعائهم المعرفة الصحيحة، وعلى اعتقادهم أن "الفيدا" موحاة، ويرفضُ فكرة تقديم الذبائح للآلهة، بل يستفظعُ نَحرَ الحيوان من أجل ذلك. وأنكرَ عبادةَ أية كائنات متفوقة، وكذلك التعازيم والتعاويذ، وجميع أنواع التقشف المتطرف. كذلك أنكر أن يكون العقابُ والثوابُ صادرين عن إلهٍ أو آلهة، إذ اعتبرهما نتيجة لأعمال الإنسان ورغباته في حياته الحالية أو السابقة.
لكن التعاليم البوذية لم يتح لها أن تنتشر كثيرًا في الهند حيثُ نظامُ الطبقية، إذْ إن دعوة بوذا جميع الطبقات إلى الانخراط في الدين الجديد أغاظ البراهمة جدًا، إذ كان يقول لتلاميذه: "اذهبوا إلى جميع البلدان وبشروا بهذا الإنجيل.
قولوا لهم إن الفقراء والطبقات الدنيا والأغنياء والطبقات العُليا هم جميعًا واحد، وأن جميع الطبقات تتحدُ في هذا الدين مثلما تتحدُ الانحارُ في البحر" (Durant.pp.433-434). وغضبُ البراهمة الذين كانوا ما يزالون يسيطرون سيطرة شبه تامة على الشعب جعل البوذية تهجر الهند إلى كثير من البلدان المجاورة حيث أصبحت الدين الرئيس فيها.
ويبدو أن نظام العدالة الإلهية المبنى على السببية الروحية اقتضى أن يبقى المجتمع الهندوسي، ولا سيما ملايينُ المنبوذين، تحت ربقة رجال الدين من جهة، والقيود الطبقية من جهة خرى، وأن يظل راسفًا تحت نير الاحتلال الأجنبي ألفًا وخمسمئة سنة أخرى كانت مدى استحقاقه الروحي قبل أن تنعم السماء عليه برحمةٍ تجسدت في شخص هادٍ عظيم هو المهاتما غاندي. ذلك اغلروحاني القديس الذي عاش متعففًا، متقشفًا، صادعًا بالحقيقة، صارخًا بصوت ضميره، شُجاعًا بإعلان الحق، داعيًا إلى إبطال نظام الطبقات، ولا سيما طبقة المنبوذين المظلومين، رافضًا العنف والعصيان المسلح لتحرير الهند من الدولة البريطانية الجبارة، مؤولاً ما جاء في كتب الهندوسية المقدسة تاويلاً يتفق مع العقل والمنطق السديد والضمير السامي. لكنه جزاء لحياته الوادعة النقية ودفاعه عن الحق والعدالة اخترقته رصاصةٌ شيطانية من يد هندوسي ينتمي إلى طبقة البراهمة الحاصرة فيها روح الألوهية. وقد رثاهُ مؤسس الداهشية، منذ مصرعه في 30/1/1948، وذكر فضائله في قطع كثيرة انتثرت في كتبه. ومما قال فيه مشيرصا إلى طبقة "المنبوذين": "ولكن العناية الساهرة لم تهمل هذه الطائفة البائسة، فقد فيضت لهم فيلسوف الهند وقيسها المجاهد الأول: غاندي؛ هذا الرجل النحيل، العازف عن تفاهات هذا العالم الحربائي التلونات؛ هذا الضئيل في جسده، الجبار في عقليته؛ هذا القميء الذي تهتز له أكبر وأعظمُ دولةٍ على هذه الأرض ، هذا الذي تكاد الملايين تعبده لأنها تتأكد من نقاء كفه وصفاء سريرته، وأنه يعمل لأجل إسعادها. فلا الرشوةُ تستطيع أن تناول من طهارة ذمته، ولا التهديد يتمكن من أذنيه؛ أما الوعيدُ فإنه يحتقره ولا يعبأ بشأنه. إن حياة هذا الرجل الكامل لهي أعجوبة جديرة بأن تسجل بأقلام سماوية على طُروسٍ فردوسية. فقد قضى أكثر أيام حياته رهين المعتقلات، أسيرَ السجون، لأجل عقيدته التي ترمي لإسعاد أبناء قومه المضطهدين..."
فهل ستستطيعُ الإصلاحات الدستورية الهندية (1949) بشأن نظام الطبقات أن تنتصر في الهند؟ ربما. هل ستستطيع البوذية والجاينية أن تقاوما إفساد رجال الدين لهما؟ كلا، يقولُ مؤسس الداهشية.
(للبحث صلة)
السببية الروحية في مجرى الأحداث العامة (4)
في ضوء المفاهيم الداهشية: الشرقُ الأقصى
تأثير البوذية في الشرق الأقصى
يحاول علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة أن يفسروا نهوض الشعوب وقوتها أو ضعفها وانحطاطها وفق قوانين يستخرجونها من ماجريات التاريخ ومظاهره الحضارية. لكن استنتاجاتهم، على صحتها، تقفُ عند سطح الحياة. والحياةُ أشبه بنهرٍ من السيالاتِ الحية العاقلة الجارية بين الأزلِ والأبد، والإنسانُ لا يرى منه إلا ما يتكشفُ في اللحظة التي هو فيها. فظهورُ بوذا، مثلاً، كان رحمةً للشعبِ الهندي؛ لكن شعبه بمعظمه فضل استمراره في الخضوع للبراهمة، وبالتالي لحياة الخنوعِ والأوهام والأحلام وآثرَ انجذابه لشهواتِ اللحم والدم مدى مئات السنين؛ وهذا ما جعل الشعب غير مستحق لرحمة الهداية الجديدة، إلا أقلية استطاعت برقي نفوسها أن تنجذب إلى الهادي الروحي الكبير. فجاذبية البوذية الروحية ما كانت لتفعل إلا في أناسٍ سما فيهم الإدراكُ بعض الشيء، كما سمت النزعاتُ واتخذت منحىً إنسانيًا شاملاً، أي في نفوسٍ أعدها مُستواها الإدراكيُّ التروعي إلى تقبل البوذية. وهذا مبدأ عام ينطبق على جميع الهدايات الروحية والأديان السماوية. وقلة القادرين على التجاوب مع التعاليم البوذية مجسدة في الأعمال جعلت الهند تنتظر حوالى ثلاثة قرون قبل أن يظهر فيها حاكمٌ حصل فيه تحول روحي عميق هو أشوكا Ashoka )نحو 273 – 232 ق.م).
لكن قبل أشوكا بحوالى خمسين سنة كان حكمُ جده شاندرا غوبتا Chandragupta Mauria (نحو 325 – 321 ق م) تمهيدًا هندوسيًا – بوذيًا – جينيًا لحُكمٍ فاضل. فعلى قسوته، حاول أن يجمع أفضلَ ما أعطته المذاهبُ الثلاثة. وبعد أن خاض معركةً مع سلوقس نيكاتور Seleucus Nicator، أحد قادة الإسكندر، الذي أسس عهد السلالة السلوقية في إيران بعد وفاة الإسكندر، عاد فعقد معه معاهدةً تنازل سلوقس له بموجبها عن المقاطعات التي عبر الإندوس مقابل 500 فيل قدمها شاندراغوبتا له. واستتم التحالف بزواجٍ متبادل وصداقةٍ سجلتها الكتبث اليونانية والسانسكريتية. واعتنق شاندرا، في أواخر حياته، المذهب الجيني، وسلك في حياة التقشف، بعد أن تنازل عن العرش لابنه بندوسارا Bindusara، ثم التحق بفريق من الرهبان الجينيين ليعيش جنوبي الهند حيث مات بالامتناع عن الطعام حتى الموت على طريقة الجينيين.
أما أشوكا الذي خلف بندوسارا فقد بدأ حكمه بقسوةٍ شديدة على غرار جده تشاندرا غوبتا؛ فأقام سجنًا للمجرمين عُرف بـ"جحيم أشوكا". لكن حدث له انقلابٌ نفسي عميق، فاعتنق البوذية، وأصبح أول ملكٍ عظيمٍ فاضلٍ حكم الهند. وقد أصدرَ مراسيم في غاية الرقي أمر بأن تُنقش على الصخور والأعمدة ليقرأها الناسُ جميعًا ويعملوا بموجبها، وهي تهيب بهم إلى التسامح واحترام الأديان جميعًا، والعيش بصدق وتقوى ورحمة وإحسان وصفاء وسلام واحترام للآخرين. كذلك شيد لكهنة البوذية 48 ألفًا من الأديرة، وبنى باسمها في أرجاء مملكته كلها مستشفيات للإنسان والحيوان، وأرسلَ مبشرين بالعقيدة البوذية إلى سيلان وسوريا ومصر واليونان يكرزون بالمحبة والسلام. تُرى ما الذي أحدث ذلك التحول الفنفسي في أشوكا؟ ولماذا لم يحدث مثل هذا التحول في مَن سبقه من الحكام؟
في ضوء التعاليم الداهشية الموحاة يمكن إعادةُ الأمر إلى سببين رئيسين: الأول أن فئة كبيرة من الشعب استحقت ذلك التغيير الرحيم السامي بما اختزنته من سيالات روحية ارتقت بفعل جهادها الروحي وأعمالها ونزعاتها في حياتها الراهنة كما في أدوارها الحياتية السابقة. والثاني أن أشوكا نفسه ينتمي سياله الرئيسي إلى هادٍ من الهداة، لأن كل مصلحٍ إنساني فاضلٍ عظيم لا بد من أن يكون فيه سيالٌ أو أكثر من الأنبياء والرسُل أو الهداة، ذلك بأن الهداية الروحية ذات منبعٍ سماويٍّ واحد، وهي في أساس رقي الحضارات البشرية وجذبها إلى أعلى. وبذلك يتحقق المثل المأثور "كما تكونون يولى عليكم".
إن أشوكا جاء رحمةً للهند وتذكيرصا لشعبها بتعاليم بوذا، لكن يبدو أن الشعب بأكثريته الساحقة لم يستفد من تلك الرحمة، فعاد القهقرى، وساده الخنوعُ والاستسلام المطلق للبراهمة مجددًا، وكان على الهند أن تنتظر، مرة أخرى، حوالى 800 سنة، ليظهنر فيها حاكمٌ فاضلٌ آخر هو هارشافارذانا (606-647 ب.م)
كان فارذانا من أتباع شيفا، ثم اعتنق البوذية، ومارس في الهند سياسة أشبه بسياسة أشوكا. فاشتهر بأعمال البر التي كان يقوم بها في حفل عظيم كل خمسة أعوام، إذ كان يدعو إليه جمع رجال الديانات، على اختلافها، كما يدعو إليه كل الفقراء والمعوزين في مملكته ويحسنُ إليهم بكل الفائض عن حاجته في خزانة الدولة. وفي ختام حفل التوزيع الذي يستمر ثلاثة أو أربعة أشهر، كان يخلع أرديته الثمينة ومجوهراته فيزيدها على الصدقات. لكن بعد وفاته عاد الانحطاط فاستبد بالهند البرهمية حتى القرن العشرين وظهور غاندي.
وكان على السيالات الروحية البوذية أن تترح إلى البلدان المجاورة كبورما وسيلان وتايلاند وفيتنام ولاوس والتيبت واليابان وكمبوديا والصين.
وشهدت اليابان عهدًا شبيهًا بعهد أشوكا عندما تسلم الأمير شوتوكو تايشي (592 – 621 بم) مقاليد الحكم بصفته وصيًا على العرش للإمبراطورة سويكو. وقد أصدر سنة 604 م قانونًا في غاية النبل والتسامح؛ ورعى الفنون والعلوم، وأدخل الأخلاق البوذية الراقية في صلب القوانين القومية. وبعد هذين الحاكمين البوذيين اللذين وازى حكمهما الرشيد البعثة الإسلامية والعصر الراشدي، لم يظهر في الهند أو الشرق الأقصى ضمن الخط الهندوسي – البوذي أي حاكمٍ فاضلٍ كبير. ولذلك كانت الأوضاع الحضارية العامة لتلك الشعوب لا تحسد عليها.
تأثيرُ لاوتسو في الصين
تلك كانت الحال في الهند والبلدان المجاورة. كذلك في الصين لم تُدّوَّن في السجلات التاريخية أيةُ وقائع عن ظهور هداية روحيةٍ فيها قبل القرن الساسد قبل الميلاد. لكن بالرغم من ذلك، كانت فكرةُ العقاب السماوي مبدا مهمًا في ثقافة الصينيين، الأمرُ الذي يوحي بأصول بعيدة خلفت آثارصا غامضة. ففي الوقائع التارليخية التي ترجح صحتها أن آخرَ حاكمٍ في سُلالةِ شانغ Shang التعي حكمت قطاعًا كبيرًا من الصين بين 1500 و1000 قبل المسيح، أغرق الفسادُ بلاطه الملكي وما فيه من معاونين إلى حد أن السماء غضبت عليه وعلى سلالته، بالرغم من قدرته العسكرية، وحولت وعايتها وتفويضها إلى أسرةٍ كانت تحكمُ مقاطعة تعشاو chou الصغيرة، غربقي الصين، فألهم حاكمها بمهاجمة عاصمة شانغ، فدمرها؛ وحكمت سلالته قطاعًا كبيرصا من الصين من 1122 إلى 771 قبل المسيح.
غير أن المرحلة الحضارية المهمة في تاريخ الصين امتدت من عام 722 إلى عام 481 قبل المسيح؛ وهي المعروفة بعصر تشون تشيو Ch’un Ch’iu . ففيه عاش الفلاسفةُ والحكماءُ الكبار، وعلى رأسهم لاوتسو Laotzu وكنفوشيوسConfucius .
عاش لاوتسو، في القرن السادس قبل الميلاد على الأرجح. لكن حياته ظلت مكتنفة بالغموض والأساطير لابتعاده عن الحياة الاجتماعية كما السياسية وإيثاره الزهد والعُزلة.
خلف عقيدة الطاوية Taoism التي تهيبُ بالناس إلى العيش بعيدًا عن المدن الصاخبة القاسية، والحياة المتعبة السريعة، كما عن النظريات المعتقدة، وأن لا يدعوا العلوم والقوانين البشرية تستعبدهم، لأن المعرفة لا تعني الحكمة ولا الفضيلة، ولا هي تُفيدُ بحد ذاتها روحيًا، ولا تقدم الطمأنينة والسلام النفسي، ولا تقرب من الـ"طاو" الذي يعني الله أو الحقيقة المطلقة الأزلية الأبدية، أو أصل الكون وغايته، أو الطاقة الجهورية المبدعة الكامنة في كل الموجودات، والقوة الثابتة وسط المتحولات، والفاعلة حيثما كان؛ أو "الطاو" هو، بمعنى آخر، الطريقُ المستقيم (طريق السماء) الموصل إلى الله. ويستحيلث إدراكُ "الطاو" أو سلوكُ طريقه إلا بالحياة الريفية البسيطة، البيئة العفوية، الوديعة المتواضعة، القائمة على العمل الهادئ الصامت، المسالم المحب الخير، كما على الاقتداء بالطبيعة وقوانينها، والتأمل في مظاهرها وتحولاتها؛ فمن خلال ذلك، ومن خلال الصراحة وتجنب الأنانية، وتقليل الرغبات، وعبر النشوة الروحية المستمدة من التأمل والحدس لا من البراهنين العقلية، يمكن سلوك الطريق المؤدي إلى "الطاو".
وقد جمعت تعاليم لاوتسو، بعد عدة قرون على الأرجح، في "كتاب الطاو والتي" Tao-te- Ching الذي يتالفُ من 81 فصلاً متفاوتة الطول؛ وهو يعتبر من أثمن ما كتب في الفلسفة الروحانية، بالرغم من غموضه. وسواءٌ بقيت التعاليم مثلما كانت في أصولها، أم طرأت زياداتٌ عليها في سياق العصور، وفق ما يذهب بعض المؤرخين، فإن جوهرها الذي ينسب إلى "المعلم القديم" لم يتغير.
وقد كان لحياة لاوتسو الزاهدة وتعاليمه تأثير عظيم في أتباعه كما في الحضارة الصينية. فقد اعتبرته فئة من الؤمنين به منبثقًا من الله. ومخلص العالم، ونادت به فئاتٌ أخرى قديسًا. وبعد ظهور كنفوشيوس، أكبره الكنفوشيون ونسبوا إليه لقاءات مع معلمهم أجل فيها لاوتسو كل الإجلال. وبعد ظهور بوذا، ذهبت الاجتهاداتُ الطاوية إلى أن للاوتسو عدة شخصيات تهبط إلى الأرض بأسماء مختلفة وفي أزمنة مختلفة لتهدي الناس والحُكام، وأن بوذا كان إحدى شخصياته.
وعلى الصعيد الحضاري أحدثت تعاليمُ لاوتسو تأثيرًا بالغًا في الفكر والأدب والفن في الصين مدى قرونٍ كثيرة. وإليه يعودُ بروزُ ملامح السلام والبساطة والعيش قريبًا من الطبيعة في عدة أجيال من الصينيين.
لكن "الطاوية" التي أرادها لاوتسو طريقةً لحياة بسيطة نقية مطمئنة، أفسدها رجالُ الدين بعد بضعة قرون، فأدخلوا إليها اهتمامات باطلة كثيرة، منها شعوذاتُ السحر والتعاويذ، والتنجيم، والبحث عن الطرق الطبية التي تطيل الحياة، والطكرق الكيميائية التي تحول المعادن إلى ذهب... فبعدوا بالعقيدة جدصا عن أهداف مؤسسها، وكانوا سببًا لانحطاط مظاهر حضارتهم الفكرية والأدبية والفنية.
تأثيرؤ كنفوشيوس في الصين
أما كن كنفوشيوس فقد فقد أباه في الثالثة من عمره، فربتهن أمه في ما يقارب القر. فاضطر إلى تعاطي أعمال وضيعة لتحصيل معيشته. وقد حصل معظم علمه بنفسه. وحياته الفقيرة العسيرة عرضته لتعرف حياة العاديين من الناس، فشعر بعذابهم وتأثر لأحوالهم، وفكر، مثلما فكر بوذا، بالقيام بعمل ما لتحسين أوضاعهم. وبعد أن تزوج في التاسعة عشرة ورزقَ صبيًا وابنتين، آثر اعتزال أسرته بعد أربع سنوات، من أجل تحقيق حلم حياته الكبير الذي استهدف إصلاغح الحكم وإصلاح المجتمع. فتسنم عدة مناصب في الدولة. وفي الحادية والخمسين تولى وزارة العدل ثم رئاسة الحكومة. وقد ازدهرت مرافق البلاد في عهده، ونجحت سياستها الخارجية.
لكن أمير البلاد ما لبث أن أصم أذنيه عن إرشادات كنفوشيوس وتعاليمه، واستسلم إلى الملذات الحسية، الأمر الذي جعل المصلح الكبير يغادر الإمارة متنقلاً من بلد إلى آخر في الصين، وهو بين السادسة والخمسين والثامنة والستين من العمر. وفي هذا العهد المضطرب أنشأ تعاليمه متعرضًا للإيذاء والاضطهاد أحيانًا كثيرة؛ لكنه لم ينثن عن هدفه، لأنه كان مؤمنًا بأن شريعة السماء تكشفت له. يقوم جوهرُ تعليمه على إنقاذ الإنسان ببناء سلوكه على العقل كما على الأصول الروحية النقية. ولا تعني الأصول الروحية محاكاة لأفكار السلف وعاداتهم وتقاليدهم، بل التزود بالأفكار السامية الخالدة وبكل ما هو حق وخير من أجل الإنطلاق قدمًا. وهذه الغاية توجب، من جهة، عدم الانخداع بمظاهر المدنية (كاختراع عجلات النقل والمراكب وعربات الحراثة وما إلى ذلك)، إذ إن تاريخ الحضارة الحقيقية، في نظره، يبدأ مع الذين وضعوا الشرائع الصالحة وقواعد المناقب الكريمة أسسصا للمجتمع والدولة؛ ومن جهة أخرى تقتضي هذه الغاية السامية تعلم مبادئ الخير؛ وهذا لا يعني حفظها غيبًا، بل صيانتها وممارستها ممارسة نفسية وعملية. فليست الثقافة بحد ذاتها هي المهمة، بل معرفة الاستفادة منها في الحياة السلوكية والعملية، بحيث تصبحُ في الإنسان قوة مبدعة محركة إلى الأصلح والأفضل.
وقد أيقظ كنفوشيوس العقل في الصين، فكان معلم الخلقيات العقلانية، يدعو إلى أشبه ما دعا إليه سقراط وأفلاطون: بناء مجتمع فاضل يحكمه ملوكٌ فلاسفة فاضلون يكونون قدوةً لشعوبهم، فيعيشُ الجميعُ بطمأنينة وسلام في ظل نظام عادل. كذلك أنشأ مدرسةً لتعليم ما يجب تعلمه من الآداب والفنون والعلوم النافعة في الحياة، ولإعداد رجال الدولة الصالحين الكفوءين؛ فتربيةُ رجالٍ فاضلين يُساندون الحكم أفضل من الشرائع الكثيرة للشعب. وأهم الأركان التي تقومُ عليها الحكومات الناجحة، في نظره ثقةُ الشعب بها، بحيث يفضل أن يضحى، لدى الخيار الحرج، بالجيش ثم بالاقتصاد، ولا يضحى بها.
بيد أنه رأى أن تعلم الحقائق لا يستطيعه كل فرد، إذ إن شرطه الأول استعداد خلقي عال لدى التلميذ يظهر في سلوكه بين رفاقه، وفي أسرته، واستعدادٌ إدراكي، ورغبة في المعرفة. ولذلك لم يهتم بدفع الناس للبحث عن الحقيقة، إذ رأى أن المجتمع السليم يقومُ على أعضاء فيه سليمين؛ ولذا جعل محور فلسفته الخير لا الحقيقة: محبة الآخرين، تعزية المسنين ومساندتهم، رعاية الأحداث، المحافظة على الصداقة، وبالدرجة الأولى سعى كل إنسان لتحسين سلوكه وترقية نفسه، وامتناعه عن معاملة الآخرين معاملة لا يودها لنفسه؛ وهي القاعدة المثالية التي تذكرنا بتعليم السيد المسيح بعد 500 سنة.
وقد أولى كنفوشيوس الأسرة اهتمامًا خاصًا، فأوصى بقيام رابطة قوية بين أفرادها، فيقدم الأولاد طاعة واحترامًا تأمين لوالدهم، وينهسبون فضل مآثرهم وحميد تصرفاتهم إليهم بينما يتحمل الآباء مسؤولية أخطاء أولادهم وقبائحهم. كذلك وضع كنفوشيوس مبادئ الصداقة الحقيقية، وأسس التعامل بين الرؤساء والمرؤوسين، وقواعدَ الحكومة الصالحة والدولة الفاضلة.
أخيرًا، مات كنفوشيوس وفي قلبه حسرة، لأنه عندما نظر حواليه باحثصا عن رجل شريف أو رجل يصلح لأن يكون حاكمًا، لم يجد بغيته. ومع ذلك لم ييأس، بل قال إن عصره مريض.
ولم يطل الزمن، بعد موته، حتى أخذ أتباعه يحرفون تعاليمه مدخلين فيها بعدًا غيبيًا، ومحولين جوهرها النقي إلى شرائع جامدة وركام من المعارف... والأدهى أن أتباعه نصبوه إلهًا، في مطلع القرن العشرين، وهو الذي رفض أن يسمى قديسًا.
لقد كان كنفوشيوس حاصرصا اهتمامه بطبيعة الإنسان وسلوكه، بينما كان لاوتسو مهتمًا، بالدرجة الأولى، بالحياة الريفية البسيطة النقية وسط الطبيعة العذراء وإيحاءاتها الروحية. وفي حين أن الكنفوشية تولي المجتمع وسياستة الحكم الأهمية الكبرى، فالطاوية تولي الفرد وعلاقته بالكون كله الأهمية الأولى. والمتبصر في تعاليمهما لا يراهما يتناقضان بقدر ما يتمم الواحد الآخر. ففي تعاليم لاوتسو نستشف لمحاتٍ من روحانية المسيح وآراء روسو Rousseau في ضرورة عودة الإنسان إلى الطبيعة، كما نستشف في مبادئ كنفوشيوس لمحاتٍ من تعاليم سقراط وأفلاطون وآراء فولتير.
إن الأحداث العامة التي وقعت للشعب العبراني خاصة، والشعوب المحيطة به عامة، عرفنا أسبابها الروحية من الوحي الإلهي الذي كان يتنزل على أنبياء العهد القديم. ولكن كيف نستطيع أن نعرف الأسباب الروحية للأحداث العامة التي جرت في الشرق الأقصى، مسرحِ تعاليم ذينك الهاديين؟
القاعدةُ الروحية العامة التي تعلمنا إياها الداهشية هي أن أخلاق الشعوب والحكام المجسدة في رغباتهم ونزعاتهم وأعمالهم، خيرصا أو شرًا، هي التي تحدد مصيرهم وواقع حياتهم سلامًا أو اضطرابًا، ازدهارًا أو شقاءً. وليس ضروريًا أن تظهر النتيجة في جيل واحد، فالأجيالُ مترابطة بعضها ببعض، سابقُها يؤثر في لاحقها، تأثير الوالدين في الأولاد والأحفاد، لأن السيالات الروحية لا تنطقع بين جيل وأخر، بل تمتد باستمرار، ومعها يمتد التأثير متبوعًا بالنتيجة. لكن لا بد من إيضاح، في هذا السياق، هو أن الله الرحيم لا يعاقب شعبًا على أعماله إلا بعد أن يُرسل إليه من يهديه، نبيًا أو رسولاً أو هاديًا، وذلك بالرغم من وجود نور العقل في الإنسان. وهذه الحقيقةت جلية في عدة آياتٍ في القرآن الكريم، منها خطابه تعالى للروسل العربي الكريم، إذ سأله الكافرون أن يستترل آية محسوسةً من الله: (إنما أنت منذرٌ، ولكل قومٍ هادٍ)(الرعد: 7)؛ كذلك (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) (الإسراء: 14).
ولا شك بأن تعاغليم لاوتسو كنفوشيوسكانت الموقظ والمحرك لأجمل وأرقى ما في الحضارة الصينية من فكرٍ وأدب وفن وسياسة. وكانت النار التي تذوبُ في حرارتها ونقاوتها كل غلظة ووحشيةٍ وفوضى في الطبيعة البشرية، بحيث يمكن أن ينسب إلى فضلها، بالدرجة الأولى، ما ساد بنية الصين الثقافية وخلقيتها السياسية والاجتماعية من تناسق وتآلف وسلام، ومن محبة للمعرفة والمحكمة، برغم الاضطرابات التي كانت تشوش هدوء تلك الحياة من حين إلى آخر، وذلك على مدى أكثر من ألفي سنة. يقول عالم الاجتماع والمؤرخ الكبير ول ديورانت: "لسنا نجد في هذا الزمان، كما لم يجد القدامى في الزمان الخالي، علاجصا ناجعًا لمن يعانون اضطرابصا ناجمًا عن تربية تقصر عنايتها على العقل، كما عن قانونٍ خلقي متدهور ووهنٍ في الأخلاق الفردية والقومية – لسنا نجد علاجًا لهذا كله خيرصا من تلقين أحداث الأمة مبائ الفلسفة الكنفوشية.
بعد وفاة كنفوشيوس بنحو قرنين، قام منسيوس Mencius (371 – 289 ق م)، أعظم أتباعه، وتلميذ حفيجه، فضارع معلمه الأول بقوة تأثيره، لكنه استقل عنه بالتركيز على نقاط ثلاث: الأولى تأكيده أن طبيعة النسان الأصلية خيرة؛ والثانية أن العظمة الحقيقية تكمن في نفلس الفرد المتبع صراط "الطاو" المؤدي إلى الخلاص، لا في المجتمع؛ والثالثة تشديده على الديمقراطية وحق الشعب في الثورة على الحاكم الطاغية.
بعد وفاة منسيوس بنصف قرن، استولى على عرش الصين إمبراطور طاغية هو شي هونُغ تي shih Huang-ti (221-209ظ201 ق م)، فأمر بإحراق الكتب الكنفوشية مع سائلر الكتب التاريخية والأدبية، ووحد إمارات الصين في دولةٍ واحدة للمرة الأولى في التاريخ، وأمر بتشييد سور الصين العظيم الذي يعتبر أضخم ما بناه الإنسان على مر الزمان، وسمى نفسه "الإمبراطور الأول"، مبتغيًا بذلك أن يمحو ذكر كل من سبقه، ليكون هو مؤسس تاريخ الصين؛ كما أمر بأن يتخذ أحفاجه من بعده أرقامًا متتابعة حتى تتم سلالته بالقرم عشرة آلاف. والأخطر أنه حكم شعبه بالحديد والنار.
ولكن هل تجري أحداث التاريخ وفق ما يريده الإنسان، خصوصًا متى كان صاحب بأسٍ وصولة وسلطان، أم تبعًا لنظامٍ إلهي مبني على الاستحقاق والسببية والروحية العادلة مثلما تذهبُ الداهشية؟
إن "الإمبراطور الأول بغطرسته وظلمة ليشبه نمرود، وبناء السور العظيم ليشبه بناء برج بابل. فما إن مضى حوالى أربعة أعوام على موته وخلافة اثنين من أسرته له 209/210 – 206 قم) حتى ثار الشعب المظلوم على ظالميه، وقضى على الأسرة الطاغية. فلا السور العظيم نفعه، ولا توحيد الصين، ولا أحلامه بسلسلة الآلاف العشرة من الأباطرة في سلالته. لقد اندثر حكمه ليبقى اسمه لعنةً على ألسنة الصينيين، ولتبقى من بعده تعاليم كنفوشيوس ولاوتسو، لأنها مستمد من سيالات الهداية الروحية التي ترسلها السماء إلى بني البشر، دواء ناجعًا لكل فئة منهم رحمةً بهم.
ولم يمض زمنٌ طويل على موت الطاغية حتى تسنم عرش الصين وو- تي wu Ti (140 – 87 قم)، أعظم الأباطرة من سلالةى هان Han، فأعاد الاعتبار إلى تعاليم كنفوشيوس، وقام بحركة إصلاحية اجتماعية واقتصادية عظيمة، إذ جرى على سياسة السلم، وأعاد إلى الشعب حرية القول والكتابة وانتقاد الحكومة، وحظر تعيين أي مواطن في مناصب الدولة إلا بعد اجتيازه امتحانصا تضعه الحكومة لهذا الغرض. كذلك سن أنظمة اشتراكية ملطفة تحول دون استثمار أية فئة من الشعب لفئة أخرى؛ فعاشت الصين في عهد رخاء لم تعش مثله من قبل. علاوة على ذلك، ازدهر العلم في عهده، وكثر الشعراء والفنانون.
لكن بعد موته أخذ نفوذُ النساء يتفاقم في دوائر الدولة، وبدأت الفوضى والمفاسد تدبُّ في الشعب، فانحرف عن تعاليم الهداة المصلحين.
ومع بدايات التاريخ المسيحي تسنم عرش الصين مصلحٌ آخر هو تشيا هوانغ تي Chia Huang-ti (نحو 9 – 23 ب م)، فأعاد إصلاح الأنظمة السياسية والاقتصادية، وألغى الرق في البلاد، وحمى الزراع والمستهلكين من جشع التجار، وناصر الأدب والعلم، واشتغل هو نفسه بهما، وقرب إليه أهلهما. وكان يعيشُ عيشةً مقتصدة، ويوزع دخله على أقربائه وعلى الفقراء من أهل البلاد؛ وباختصار، كان مثال الرجل الصيني المهذب الكامل. لكن يبدو أن معظم الشعب لم يستحق هذا المصلح ولا مشاريعه الإصلاغحية، فثارت عليه فئاتٌ ناقمة وقتلته. وبقتله قتلت السلام والازدهار في البلاد؛ فعادت المفاسدُ والفوضى تتحكم بها ومعها النكبات الطبيعية. ومرت ستة قرون على الصين قبل أن يقيض لها حاكمٌ فاضلٌ كبيرٌ آخر.
كان هذا الحاكم الفاضل تاي تسونغ TG’ai Tushg (627 -649( من سلالة تانغ Tang . وعهده يوازي أواخر عهد البعثة النبوية العربية والخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل. تمسك بالتعاليم الكنفوشية، فرفض ضروب الترف في قصره، وأبعد عنه الغوابي، وحكمَ بالعدلِ والتسامح، ومنح شعبه حرية المعتقد؛ فأم المبشرون الصين من بوذيين وزردشتيين ونسطوريين مسيحيين. فكان يُرحبُ بهم ويبسط عليهم حمايته، ويعفي معابدهم من الضرائب. وقد شهد عهده ازدهارًا وبحبوحةً كبيرين، كما شهد نهضة أدبية وفنية عظيمة، إذ كثر الشعراء والفنانون وتقلدوا مناصب عالية؛ فأصبحت الصين في عهده، على حد قول ديورانت: "أعظم الإمبراطوريات قوةً، وأكثرها استنارة، وأسماها رُقيًا، وأفضلها حكمًا وحضارة على سطح الأرض" (ص 703).
ومع أن الصين شهدت نهضة كبيرة في الفن والعلم في عهد سلالة سونغ sung (860 – 1276)، فإنها لم تعرف بعد تاي تسونغ إمبراطورًا كبيرصا وصالحًا آخر، لكنها عرفت في عهد الإمبراطور شن تسونغ Shen Tsung (1067 – 1086) عالمًا وأديبًا تولى صلاحيات واسعة وكان شديد الاهتمام بتطبيق مبادئ كنفوشيوس هو وانغ آن- شي Wang An-shih (1021 – 1086). وقد انصرف إلى العمل لرفاهية شعبه، غير مهتم بشخصه ولا بلباسه ولا بما يصيبه من إرهاق. اقام نظامًا اشتراكيًا صالحًا استهدف خير الشعب، وإنقاذ الزراع من المرابين، وإعانتهم من مال الدولة، وإغاثة الطبقات العاملة ورفع الحيف عنها. كذلك أصلح اساليب التعليم ونظام الامتحانات، وأجرى معاشات على الشيوخ والفقراء المتعطلين، وقام بأعمال هندسة عظيمة لمنع الفيضانات (ص 724 – 726)
لقد أتى لاوتسو و كنفوشيوس هادتين للشعب الصيني، مثلما أتى بوذا وماهافيرا وغيرهما من الحكماء هداةً للشعب الهندي وما حوله من شعوب، وذلك في زمنٍ كاد الوحي فيه يكف عن العبرانيين. لكن البشر، حيثما كان، يسمعون أصوات هداتهم حينًا، وأحيانًا يصمون آذائهم عنها. والقاعدة الروحية تبقى واحدة: ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد. وبناءً على هذه القاعدة فعهودُ الاطمئنان والسلام واليُسر التي شهدتها الصين لم تكن لتعادل بطولها عهود الاضطراب والعذاب والشقاء. فالسجلات الصينية حفظت تأريخ 290 وباءً فتاكًا أصابت الصين كلها أو مقاطعات منها إصابات متقطعة بين سنة 243 ق م وسنة 1911 بعده، وقضت على ملايين السكان.
كذلك نشبت في مناطق مختلفة من الصين بين عام 111 قبل المسيح وعام 1978 بعده 87 حربًا أو ثورة أو فتنة أهلية زادت الفجائع والكوارث.
وفي ما يأتي من هذا البحث سنرى أن النظام الإلهي أطلع في اليونان خطأ آخر من الهداة موازيًا في الزمن لخطي الهند والصين. وهذا يؤكد أن العناية الإلهية تختط تصميمًا تجعل فيه لك شعب هاجيًا أو أكثر يكون صالحًا له، أي لمستوى مداركه وطبيعة نزعاته وأنواع استعداداته، وبكلمة أخرى للقوى النفسية التي تختزنها سيالات الشعب الروحية التي تبرمج جينات كل فردٍ فيه وهو في طور تكونه. فكل إنسان، وفق التعاليم الداهشية الموحاة، يولد وفيه سيالُ دين معين. وإذا غير الإنسانُ دينه باختياره وملء رضاه، فإن سياله الديني يكون قد تغير. فـلا إكراه في الدين (2:256). أما إذا حدث الإكراه، فلا المغصوبُ على أمره سيستفيد روحيًا، ولا الدين الذي أجبر على اعتناقه سيستفيد منه، لأن سيالاته، من خلاله ومن خلال سلالته من بعده، ستسعى واعيةً أو غير واعية إلى تخريب الدين الذي غُصبت على اعتناقه.
(للبحث تتمة في العدد المقبل)
السببية الروحية في مجرى الأحداث العامة (5)
في ضوء المفاهيم الداهشية: اليونان
بقلم الدكتور غازي براكس
لا بد من الإلماع مجددًا إلى أن النظرة الداهشية إلى سببية الأحداث العامة (وكذلك الأحداث الخاصة) تتخطى نظرة معظم المؤرخين وعلماء الإجتماع والمحللين السياسيين التي تجعل القوى الاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها المؤثرات الوحيدة في تطور المجتمعات البشرية. فهذا التعليلُ، على صحته الظاهرية، يفترض أن الإنسان هو السيدُ المطلق لمصيره وأن كيانه الحياتي محصورٌ بوجوده الحاضر، فلا وجود له قبله، وليس من نظام إلهي مبني على العدالة والاستحقاق الروحيين يسود الكون كله. فالداهشية تنفي الصدفة وتقولُ بأن ما يحدد مصير كل مجتمع هو خلقية أفراده ومستوى مداركهم وصلاح أو طلاح أعمالهم، لا في جيل واحد بل في عدة أجيال، وخصوصًا تقيدهم بالإرشادات والتعاليم التي تنفحهم بها الهدايةُ الروحية التي ظهرت بينهم. فكيف نُعلل تطور المجتمعات الإغريقية في ضوء المفاهيم الداهشية؟
عصور الاستبداد والغوغاء
لن أبحث في أصول الأغارقة، فالتارليخُ فيها يختلطُ بالأسطورة. لكن من المفيد أن أشير إلى أن العالم الإلهي الأولمبي مثلما تجلى في ملحمتي هوميروس، "الإلياذة" و"الأوذيسة"، يكاد يكون على غرار المجتمع الإغريقي. فمن القرن العاشر، عصر هوميروس، إلى القرن السادس (ق.م.) كان الأغارقة قبائلُ مستقرة في أماكن مختلفة من اليونان، كل منها تسودها العشيرة الأقوى ويرئسها زعيمها. وكانت الزعامة وراثية. وكل عشيرة تدعي الانتساب إلى شخص أسطوري ينتمي إلى بعض الآلهة. وكانوا يؤمنون بأن الآلهة يخالطون البشر ويتدخلون في شؤونهم مباشرة ويتحيزُ كل منهم لفريق أو شخص معين. في هذا الإطار وقعت، في القرن الثاني عشر (ق.م.) حربُ طروادة التي أتحدث فيها جيوشُ المدن اليونانية تحت إمرة أغاممنون لاستعادة هيلانة، زوجة الملك مينلاوس Menelaus، التي خطفها باريس Paris، ابنُ بريام Priam ملك طروادة، من عُقرِ دارها. لم يكن في تلك الحقبة من وجودٍ لدينٍ عقائدي ذي نظام خُلق4ي ملزم وإجلالٍ حقيقي للألوهة. فممارسة الدين تختصر بطقوسٍ واحتفالات تخاطب الحواس وترمز إلى الظاهرات الطبيعية والعناصر الأولى وعلاقة الآلهة والأرض والإنسان، بها. ولم يكن المجتمعُ الإلهي الأولمبي نفسُه يدعو إلى الفضيلة والإخاء والمحبة والرحمة. فلا بأس من أن يسقط ألوفلإ من القتلى وتقوض دولة من أجل استعادة امرأة، ذلك بأن الثأر للشرف كان هو القاعدة. وعلى ظهور هزيود Hesiod، في القرن التاسع (ق.م)، الذي نادى في ملحمته "الأعمال والأيام" بعدالة الآلهة وكمالهم، فإن صوته لم ينفذ إلى ضمائر
لم يكن في تلك الحقبة من وجود لدين عقائدي ذي نظام خلقي ملزم وإجلال حقيقي للألوهة. فممارسة الدين تختصر بطقوس واحتفالات تخاطب الحواس وترمز إلى الظاهرات الطبيعية والعناصر الأولى وعلاقة الآلهة والأرض والإنسان بها
الأغارقة ولا غير شيئًا من عاداتهم وخلفيتهم. ولذلك انتشر الاقتتال بينهم، وتكاثر المستبدون كما المظالم. وكان القدر الذي لا يرد جزءًا من ثقافتهم. فقوه الغامضة كانت تسيطر حتى على الآلهة. لكن الأقدار تبدو أحيانًا غير جامدة، فمحاربها تتغير بتغير الأعمال. مثاله إذا تزوج زوس ثيتيس، فابُنه سيطيح به عن عرشه. فالإتيان بالعمل حر، لكن نتيجته محتومة. والآلهة يُرشدون البشر بإلهامهم لتفادي الأعمال التي تؤدي بهم إلى المهالك أو المصائب، لكنهم لا يتدخلون في ما تؤدي إليه تلك الأعمال إذا اختارها البشر. لكن قلما كانت العقلانية تداخل أعمال العامة وسلوكهم.
وفي أواخر القرن السابع وخلال القرن السادس (ق.م.) ظهر حكام في اليونان أدخلوا بعض الإصلاحات العملية السياسية والاقتصادية، فسموا بـ"الحكماء السبعة"؛ وكان أبرزهم سلولونSolon (639؟-559؟ ق.م) الذي خفف أعباء البؤساء، وأعاد الأتزان إلى أثينا بمنحها دستورًا أكثر ديمقراطية. لكن "الحكماء السبعة" جميعًا وجدوا مقاومةً من فئات مختلفة. وقد ظهرت قوةُ العقل الستنير مقابل الإيمان بالقدر المحتوم، أول مرة، في خطبة وجهها سولون لمواطنيه قال فيها: "إن مدينتنا لن تهدم بقوة قدرِ زوس... بل إن المواطنين أنفسهم سيهدمونها بجنونهم". وقال أيضًا "إذا كنت تعانون الشر من جراء الفساد الذي قمتم به أنتم، فلا تلوموا الآلهة، لأنكم أنتم بأنفسكم جعلتم ظالميكم كبارًا" (ص 273). بهذه الكلمات أنار سولون أول مصباحٍص من مصابيح العقلانية في أثينا. لكن يبدو أن بذوره لم تلق أرضًا خصبة. وما قاله تحقق.
وبعده بحوالى ثلاثين سنة أسس فيثاغورس جمعية دينية وعلمية انضم إليها أتباعٌ من العلماء والفلاسفة ومئات من طلاب المعرفة رجالاً ونساءً، كثيرون منهم كانوا يعتبرونه أبولو مُجسدًا. وكان أول من منح النساء، قبل أفلاطون، حقوقًا وفُرصًا متكافئة. كان هدفُ جمعيته إصلاح المجتمع إصلاحًا خلقيًا. وكان لها نقاطُ التقاء كثيرة مع "الأورفية" Orphism (نسبةً إلى أورفيوس الاسطوري)، إذ إن هدف الجمعيتين كان تنقيه النفس من أجل تمكينها من التحر من "عجلة الولادة". ويمكن إيجاز تعاليم جمعية فيثاغورس في ثلاث نقاط: أولاً، التقمص حقيقة؛ لكن يستحيل أن يتحرر نهائيًا من الجسد إلا النفوس التي تبلغ درجةً عالية من النقاء. ثانيًا، الجسد سجن للنفس، وواجب الفلسفة أن تقضي إلى التأمل في معنىت الموت وطرق التحرر من الجسد. ثالثاً، الحياة النقية تقوم على إطاعة النواهي التي نتجت عنها المحرمات الأصلية، وعلى الإنسان أن يسأل نفسه كل مسصاء: بماذا سقط؟ ما الخير الذي فعله؟ ما الذي لم يفعله وكان يجب أن يفعله؟
لكن كيف عومل فيثاغورس – الذي قال عنه المؤرخ البريطاني، ديورانت Durant، "إنه مؤسس العلم والفلسفة مثلما عرفناهما في أوروبا" – من قبل شعب مدينته، كروتونا Crotona؟ لقد أحرفوا المنزل الذي كان أتباعه يجتمعون فيه، وقتلوا كثيرين منهم، والبقية طردوهم من المدينة. أما فيثاغورس فقد تضاربت الرواياتُ في مصيره. فمنهم من قال إنه قُتِل بأيدي الغوغاء، ومنهم من قال إنه غادر المدينة إلى مكان آخر حيثُ اعتزل ثم صام 40 يومًا مات على أثرها. وهكذا أضاءَ فيثاغورس المصباح الأول للهداية الروحية في اليونان، لكن الغوغاء أطفأته! فما الذي جعل الأغارقة عُصاةً للإصلاحِ الخلقي؟
تنهضُ عدة أسباب؛ أهمها أن الدين اليوناني السائد منذ حرب طروادة (القرن الثاني عشر ق. م.) لم يكن عاملاً ايجابيًا ذا تأثير حسن في سلوك الناس وخلقيتهم. فقد كان أشبه بنظكام "سحري"، لأن ممارسة الطقوس ممارسة صحيحة تبعًا للتقاليد كانت أهم من السلوك والخلقيات؛ فخلاصُ الإنسان كان بالطقس الصحيح، لا بحياته النقية. زِدْ إلى ذلك أن الآلهة، في المفهوم الشعبي، لم يكونوا كاملين في نزاهتهم واستقامتهم وعدالتهم وعفتهم ولُطفهم، ولا يُمكنُ أن يتخذوا مِثالاً أعلى في المحبة والرحمة. ولذلك لم يكن من رادعٍ روحي واضح للأغارقة ينهاهم عن المحرمات ويضعُ لهم حدودًا. فالمجتمع الإغريقي كان أشبه بالشاب الغرير، ينفعل حتى البكاء ويعطف على أهل بيته من جهة، ومن جهة أخرى يأخذ بالثأر، ويسطو على المراكب بالقرصنة، وإذا اجتاح بلدةً، قتل جميع رجالها أو باعهم عبيدًا، وسبى نساءها وأطفالها أو استعبدهم. والكذبُ والحنثُ بالوعد لدى أبطالهم عند مواجهة أعدائهم كانا يُمدحان. يقولُ وِلَ ديورانت: "سر ذلك أن مقياس الآخيين Achaeans في الحُكمِ على الأمور يختلف عن حُكمنا اختلاف فضائل الحرب عن فضائل السلام... فالرجل الفاضلُ ليس اللطيف الصبور، الصادق المعتدل، المجتهد الشريف؛ إنه من يقاتل قتالاً شجاعًا ممدوحًا. أما الرجل الرديء فليس من يُسرِفُ في شُربِ المسكرات، ويكذبُ، ويقتل، ويخون، بل من يكونُ جبانًا، أحمقَ وضعيفًا". ولعل لُحمةَ الأسرة هي الميزةُ الإيجابية الوحيدة التي اكتسبها الإاغريقُ من دينهم3 (ص 50 و 200 – 202).
وقد مرت قرونٌ على مدن اليونان من غير أن تعرف قوانين تضبط أوضاعها السياسية والاقتصادية. فالمساواة أما القانون، والأسسُ الخلقية في التعامل، والديمقراطية لم تكن معروفة، والثرواتُ والممتلكاتُ كانت محصورة بين أيدي قليلين، بينما الأكثرية كانت في عوزَ. و"الحكماء السبعة" – علتى سنهم بعض الشرائع العملية للمواطنين – لم يكونوا حكماء فاضلين حقًا، ولا استطاعوا إنشاءسً مفهومٍ مجرد للدولة. فالدولةُ في إسبرطة أو أثينا كانت في الوجودِ الحي لأبنائها ومظاهرها وهياكلها ومذابحها وحياتها الاجتماعية وتقاليدها. وإن يظهنر في مدينة ما حاكم يحاول أن يكون عادلاً، فما تلبث الارستقراطية أو الغوغاء أن تعترض أعماله، أو يتكاثر حوله المتملقون والمتزلفون حتى يدفعنم الحسدُ إلى الطعن بفضله. وزاد الطين بلا أن القادة والحكام، بصورة عامة، كانوا يلجأون إلى "وسطاء الوحي" المزيفين من الكاهنات أو الكهنة ORACLES لاتخاذ قراراتهم، قبل خوض حرب أو اتخاذ موقف حاسم في إدارة الشؤون العامة، الأمر الذي شل الأحكام العقلانية.
لكن بالرغم من ضعف الأغارقة الخلقي وتنافرهم داخليصا حتى في مدنهم نفسها، فإن الحماسة وحدت كثيرين منهم ضد أعدائهم الخارجيين. فقد استطاع جيشُ اليونان الصغير أن ينتصر على جيش الفرس الهائل الضخامة، أول مرة، في معركة ماراثون (490 ق.م.) ، وثاني مرة في معركة سالاميس (480 ق.م.). وبعدهما فُتحت جميعُ المرافئ في البحر المتوسط للتجارة اليونانية. فهل كان دهاء اليونان ووحدةُ صفوفهم الآنية كافيين لانتصار جيشهم الصغير على جبروت جيش داريوس ثم أحشورش الأول الذي كان قد أخضع مصر وبلاد الكلدانيين وثراس Thrace ومقدونيا وثيسالي Therssaly واجتاح اليونان ودمر أثينا، وأمعن تشويهًا بآلهتها؟ هل كان طبيعيًا أن يقتل من القوة اليونانية، وفق المؤرخين، 159 جنديًا فقط مقابل 260,000 جندي من الفرس؟ (ص 234 – 242) لا بد من أن يكون لذينك الانتصارين العجبيين أسبابٌ روحية.
العصر الذهبي: بريكليس وسقراط
يقول الفيلسوفُ الألماني هيغل: "لم يحدث قط في التاريخ أن تجلى تفوق القوة الروحية على الضخامة المادية – وهي ضخامة لا يستهان بها – مثلما تجلى في هذه الحرب ]اليونانية الفارسية[ التي أصبحت لما استتبعت من نمو في المدن المشاركة فيها أسطع حقبة في تاريخ اليونان (ص 258).
إن القوة الروحية التي أشار إليها هيغل منبعها السيالات الروحية (أي القوى الإداركية التروعية الإرادية) التي ستبدأ تباشيرها بالإطلاع بتولي بريكليس Pericles الحكم (463 – 430 ق.م.). فأثينا عرفت فيه أعظم حاكم في تاريخها، وبلغت في عهده أوج عظمتها ومجدها وحضارتها، غذ اجتمع فيها إلى جانب سقراط الحكيم العظيم، أبي الفلسفة الخلقية، أعظم أدباء اليونان، كإسخيلوس Aeschylus وسوفوكليس Sophocles ويورييديس Euripide وغيرهم وأكبر فنانيها كفيدياس Phidiasو زكيس Zeuxis وكثيرون آخرون من العباقرة. فالرحمة الإلهيةى صانت اليونان إلى أجل معين من أجل هؤلاء لأنهم سيكونون القاعدة الروحية (الخلقية والفكرية والأدبية والفنية) التي ستُبنى عليها حضارةُ أوروبا فيما بعد، والتي ستمد التعاليم الموحاة المقبلة على العالم، من خلال المسيحية والإسلام، بمبادئ عقلانية وجمالية.
أحاط بريكليس بثقافة عصره من جوانبها جميعًا، الفنية والأدبية والفلسفية والاقتصادية والعسكرية حتى رآه المؤرخون ذروة ما أنجبته اليونان من حكام. وكان بليغًا في خطاباته، رزينًا، رابط الجأش، عظيم التأثير في العقول المستنيرة. ولم يكن نفوذه مستمدًا من ذكائه فحسب، بل من استقامته ونزاهته مستمدًا من ذكائه فحسب، بل من استقامته ونزاهته أيضًا. وقد أدخل الديمقراطية على أثينا، وعمل على ازدهار العُمران والحياة الاقتصادية وتعميم الرخاء؛ ومع ذلك لم يزد شيئًا على ما ورثه عن أبيه طوال حياته. ومن أهم منجزاته أنه صان حرية الكلام حتى على نقد شخصه وزوجته، وحمى الفنانين والأدباء والفلسفة، وسعى إلى رفع مستوى الشعب الثقافي بدفعه مكافآتٍ لكل مواطن يحضرُ المسرحيات والألعاب في الأعياد العامة. (ص 245 – 254).
من الامتحان إلى المحنة
حكم بريكليس أثينا حكمًا عادلاً فاضلاً أحبه الشعب عليه وحمده. لكنه بعد 13 عامًا من بداية حكمه (حوالى 450 ق.م.)، تعرف إلى امرأة جميلة من أصل ميليزي Milesian تُدعى أسبازيا Aspasia. فاجتذبه جمالها مثلما اجتذبته حركتها النسائية التحررية التي أنشأتها ودعت فيها إلى حرية الزواج خارج نطاق الشرعية، وإلى حقوق المرأة في حرية التحرك والسولك والثقافة والاختلاط بالرجال. وقد فتحت مدرسة للخطابة والفلسفة كان يحضرُ دروسها كثيراتٌ من فتيات الأسر المعروفة، بل إن كثيرين من الأزواج كانوا يصطحبون زوجاتهم للاستماع إليها. وقد حضر دروسها رجالٌ كثيرون بينهم بريكليس وسُقراط نفسُه الذي كان ما يزالُ في أوائل العشرينيات من عمره. ويقولُ المؤرخون إن بريكليس تولع بها حتى تزوجها زواجًا غير شرعي، لأن القانونن اليوناني الذي سنه هو نفسُه عام 451 (ق.م.) يمنعُ الرجل الأثيني من أن يقترن بامرأةٍ غير أثينية اقترانًا شرعيًا. بل إنه أصى بثروته للولد الذي ولدته له، بالرغم من وجود أولادٍ شرعيين لديه. وقد نشأت بينه وبين زوجته الشرعية خلافاتٌ حادة أدت إلى طلاقها. وقد جعلت أسبازيا من منزله، وهو منزلُ الحاكم، صالونًا يتلاقى فيه الفنانون والأدباءُ والفلاسفة ورجالُ الدولة، حتى قيل فيها إنها أصبحت ملكة أثينا غير المتوجه. ذلك كان كافيًا لتنطلق ضد بيركليس ألسنةُ السوء من المحافظين ومدعي التقوى الدينية، وليتهموا أسبازيا باحتقار آلهةِ اليونان. فأحيلت على محكمة اختير لها 1500 محلف Jurors. واتخذ بيركليس موقف محامي الدفاع، فدافع عنها ببلاغو ودموع حتى أبطلت الدعوى. لكن منذ هذه اللحظة (432 ق.م.) بدأ بيركليس يفقد سطوته على الشعب الأثيني (ص252 – 254).
هل استطاع بريكليس تغيير خلقية الأغارقة؟ بالرغم من ازدهار الحياة اليونانية، وخصوصًا في أثينا، في المجالات الاقتصادية والفكرية والفنية طوال 60 سنة (بدءًا من الحروب اليونانية – الفارسية عام 492 ق.م. حتى آخر حكم بريكليس)، فإن خلقية الأغارقةى لم تستطع أن تنهد إلى المثل العليا المتطلعة إلى اللانهائي والمتفلتة من العنصر الطبيعي، العنصر الكامن في المحسوس من الجمال والتمثل الإلهي. ذلك فضلاً عن أن تلك الخلقية تمحورت حول الذاتية الضيقة التي شكلت بذرة الانهيار اليوناني. وقد تجلى الإنحلالُ السياسي أولاً، في التنافس على السيادة بين المدن اليونانية، وكذلك في تنازع الفضائل في المدن نفسها. فخلقية الذاتية الضيقة جعلت بلاد الإغريق غير جديرة بتكوين دولة واحدة من مدنها المتنافسة. أما تجربة حرب طروادة التي اجتمعت فيها مدن اليونان فكانت عابرة. يؤكد ذلك أن محاربة الفرس الضارية للأغارقة لم تستطع أن توحد جميع المدن اليونانية؛ فالأواصر بينها كانت واهنة، لأن التحاسد كان ينهشها، والتنافس من أجل السيادة كان يعكر صفوها (ص 261 – 266).
أما أثينا تنعم بالحرية والديمقراطية في عهد بريكليس، لكنها كانت تطمع بالسيطرة على المدن والشعوب الأخرى. فثراؤها الفاحش بلا المدن الأخرى بالحسد، ونزعتها الإمبريالية للسيطرة على التجارة دفعت سائر المدن لبغض شعبها. وحب بريكليس لأثينا وتفوقها حفزه إلى المغامرة من أجلها. فكان يعمل للسلام مع المدن الأخرى. وفي الوقت نفسه يتأهبُ للحرب التي رأى أنها لا بد واقعة. عرض على إسبرطة الحوار، لكنها رفضته مع أكثر حلفائها. ثم تعاقبت الأحداثُ بين أثينا وسائر المدن اليونانية التي حالفت إسبرطة، إلا واحدة هي أرجوس Argos. فطلبت إسبرطة من أثينا تخليها عن سيادتها الإمبريالية ومنحها جميع المدن التي تحت سيطرتها الاستقلال. لكن بريكليس أقنع الأثينيين برفض طلب غسبرطة اغلتي ما لبثت أن أعلنت الحرب. فما كان من بريكليس إلا أن منع جنوده من التوجه إلى القتال، وأمرهم أن يبقوا مع الشعب كله داخل أسوار أثينا. ويبدو أن محنة أثينا أطلقها سبب روحي اتخذى مجرى طبيعيًا، إذ سرعان ما تفشى وباءٌ استمر زهاءَ ثلاث سنوات، بدءًا من عام 430 ق. م فقضى على ربع الجنود الأثينيين وكذلك على أعدادٍ كثيرة من السكان. فأنهم الشعب بريكليس الذي أحبه كثيراً بأنه سببُ الحرب والوباء، ووضع المسؤولية على عاتقه، فأقاله المشرعون من الحكم. وبعد سنة واحدة (429ق. م.) قضت شقيقته وأبناه الشرعيان بالوباء. وعندما رأى الأثينيون أن لا حاكم لديهم بإمكانه أن يحل محل بريكليس، استصرخوه أن يعود إلى اللحكم لائمين أنفسهم. لكنه مات بالوباء نفسه بعد عدة أشهر؛ وبموته مهد الطريق لانحدار حضارة أثينا ومدُنِ اليونان جميعها، لأن خلفاءه من الحكام كانوا منحرفين فاسدين، لا هم لهم إلا جمع الثروات الفاحشة. ولعل أبرزهم وأضرهم كان ألسيبيادس Alcibiades. فقد نشأ في أسرة ثرية بارزة، إذ كان والده قائدًا لجيش أثينا، والقيم عليه بيركليس، ومعلمه في المرحلة الأولى سقراط العظيم. لكنه كان شابًا محبًا للإسراف، مزدهيًا بنفسه، متلونًا، سيالاته الروحية المتدنية المستوى تغلبت على ثقافته. ولما بلغ الثلاثين من عمره تخلى عن النزاهة التي كان سقراط ينصحه بالتزامها، ليخوض غمار السياسة المتقلبة المتناقضة المواقف. وكان لهذا التلون اثرٌ سلبي في تسعير الحرب بين أثينا وإسبرطة التي لم ترتدع حتى عن الاستعانة بفارس لضرب أثينا والمدن التابعة لها. لكن ألسيبيادس جوزي على فساده. فإسبرطة، التي صادقها ثم انقلب عليها والتجأ إلى ملك فارس، استطاغعت أن تقنع الملك بقلته. وبعد ذلك خربت الديمقراطية في أثينا، وتسلمت فارس السلطة على المدن اليونانية في آسيا الصغرى (ص 266 – 267).
النذيرُ الهادي والسقوط
عام 424 (ق.م) وقعت معركة ديليوم Deluim بين أثينا من جهة وإسبرطة وطيبة من جهة أخرى. كان سقراط في الخامسة والأربعين من عمره، وقد بدأ ينثرُ أفكاره الفلسفية الخلقية، لكنه لم يكن بعد قد نشط في دعوته الإنسانية، ولا انتظمت تعاليمه. وبصفته يونانيًا بين الثامنة عشرة والستين من العمر، كان ملزمًا بالاشتراك في القتال. كان سقراط في فرقة حملة السلاح الثقيل. وقد قتل من رفاقه أكثر من ألف جندي، أي بنسبة 15% منهم؛ بكلمة أخرى، كانت الموقعة كارثة على أثينا. لكن سقراط فضل أن يفر من المعركة عائدًا إلى أثينا. تُرى، هل كان يخافُ الموت؟ إن رفاقه الذين نجوا يروون أنه كان شجاعًا. ونهايته المعروفة تظهر نه كان جريئًا في الموت كما في الحياة! بل إنها دفعت الباحثين فيها، وخصوصًا جماعة الأفلاطونية الحديثة، إلى جعله سابقصا للمسيح. إذًا ما الذي جعلن يفر من القتال؟ لا شك بأن قوة روحية خفية دفعته إلى أن ينجو بنفسه، قوةً كان يسمعُ صوتها في نفسه، لأن حياته ستكون ذات تأثيرٍ إيجابي لكثيرين، ولأنه يحمل دعوةً روحية، خُلقية فلسفية عليه أن يتممها. فلو قُتل سقراط في تلك المعركة لما كانت حواراته ولما كان أفلاطون وأرسطو مثلما نعرفهما، ولما كانت الحضارةُ الغربية بأعمق وأجمل ما فيها من فكر وخلقيات. إذًا لا صُدفة في مجرى الحياة. وأحداث البشر العامة والخاصة ذاتُ أسباب روحية مبنية على الاستحقاق الروحي وعلى نظامٍ إلهي مهيمنس على الأرض ليس فيه ظلم مقدار ذرة، بل رحمةً وهدايةٌ يعقبهما ثوابٌ أو عقاب.
يقول هيجل: "سقراط مشهور بأنه معلم النظام الخلقي، لكن بالأحرى أن نسميه مبتكر النظام الخلقي. فالأغارقة كان لهم نظام خلقي مبني على الأعراق؛ لكن سقراط اضطلع بتعليمهم ماهية الفضائل والواجبات الخلقية... فالإنسانُ الفاضل ليس من يريدُ ويعمل ما هو حق، ليس الإنسان النقي السريرة فحسب، بل هو من يمتلكُ وعي ما يفعله" (ص269). لم يكن سقراط نبيًا، لكن بعضصا من سيالات الأنبياء الروحية كان يحييه، وفقًا للتعاليم الداهشية. ولذا كان واعيًا دعوته،, مؤمنًا بها؛ وقد قامت رسالته على محاورته الناس ليوقظ فيهم ما هجع من الخير والحق وليعلمهم التمييز بين الصواب والخطأ. وكان منطلقه وشعاره في الحوار: "أعرف ذاتك". ذلك بأن معرفة النفس بابٌ لكل معرفة إنسانية؛ وهي طريق لتعرف كُنه النفس ومصدرها ومصيرها ولإيضاح قواها واستعداداتها ودوافعها ونزعاتها، وجلاء مناهجها السلوكية، وما يجب أن تمتنع عنه، مثلما هي سبيل إلى فهم القوانين المنطقية للتفكير السليم. واعتبر سقراط أن المعرفة الصحيحة التي هي وليدةُ الحق لا تقوم إلا مقترنةً بالفضيلة التي هي وليدةُ الخير؛ ولذا فالإنسان السليم لا ييبنيه إلا اتحاد الفكر الحق فيه بالعمل الخير. وقد آمن سقراط بوجود قوة إلهية مدبرة ترعى البشر، وبنظام ثابت يهيمنُ على الكون، وبوجود حقيقة ثابتة وعالم روحي، وبخلود النفس والثواب والعقاب والتقمص.
وكان سقراط مثالاً خلفيًا أعلى لكل من سعى إلى الفضيلة بعده. كان متحمسًا بنفسه، ضابطًا لترعاته، متقشفًا، ولا سيما في سنواته الأخيرة. ومع ذلك لم يكن يدعي الصلاح التام والتباهي، ولا كان يقسو على مواطنيه بالرغم من معرفته سوء أخلاقهم وسلوكهم، لأنه كان مؤمنًا بأن ارتقاء مواطنيه خلقيًا – وليس ارتقاءه فحسب – هو رسالةٌ ائتمنه الله عليها؛ وهذه الرسالة يجبُ أن يؤديها بوجه لا يعرف العبوس مهما حدث له. لكن تعاليم سقراط السامية مقرونة بخلقيته الصارمة أثارت السيالات الروحية السفلية التي كانت تحتل معظم أعضاء مجلس الشعب، فأصدروا حكمهم عليه بالموت عام 399 (ق.م.) بتجريعه سم الشوكران. وهذه الإدانة التي تمت بموافقة 280 عضوًا ضد 220، على الأرجح، كانت، في نظرهم، بسبب "تعديه على شرائع البلاد، وعدم إيمانه بآلهتها، وتبشيره بمعتقد جديد، وإفساده الناشئة". وقد أمضى شهرصا كاملاً في السجن حيث كان يستقبل أصدقاءه، ودبرت خطة لفراره، لكنه رفض ذلك وىثر أن يشرب السم. كذلك سنحت له فرصة في أثناء المحاكمة لتخفيف الحكم عليه شرط أن يتنازل عن رسالته؛ لكنه رفض التراجع معتبرصا نكوصه عارًا. بل إنه خاطب ممثلي أثينا بقوله في أثناء محاكمته: "أتنبأ لكم، أنتم يا من تحكمون عليَّ: عقابٌ وسيكٌ سينزلُ بكم بعد موتي، وسيكونُ أصرمَ جدًا من عقابي" أما الكلمة الأخيرة التي تفوه بها قبل موته فكانت: "إني مؤسس الداهشية يشبه مضطهديه بمضطهدي سقراط، وقد أشار إلى ذلك في رسالةٍ منه إلى الدكتور حسين هيكل باشا.
وقد تحققت نبوءه سقراط بخراب اليونان مثلما تحققت بعدها نبوءه المسيح بخراب أورشليم؛ ونبوءةُ الدكتور داهش بخراب لبنان بدءًا من 1975، تلك النبوءة التي نشرت في جريدة الحياة البيروتيو بتاريخ 4/1/1948، ولم يصدقها أحد إلا تلاميذه!
وقد بطش الشعبُ الأثيني ببعض متهمي سقراط، والآخرون شنقوا أنفسهم أو عزلوا حياتهم.
أما الثورة الفكرية الخلقية التي أطلقها سقراط فقدكان معينًا أن تستفيد منها شعوب أخرى. أولاً، عبر أفلاطون، تلميذ سقراط، بشرحه أفكار معلمة في حواراته. قال برتراند راسل: "على كثرة الفلسفة، قليلون الذين استطاعوا أن يجاروا أفلاطون، ولكن ليس من أحدٍ حاكاه في عُمقه، ولا أحدٌ تخطاه".
ونافلٌ القول إن من تلاميذ أفلاطون أرسطو الذي شق لنفسه نهجًا فلسفيًا خاصًا، لكن أسس فلسفته مدينٌ بها لمعلمه. ومن اندياحات الموجة الأفلاطونية تولدت الأفلاطونية الحديثة التي أسسها أفلوطين (نحو 203 – 270 ب.م.)؛ وقد امتدت تأثيراتها ألف سنةٍ ونيفًا. كذلك امتد تأثيرُ أفلاطون، في سياق التاريخ، إلى كثيرين من المفكرين الكبار؛ منهم أوريجينس، وأوغسطينس، وتوماس مور، وكبلر، وغاليليو، ولايبنتز وغيرهم كثيرون.
ثانيًا: إن أفكار سقراط وأفلاطون انتقلت إلى شعوبس كثيرةٍ أخرى بواسطة شاب عبقري التمع فيه شيء من وهج الهداية الروحية. إنه تلميذ أرسطو، الإسكندر الكبير (356 – 323 ق.م.)، الذي تسلم الحكم وهو في عمر العشرين، بعد مقتل أبيه فيليب المقدوني على يد أحد ضباطه؛ فتخلص الإسكندر سريعًا من مناوئيه داخل مقونيا، وزحف بجيشه على المجدن اليونانية مدفوعًا بإيمانه العظيم برسالته الحضارية، ففرض سلطانه عليها جميعًا إلا إسبرط’، وألغى الحكم الدكتاتوري في بلاد اليونان، وأمر بأن تعيش كل مدينة وفق قوانينها الخاصة. وما لبث أن قام بفتوحٍ عظيمة في الشربق ناشرًا الحضارة اليونانية الأثينية حيثما حط بالإسكندرية، وفارس، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ولما كانت فارس أعظم الدول قوة، عهدئذٍ، ولمس الإسكندر أن أشراف الفرس ذووو خلقٍ حسن ملحوظ لم يجتذب نظره في الديمقراطيات اليونانية، قرر مزج الدم اليوناني بالدم الفارسي، فأمر بأن يقام عُرسٌ عظيم في السوس (سنة 324 ق/.م.)، تزوج فيه الإسكندر ابنة داريوس الثالث، ملك الفرس الذي كان قد قتله قائد فارسي من جنوده، بعد فراره من وجه الإسكندر؛ وكذلك تزوج ثمانون من ضباطه، بناءً على رغبته، بنساء فارسيات، ثم اقتدى بهم ألوفٌ من جنوده. وقد وهبَ الإسكندر ضباطه الذين تزوجوا بائناتٍ كبيرة. ودفع الديون عن جميع جنوده البذين حذوا حذوهم. ورغبة أن يقيم الإسكندر دينًا مشتركًا تؤمن به شعوب إمبراطوريته المختلفة المعتقدات، أعلن أنه ينحدر من أبٍ إلهي هو زوس – أمون، أي الله بتسميته اليونانية – الفارسية. فاستمالت هذه الدعوة كثيرين وأغاظت كثيرين؛ فتكاثرت المؤامرات عليه لقتله. وبعد آلامٍ وهمومس شديدة، لازمته حمى مرتفعة قضت عليه بعد عشرة أيام وهو في بابل، وعمره ثلاثة وثلاثون سنة. ويموته انطفأت مشاعل الهداية الروحية ثلاثة قرون لتتوهج في يسوع الناصري. عام 146 (ق.م.) أصبحت اليونان ولايةً رومانية. وبعدئذٍ اجتاحها البرابرة ثم شعوب أخرى. والحضارة العظيمة التي شهدتها عهد سقراط وبراكليس لم تشهدها من بعد إطلاقًا.
(في العدد المقبل: السببية الروحية ونشأة المسيحية)
السببية الروحية في مجرى الأحداث العامة (6)
وفق المفاهيم الداهشية: نشأةُ المسيحية ومرحلتها الأولى
بقلم الدكتور غازي براكُس
لعل القارئ تنبه، في معالجتي لموضوع السببية الروحية في مجرى الأحداث العامة، إلى تأكيدي المتكرر أن وراء الأحداث الجماعية وكذلك الفردية – نظامًا روحيًا عادلًا وثابتًا يُهيمنُ على الأرض ِ وعلى الكونِ كله معلومه ومجهوله، وأن من قواعد هذا النظام ظهورَ أنبياء أو هذه روحيين، منذرين ومبشرين؛ فيخاطب كل منهم قومه أولاً، ثم العالم، من خلال الحقائق والإرشادات الموحاة أو الملهمة التي يتركها، مؤكدًا أن خير الفرد والجماعات الأسمى رهنٌ بمدى ممارستهم وتجسيدهم لتلك الحقائق والإرشادات، وبالتالي مدى استقامة العلاقات الروحية التي يقيموها بينهم وبين ذلك النظزام الروحي يدفعنم إلى ارتكاب مختلف الرذائل والشرور، وبالتالي إلى جر شعوبهم إلى النكبات والويل والثبور.
يقول الدكتور هيوستن سميث Huston Smith، المرجعُ الكبيرُ في تاريخ الأديان وأستاذُ الدراسات المقارنة فيها في جامعات واشنطن و MIT وسيراكيوز وبركلي بكاليفورنيا: "العلمُ الحديثُ ما يزال يشكك في وجود كياناتٍ غير منظورة؛ لكن التشكيك العلمي بدأ يتراجعُ مع ملاحظة إدنغتن Eddington أن العالم هو شبيهٌ بعقلٍ أكثر منه بآلة، ومع تقارير عُلماء الفيزياء الفلكية القائلة بأن مقدار 90 بالمئة من المادة في الكون هو غير منظور، بمعنى أنه لا يؤثر في أي من أجهزتهم".
والعقل الإلهي المدبر هو الذي يهيمن على النظام الروحي الكوني، ويؤثر في المخلوقات ومصايرها وفق عدالة كاملة وسببية روحية شاملة. وهذا التاثير يطال الموجودات جميعها معروفها ومجهولها من خلال جوهرها الروحي الكائن في كل سيال؛ علمًا بأن التعاليم الداهشية الموحاة أوضحت أن نسيج الكون كله هو من السيالات. وهيهات أن تكون قوة "المادة" مهما عظمت كقوة الطاقة الروحية المجردة التي بدأ يفترضُ بعضُ العلماء أنها مُنبثةٌ في الكون كله. يقولُ الفيزيائي البوذي ألن والاس Allan Wallace إنه لو أتيحَ للعلم أن يقيسَ تلك القوة غير المادية في فضاءٍ مجرد من المادة لظهر له أن أي حجمٍ منها، مهما يكن صغيرًا، لأعظمُ قوةً من مجموع الطاقة التي تختزنُها المادة في الكون كله، لأنها قوة لا نهائية.(2)
حياةُ السيد المسيح واضطهادُه والأسبابُ الروحية وراءهما
بهذه القوة الروحية الخارقة التي تبعث على الخشوع والذهول كان يسوع الناصري مزودًا من قبل المهيمن على نظام الكون. فشفى بقوة الروح الأمراض المستعصية، وسيطر على الطبيعة، ومشى على المياه، وكشف الغيب... فكانت معجزاته ونبوءاته تصديقًا للمصدر الإلهي الذي استقى منه تعاليمه المبنية على المحبة والرحمة والفضيلة وسائل القيم الروحية. ولا حاجة للإفاضة بعرض تعاليم السيد المسيح في هذا المجال؛ فذلك سيعالج في الكلام على وحدة الأديان الجوهرية وفق المفاهيم الداهشية. لكن تجدرُ الإشارة إلى أن أهم وجه في تعاليمه السامية كان أنه عاشها حياةً سامية، فكان تجسدًا للمحبة اللانهائية وعطاء الذات حتى الفداء، مثلما كان تجسدًا للتواضع والفضيلة بكل مجالاتها. لكن الشعب وحكامه، من اليهود والرومان، لم يستفيدوا شيئصا منه بصورة عامة. فتآمروا عليه رجال دينٍ ودنيا، وقبضوا عليه وعذبوه وصلبوه وفق ما دونه الإنجيليون. لكن ما الأسبابُ الروحية لكل ذلك؟
عدة أنبياء من العهد القديم تنبأوا بمجيء السيد المسيح بعد عودة اليهود من سبى بابل. يكفي أن أشير إىل نبوءة النبي ميخا التي يقولُ فيها: "يا أورشليم، جيوشُ الأعداء تضيقُ عليك الحصار، وتضرب حاكم بني إسرائيل على خده بالقضيب. أما أنت، يا بيت لحم أفراته، وإن كنت صغرى مُدن يهوذا، فمنك يخرج لي سيد على إسرائيل يكون منذ القديم، منذ أيام الأزل... يقف ويرعى شعبه بعزة الرب إلهه وبجاه اسم الرب، لأن عظمته ستمتد إلى أقاصي الأرض، ويعمها سلامه" (ميخا 1:5 – 5).
ووفق إنجيل متى عرف هيرودس الكبير من "مجوس" وفدوا إلى أورشليم بأن المسيح، سيد إسراغئيل الآتي، سيولد في بيت لحم، وأنه قد ولد فعلاً. وسرعان ما اضطرب هيرودُس وخاف على عرشه. وإذ تأكد له من أحبار اليهود أن ولادته ستتم في بيت لحم، أمر بقتلِ جميع الأطفال فيها من عُمر سنتين فما دون. وسرعان ما أوحي إلى يوسف في الحلم أن يأخذ الطفل ويترح إلى مصر ريثما يموتُ هيرودُس. وهكذا كان. لكن ما الأسبابُ الروحية وراءَ ذلك؟
إن السيد المسيح كان يجب أن يولد في ذلك الزمن (عام 5 ق.م.) ليجدد معاناة الآلام التي بدأها في افتدائه آدم وذريته، ومَن سيختارهم من التابعين له بسيالاتهم الروحية. وكان في الخطة الإلهية، أولاً، أن يولد في بيت لحم لتحقيق النبوءة لكن يوسف ومريم كانا من سكان الناصرة. فإذا بالقيصر أوغسطس يأمرُ بإحصاء سكان الإمبراطورية. فاضطر كل واحد إلى الذهاب إلى مدينته ليكتتبَ فيها. فصعد يوسف من الجليل حيث مدينةُ الناصرة إلى بيتَ لحمَ، مدينة داوود، في اليهودية، لأنه كان من بيت داوود وعشيرته. وبينما هما في بيتَ لحم فاجأ مريم المخاض. فهذا الترتيبُ العجيبث المعقد ليس ترتيبًا بشريًا. ثانيًا، أن تتم ولادته في عهد هيرودس الكبير، لأن فيه سيالاً من الفرعون الذي أمر بقتل أطفال العبرانيين الذين أُنقذ موسى النبي من بينهم وهو طفل، ويسوع فيه سيالٌ روحي من النبي موسى، وذلك من أجل أن يعاقب الملكُ، كما سنرى، عقابصا رهيبًا، فتتم العدالةُ الروحية. ثالثًا أن يولد في عهد الإمبراطور أوغسطس Augustus، لأن العالم المنتشر على حوض البحر المتوسط كان كله موحدًا في ظل الحكم الروماني. وهذه النقطة الأخيرة أدركها أوريجينس Origen (185 – 254م)، أكبر لاهوتي مسيحي بعد بولس الرسول، إذ كان موقنًا أن ولادة يسوع الناصري في ذلك العهد كان من ضمن الخطة الإلهية، لأن الظروف المؤاتية للإرساليات التبشيرية كانت عظيمة؛ فالناسُ كانوا أحرارًا في التنقل من بلد إلى آخر، لأن العالم الروماني الموحد أزال الحواجز بين الدول، والأفكار الفلسفية اليونانية الالمثالية، الأفلاطونية والفيثاغورية، كانت منتشرة، وسيزدادُ انتشارها في القرون الثلاثة التالية. أما المجوس الذين تدخلوا في نشر خبر ولادة "ملك اليهود"، فلم يكونوا "علماء فلك" أو "ملوكًا" مثلما يذهبُ المفسرون المسيحيون، بل كانوا تجسدات لكائنات فردوسية، أُمروا بأن يتجسدوا على الأرض للإسهام في تنفيذ عملية الفداء العظمى التي يقومُ بها السيد المسيحج. وهذا السر الذي كان يجبُ أن يبقى مكتومًا في ذلك الزمن كشف عنه الوحي الداهشي.
لكن ما هي الأسبابُ البشرية التي استدعت الأسبابَ الروحية ونتائجها مثلما سنرى؟
كان الشعبُ اليهوديُّ، زمان المسيح، قد مضى عليه حوالى مئة سنة وهو تحت الحكم الروماني مسلوبَ الحرية، يدفع الضرائبَ الباهظة. فسياسيًا كان العقدُ والربطُ بيد الوالي الروماني، وملوكُ اليهود كانوا واجهةً دينية يدعمُها رجالُ الدين.
أما فئات الشعب اليهودي فأهمها خمس: أولاً، الفريسيون Pharisees الذين التزموا تطبيق الشريعة الموسوية المكتوبة والشفهية بحرفيتها ودقائقها وتأويلاتها، وأرادوا تجديد الحياة اليهودية من خلال إلزام طائفتهم ممارسة الطقوس الدقيقة في الصلاة داخل المجامع وفي الاغتسال وتحديد أنواع الأطعمة والعلاقات مع الآخرين، مما سيشكل تكوين "التلمود"؛ وبما أن معظم الكتبة (وهم علماء متفقهون في الشريعة وكثيرون منهم أحبار) كانوا من الفريسيين، فقد تمتع هؤلاء بالنفوذ الأقوى. ثانيًا الصدوقيون Sadducees الذين كانوا الأكثر تكيفًا مع الحكم الروماني والثقافة اليونانية؛ فهم يتمسكون بالتوارة، لكنهم يرفضون تقاليد الكتبة وروايات الفريسيين وشروحهم الشفهية، وينكرون قيامة الموتى والدار الآخرة (مرقس 12:18؛ أعمال الرسُل 23:8) ثالثاً، الأسينيون Essenes الذين كانوا يائسين من تجديد الدين اليهودي لنفسه ما لم يتدخل يهوه (الله)، لكنهم كانوا يتمسكون بالشريعة المكتوبة وغير المكتوبة، ويحرصون على التقشف والزهد، ويعتزلون الحياة العامة لعيشوا في متحداتٍ خاصة عيشةً اشتراكية في مآكلهم ومجمعاتهم السكنية منتظرين مجيء المسيح المخلص. رابعًا، السامريون الذين يرقى أصلهم إلى الانشقاق الذي حدث بين مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا الجنوبية؛ فهم لا يقرون إلا بالتوارة (أي الأسفار الخمسة الأولى) مع تغييرات في نصوصها، ويتخذون جبل جريزيم القائم في قلب السامرة مكانًا مقدسصا لعبادتهم؛ وسائرُ اليهود يُبدون لهم عداوةً دينية وقومية، إذ يعتبرونهم هراطقة، لا سيما أنهم لا يمانعون في التزاوج بينهم وبين الوثنيين الذين كانوا يسكنون جميع مدُن فلسطين الساحلية إلا يافا. خامسصا، الأحزابُ اليهودية التي طغت السياسةُ فيها على الصبغة الدينية، فجعلت هدفها الأول التحرر من الحكم الروماني بالمقاومة المسلحة. وقد برز بينهم "الغيورون" Zealots و"السفاحون" Daggermen، وبرز من زعمائهم ألعازر بن شمعون، وسيمون بن غوريا، ويوحنا بن لاوي.
إن السبي والتشرد والمصائب والآلام التي عاناها اليهود طوال عصور كثيرة، ورزوح شعبهم تحت نير الدول الأجنبية – كل ذلك جعلهم يعلقون آمال خلاصهم بمنقذ تتم فيه نبوءاتُ أنبيائهم الكثيرين، فيكون هو المسيح المخلص. لكن سيالاتهم المتشبثة بالقيم المادية والمفعمة بترعات الطمع والسيطرة والشهوات الدنيوية، تلك النزعات نفسها التي ندد بها أنبياؤهم وكانت سبب نكباتهم المتكررة التي تحدثت عنها سابقًا، صورت لهم أن "مسيحهم" يجب أن يولد من بيت داوود الملكي ملكًا، أو ينزل من السماء آتيًا على السحاب (تأويلاً حرفيًا للتوارة) ليُحرر اليهود من سلطة الرومان، ويؤمن لهم القوة والرخاء المادي. وبكلمة أخرى، تصوروا أن ملك المسيح يجب أن يكون سياسيًا، وقوته عسكرية، وشريعته شريعة أخبار اليهود وكتبتهم، لأنهم "مقدسون".
تجاه تلك الفئات الخمس وقف يسوع الناصريُّ وقفةً مغايرة لهم جميعًا. فهو يريد التغيير، ويبشرُ ببعث الموتى وجزائهم حسب أعمالهم ونزعاتهم علىت نقيضٍ من الصدوقيين. ويرغب في البقاء قريبًا من الناس واهتماماتهم، من أجل إصلاحهم، على نقيض الأسينيين. ويُلحُ على المحبةت الشاملة والمقاومة السلمية بمحبة الأعداء لا بمقاومتهم المسلحة، على نقيض الجماعات التي التزمت المقاومة العنيفة الدموية. أما الفريسيون فخالفهم في أنه شدد على المحبة والشفقة ونقاء النفس لا نقاء الجسد والطعام. وكذلك على المساواة بين الناس يهودا وغير يهود، فريسيين وسامريين، أحرارًا وعبيدًا، أغنياء وفقراء؛_ فكان يؤاكلُ ويحادث الخطأة والمهمشين وجامعي الضرائب للرومان؛ وكان يناقضُ شريعتهم التي تحرمُ العمل عليهم يوم السبت، حتى لإنقاذ إنسان، فكان يشفى المرضى في هذا اليوم وكذلك كان يتكلم بسلطة مؤولاً الأسفار المقدسة تأويلاً جديدًا، مخالفصا لتأويل الكتبة. وأخطر ما في حياته وتعاغليمه وخوارقه كان أنها ناقضت جميع ما اعتاده الشعبُ اليهوديُّ بكل فئاته، ولا سيما الطائفة الأقوى فيه التي جعلت رؤساء الكهنة امتدادًا للعائلات اليهودية الأرستقراطية يُساندُ بعضها بعضصا. حتى إنهم، يوم حاكمه بيلاطس، وخيرهم في من يطلقُ لهم يسوع أم برأبا، رئيس إحدى عصابات المقاومة المسلحة، فضلوا عليه برأبا.
ذلك كان موقفه من مختلف فئات الشعب اليهودي. أما موقفه من الدولة الرومانية الحاكمة فكان موقف المؤنب على الظلم، المقاوم مقاومةً سليمة. فمؤسسُ الداهشية كشف، في كتباه الموحى، "مذكرات يسوع الناصري"، الذي يروي فيه أحداثًا جرت في طفولة يسوع بين الثانية عشرة والخامسة عشرة، أن معجزته الأولى تمت في كفرناحوم، إذ إن قائد الشرطة، بعد أن استجوب يسوع وأنذره لأنه يثيرُ الاضطرابات الفكرية بين الأحداث، الأمرُ الذي استنكره أهاليهم، سأله (لما عرف أن والديه في الناصرة): "وكيف؟ هل أنت متمرد عليهما؟" فأجاب يسوع: "أنا لا أتمرد إلا على الظالمين أمثالك." فرد القائد: "يا شقي، اصمت". فكان جواب يسوع: "أنت الشقي. أما أنا فإنني أضرعُ إلى أبي أن يجرد عليك سيف حقيقته البتار ، لترى من منا سيصمت". وهوى قائد الشرطة ميتًا. وكان لهذا الحدث الخارق ضجة ومهابة!
ومؤرخو نشأة المسيحية يثرون أن الدولة الرومانية كانت تراقب أعمال المسيح وكلامه وتنقلاته والحشود التي تجتمع حولهخ، ولم يكونوا ليميزوا تمييزًا قاطعًا بين حركته والحركات العنيفة المقاومة لهم، خصوصصا أن رؤساء الكهنة والأرستقراطيين من اليهود كانوا حلفاءهم. ولعل أعنف موقفٍ وقفه من رؤساء الكهنة المحالفين للرومان كان يوم دخل أورشليم دخول الفاتح، وولج الهيكل مع الجموع وطرد بسوطه الباعة والصيارفة من ساحته، وشفى المرضى. فاغتنم رؤساءُ الكهنة والحراسُ اليهود من الفريسيين هذهن الفرصة ليدعوا أنها كانت محاولةً من يسوع للسيطرة على مجمع الهيكل الضخم (أكثر من 200 يارد عرضصا و450 طولاً) الذي يضم 20 ألف موظف يعملون في مختلف الإدارات، فضلاً عن اشتماله على المصرف المركزي الحاوي كمية ضخمةً من النقود والأحجار الكريمة والودائع. ولذلك رافقت الجموعُ يسوع إلى بيلاطس مدفوعةً من رؤساء الكنهة والأرستقراطية اليهودية، وأخذوا يتهمونه قائلين: "وجدنا هذا الرجل يثير الفتنة في شعبنا، ويمنعه أن يدفع الجزية إلى قيصر، ويدعى أنه المسيح الملك" (لوقا 23:2 – 5). كل هذا يؤيد ما قاله مؤسس الداهشية أن السيد المسيح "أطلق ثورةً نبيلة كي يحطم بواسطتها كبول الظلم والإرهاق، ويقطع أغلال الرق والعبودية..." وأنه "ثلاثة وثلاثين عامًا جاهد جهاد المستميت، داعيًا الجميع للانتفاض على دستور القوة والبطش، دون أن يسير في ركابه أحد، خوفًا من الدولة الرومانية القوية الشكمية... ما خلا نفرًا من البُسطاء الذين فتنتهم تعاليمنه العلوية، وأضاءت قلوبهم بأنوار المعرفة الإلهية. لم ييأس... ولم يتراجع... بل راح يهاجم قيصر روما في شخص هيرودس، طاغية فلسطين... وفي النهاية، عظمت التضحية وضخم العداء. فقد بذلك الثائر حياته فداء لحرية البشرية المعذبة؛ هذه البشرية المتألمة التي أعمت الشهواتُ والترواتُ بصرها وبصيرتها، فقدمته ضحية على مذبح جهلها الصارخ، إذ كافأته على جهوده في سبيل تحريرها وحبه إياها بتعليقها إياه على خشبة الصليب!".
لكن ما دام السيد المسيح كان يعلم من سيسلمه إلى السلطات، فلماذا سكت عنه؟ وهل حقيقة أنه صُلِبَ؟
عرفتُ من مؤسس الداهشية أن يهوذا الإسخريوطي كان من أحب التلامذة إلى السيدة المسيح، وقد أوكل إليه أمانة الصندوق، بالرغم من معرفته أن فيه بعضًا من سيالات قابين الروحية. بل إن معرفتن تلك زادته حرصصا على إحاطته بالعناية والمحبة لعل يتغلبُ على سيالاته السفلية؛ لكن يهوذا لم يُفلح. فرأى يسوع، عشية القبض عليه، أن الساعة قد حانت ليتابع عملية الفاداء التي أتى من أجلها، والتي كانت قد بدأت منذ عصيان آدم وحواء وسقوطهما في التجربة الجنسية. فإذا به، وهو على العشاء مع تلاميذه، يلمح إلى أن واحدًا من بينهم سيسلمه. وإذ سأله يوحنا الإنجيلي، وكان أصغرهم، مَن هو؟ "أجاب يسوع: "هو الذي أناولُه اللُقمة التي أغمسُها. وغمس يسوع لقمة ورفعها وناول يهوذا بن سمعان الإستخريوطي. فلما تناولها دخل الشيطان فيه. فقال له يسوع: "اعمل ما أنت تعمله ولا تبطئ" (يوحنا 13:25- 27) أما الشيطان المشار إليه فإنما هو سيَّالُ قابين التابع للإسخريوطي والذي كان في دركٍ جحيمي جزاء له على قتله لأخيه هابيل.
وفي التعاليم الداهشية الموحاة أنه لم يكن في الخطة الإلهية المبنية على العدالة الروحية أن يصلب يسوع الناصري. ولذلك سمحت بأن يفتديه سيالٌ علوي تابع له، فهبط من عالم فردوسي وتجسد في المكان الذي قصده جنود الرومان بصحبة يهوذا الخائن ليقبوا عليه، بينما حجب يسوع الناصري بسيالٍ روحي عن العيون، وأمضى حياته الباقية التي تجاوزت عشرين سنة ينتقل متنكرًا . هذا السيَّال الذي كان في تجسده شبهه تمامًا لم يكن يعرف سره المسيحيون الأوائل، لكن القرآن الكريم أنبأ عنه بقوله (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) (النساء 157). غير أن فهم سر "التشبيه" بقي غامضًا وعلى تباين لدى المجتهدين المسلمين، ولم يتم جلاؤه غلا في الداهشية وفي شخص مؤسسها، بعد أن أعدم في أذربيجان في 1/7/1947، في خلال ثورة قائمة هناك، ثم بعث من الموت؛ وقد نشرت الصحف صور مصرعه في حينه. علمًا بأن في تعاليم الداهشية أن يسوع كان له سيَّال فردوسي يُسمح له بالتجسد من حين إلى آخر، مثاله حينما مشى على الماء، وظهر بعد صلبه لبعض المؤمنين والمؤمنات، واخترق جدران غرفة كان يجتمع فيها تلاميذه بعد الصلب. هذا السيَّال الفردوسي المتسجد تسميه الداهشية "شخصية".
العقاب الإلهي وبدايةُ انتشار المسيحية
مما كتبه فلافيوس يوسيفوس نقلاً عن نيقولاوس الدمشقي، مرافق هيرودس الكبير الذي أمر بقتل أطفال بيت لحم لعله يقتلُ يسوع معهم، أن مرضًا خفيًا عصبيًا على الشفاء
أصاب هيرودس عام 4 ق.م.، وكان مصحوبًا بحمى شديدة وقرحة في أمعائه، والتهاب في رجله مع صديد ظاهر، وتعفن في أعضائه التناسلية سبب ولادة ديوان فيها، علاوة على آلام تطاق ودافع إلى حك جلده باستمرار، الأمر الذي دفعه إلبى محاولة انتحار أنقذه منها أحد أنسبائه. لكن لم يطل الزمن حتى قضى نحبه في العان نفسه. وإذ ذاك ألهم يوسف في الحلم أن يعود إلى الناصرة مع الطفل يسوع وأمه، لتتم النبوءة القائلة "من مصر دعوتُ ابني" (هوشع11:1).
وفي عهد هيرودس أنتبيا، خليفة هيرودس الكبير، قبض على يسوع وسبق إلى الوالي الروماني. ولما اشتد اضطراب الجموع اليهودية مطالبين بقتل يسوع، أخذ بيلاطس ماء "وغسل يديه أمام الجموع وقال: "أنا بريء من دم هذا الرجل. دبروا أنتم أمره. فأجاب الشعب كله: دمه علينا وعلى أولادنا". (متى 24:27 – 25). هذا الطلب أصبح سببًا روحيًا لعبا اليهود الراغبين في تنفيذه حاضرين كانوا أو غائبين ولعقاب سلالاتهم من بعدهم، إذ قال السيد المسيح مخاطبًا أورشليم عندما اقترب منها: "ليتك عرفت اليوم طريق السلام! ولكنه الآن محجوب عن عينيك. سيجيء زمانٌ يحيط بك أعداؤك بالمتاريس، ويحاصرونك، ويطبقون عليك من كل جهة، ويهدمونك على أبنائك الذين هم فيك، ولا يتركون فيك حجرصا على حجر، لأنك ما عرفت خلاصك عندما أتى زمان الله" (لوقا 41:19 – 44).
وكان هيرودس أنتيباس الذي في ظل حكحمه تم اضطهاد السيد المسيح، متزوجًا ابنة الحارث الرابع ملك الأنباط، الذين أقاموا مملكتهم في "العربية" الكتي كانت عاصمتها بصرى الشام. لكن هيرودس أغرى هيروديا، زوجة أخيه فيليب (من أم أخرى) ليتزوجها؛ فقبلت، شرط أن يتخلى عن ابنة الحارث. وهذا ما دفع يوحنا المعمدان إلى تقريع هيرودس وهيروديا علنًا، الأمر الذي سبب تاريخيصا قطع رأسه. لكن ابنة الحارلث عرفت بمكيدته، فتظاهرت بالمرض وطلبت إليه أن يدعها تستجم في القلعة التي تقعُ على الحدود الفاصلة بين إمارة هيرودس ومملكة الحارث، وهي القلعة الي قُطع فيها رأس يوحنا. ومنها أوصلت خبرها لوالدها. فكان أن أرسل قادةً من جيشه مع جنودهم فاختطفوها، وأعلن الحرب على هيرودُسص أنتيبا، وهزم جيشه. ولما كان هيردوس من موالي الإمبراطور الروماني طيباريوس، فقد أعز هذا الأخير إلى فيتاليو Vitalius، قائد جيشه في سوريا، بأن يُعلن الحرب على الحارث. وعند هذه النقطة يبدأ التدخل الروحي بالاتضاح، وأن ما يشاؤه الله لا يمكن أن ينقضه بشر. ففي أثناء تقدم فيتاليوس بجنوده ليدخل أورشليم وصولاً إلى مملكة الأنباط تدخل رؤساء اليهود طالبين إليه ألا يدخلها حتى لا تُدنس بالتماثيل والصور الوثنية التي يحملها الجنود على راياتهم ورماحهم. وامتد الجدالُ بينهم أيامًا، وإذا بخبر موت طيباريوس يوافي القائد، فإذا ذاك يتراجعُ القائد بجيشه، ولا تنشب الحرب. هذا من ناحية، من ناحية ثانية، اشتدت العداوة بين مملكة الأنباط العربية وإمارة هيرودس، بحيث إن كثيرين من المؤمنين بالمسيح التجأوا إليها, ومن بينهم بولس الرسول الذي بدأ تبشيره الواسع فيها بحرية دونما خطرٍ عليه.
ولم يمض بضعُ سنوات حتى اشتدت المقاومة المسلحة لا ضد الرمان فحسب، بل أيضًا ضد الأرستقراطية اليهودية ورؤساء الكهنة المتحالفين معهم. فقتلت فرق "السفاحين" الكاهن الأكبر يوناثان في أثناء حكم الوالي الروماني أنتونيوس فيلكس Felix A. (52 – 60 ب. م.)؛ وعام 66 (ب.م.) هدموا منزل رئيس الكهنة حنانيا، وقصرين لحفيدي هيرودس الكبير، أغريبا الثاني وشقيقته بيرينيكه Berenike، وأحرقوا المستندات المصرفية العامة. وأقسم "الغيورون" و"السفاحون" على أن يغتالوا كل يهودي خائن يشتبه بأنه يحابي الرومان، بعد أن ادعى زعيم كل فئة أنه هو المسيح المخلص؛ فكانوا يندسون بين الحشود، ويغدرون ضحاياهم بطعنهم في ظهورهم، ثم يتوارون في الفوضى التي تنتشر بين الجماغهير عقب جرائمهم. وانقسمت أورشليم بين المتخاصمين، بل انقسمت كل أسرةٍ تقريبًا، بعضها ضد بعض. وفي العام 68 نشبت فتنةٌ أهلية عمياء صماء، استعمل فيها المتناحرون كل ما وصلت إليه أيديهم من أسلحة، نارية أو معدنية أو حجرية. وقد وصف المؤرخ اليهودي يوسيفس هذه الفتنة الرهيبة التي كان شاهدًا لها بأن الشعب اليهودي أصبح "أشبه بوحشٍ مجنون دفعه فقدانه الغذاء إلى أن يفترس جسده نفسه" ("الحرب اليهودية"، ص 276). وفي أواخر الفتنة انتصر المتطرفون من الشبان والفقراء، بعد أن قتلوا حوالى 12 ألف يهودي"، بينهم معظم الأغنياء. وكانت جثث الشيوخ والأطفال والنساء العاريات منتثرة في الطرق، وليس من يدفنها. وبلغت النكبة ذروتها عام 70، بعد أن أحكمك تيتوس Titus، القائد الروماني، الطوق حول أورشليم، متابعًا الحصار الذي بدأه والده فسبازيان Vespasian الذي كان قد اعتلى عرش روما. فدك منازلها الباقية دكا، ووقضَ هيكلها العظيم تقويضًا، والقليلون الذين نجوا من اليهود وقعوا ضحايا السبي والتشريد والعنت والااضطهاد والاحتقار في مختلف أرجاء العالم مدى ألفين من السنين. وهكذا تمت نبوءة السيدة المسيح في خراب أورشليم كما نبوءته في سقوط الشعب اليهودي "بحد السيف، وسبيه إلى جميع الأمم، ودوس الأمم أورشليم إلى أن تتم أزمنةُ الأمم" (لوقا 21:24). وقدر المؤرخ الروماني تاسيتوس Tacitus،(نحو 55-نحو 117) عدد قتلى اليهود بـ 600,000، بينما قدره المؤرخ اليهودي يوسيفس بمليون و197,000 شخص. وقد انضم أغريبا الثاني اليهودي إلى الجنود الرومان في محاصرة أورشليم وإحراق هيكلها وتقويض عمرانها. وهذا من سخريات القدر!
وقد استطاع اليهود الذين نجوا أن يجمعوا شملهم ويوقدوا ثورةً جديدة بزعامة شمعون باركوشيبا الذي ادعى أنه هو المسيح، وذلك سنة 132. لكن الرومان قضوا عليه تمامًا بعد صراعٍ دام ثلاث سنواتت، دمروا في خلالها 985 بلدة في فلسطين، وذبحوا 580,000 يهودي. وقد قضى في هذ1هذه الحرب الأخيرة ما يُساوي العدد الآنف الذكر من الجوع والمرض والحريق، وخربت بلادُ اليهود كلها تقريبًا، وخرَّ باركوشيبا نفسه صريعًا. أما المسيحية فقد بدأت انتشارها الواسع في اليونان وآسيا الصغرى وروما نفسها بفضل جهاد بولس الرسول بصورةٍ خاصة، ومؤمنين آخرين في طليعتهم بطرس الرسول. وكانت الجالياتُ اليهودية تثيرُ الاضطراب في وجههم حيثما حلوا. وأراد الله أن يمنح كثيرين من المسيحيين فضل العذاب والاستشهاد من أجل اسم مسيحه ونشر مجده في العالم؛ وكان في الخطة الإلهية أن يقوم بهذا الاضطهاد طاغيةٌ لا يقل إجرامًا ودناءةً عن قابين نفسه، ألا وهو نيرون الذي اقترف من الجرائم أفظعها، فقتل، في من قُتل، أمه أغريبينا وزوجته أوكتافيا، وشقيقه بريتانيكوس، وكثيرين من ذويه وأصدقائه، بينهم معلمة الفيلسوف سينيكا. ثم أمر خفيةً بإحراق روما واتهم المسيحيين بحريقها الذي بدأ في 18/7/64 واستمر نحو تسعة أيام. يقولث المؤرخ الروماني تاسيتوس، معاصر نيرون، إن الطاغية من أجل أن يتخلص من تهمة إحراق روما، عمد "غلى إلصاق التهمة وإنتزال أفدح العذابات بطبقة من الناس بحقد الشعب عليهم لأعمالهم الخبيثة، ويسمون بالمسيحيين... وهكذا وجهت ضربة شديدة إلى خرافة خطيرة، فأوقفت نموها إلى حين؛ لكنها لم تلبث أن استعادت نشاطها ليس في اليهودية، منبع الشر الأول فحسب، بل أيضًا في روما نفسها، المركز الرائج والبؤرةِ الفاسدة لجميع الأشياء الدنيئة والممقوتة الصادرة من مختلف أرجاء العالم. وبناءً عليه، أُلقي القبضُ, أولاً، على مَن اعترفوا بأنهم مذنبون ] من المجرمين غير المسيحيين[، ثم استنادًا إلى المعلومات التي أطعوها، أدين كثيرون ] من المسيحين[، لا بناء على أدلة تثبت أنهم ارتكبوا جريمة إحراق المدينة، بل بحجة أنهم يكرهون الجنس البشري. وقد قُرنت طرقُ موتهم بمختلف فنون السخرية والازدراء... على أن المسيحيين، حتى لو اعتبروا مجرمين مستحقين أشد أنواع العقوبات، أثاروا في الشعب عواطف الرأفة والرحمة؛ ذلك بأن تقتيلهم، مثلما بدا، لم يكن لمصلحة الشعب، إنما لإشباع وحشية رجل ] نيرون[". فثار الشعب عليه وحاول قتله؛ لكنه انتحر. وهكذا واجه المسيحيون أقسى فنون التعذيب والموت برباطة جأش وإيمانٍ راسخ، مقتدين بحياة معلمهم الإلهي، سيد المجد.
وإن قارنا خسارة المسيحيين البشرية بخسارة روما الوثنية، لبدت الأولى لا تُذكر. فالمسيحيون الذين قُبض عليهم كانوا قليلين جدًا، لأن مجموعهم، عام الحريق، كان ما يزالُ نزرًا، إذ إن بولس اغلرسول، كان قد أُفرِجَ عنه من السجن في روما قبل سنتين فقط؛ في حين أن خسائر الرومان في الحياة والعُمران كانت هائلة. واستشهادُ المسيحيين مع انكشاف جريمة نيرون أثارا الفُضول في الشعب الروماني ليتعرف الديانة الجديدة. فكانت الأحداث حافزًا قويًا لانتشار المسيحية.
فضلاً عن ذلك، ففي 24/8/79، ثار بركان فيزيوف Vesuvius فجأة؛ وكان من شهوده بليني الأصغر Pliny the Younger الذي تلقى تاسيتوس رسالتين منه. ولما وقف هيجانه، في اليوم التالي، كانت مدينة بومبي Pompeii مغطاةً بطبقة من الرماد البركاني والحطام كثافتها تتراوح بين 19 و23 قدمًا. وفي مدينة هركيولانيوم Herculanium، امتزجت حُمَمُ البركان بسيولٍ من المياه وتغلغلت في أرجاء المدينة كلها وطمرتها بطبقة محرقة متجمدة بلغت كثافتها 65 قدمًا. وما حل في هركيولانيوم حل في ستابيه Stabiae. وقد كشفت الحفريات عن داراتٍ واسعة كثيرة جميلة، وحدائق وساحات ومسارح وأسواق وابنية دينية واقتصادية وقضائية، وأعمدة تحيطها، وتماثيل لجوبيتر وجونو و ميزفا وأبولو وفينوس وإيزيس، وعن مئات المباني السكنية التي تكثر بينها الصروح الفخمة التي تدل على رفاهية أصحابها، معت جدرانها المرصعة وأراضيها المزخرفة وحدائقها ذات الينابيع. أما أكثر المشاهد تأثيرًا من تلك الآثار المحترقة التي جمدها الزمن فمشاهدُ آلاف الهياكل العظيمة التي يختلط فيها الرجال بالنساء والأطفال، وبينها كثيرٌ في حال المضاجعة. هذه النكبة الطبيعية ساعدت المسيحيين في تنبيه ضمائر كثيرة إلى أن فوق البشر والقياصرة قوة إلهية جبارة مراقبة، وأن يسوع الذي قتله الرومان في فلسطين قد يكون حقًا قام من الموت وذات حقيققة جبرون.
السببية الروحية في مجرى الأحداث العامة (7)
المسيحية: من الاقتداء الحي بحياة المسيح إلى بدايات الانحراف
بقلم الدكتور غازي براكس
المسيحية في حياتها المثالية
إن الاقتداء الحي بسلوك المعلم العظيم ومواقفه، سواءٌ في حياغة المسيحيين الأوائل أو في مواجهتهم فنون التعذيب والموت بإيمان راسخ ورابطة جأش، كان أساس خلقية المسيحيين وثقافتهم، بصورةٍ عامة، في الحقبة الأولى التي امتدت ثلاثة قرون. وكان لهذا الاقتداء دعامتان: دعامةُ الحياة ودعامةُ الموت.
أما قوامُ الأولى فكان حياة السيد المسيح المثالية التي أحيتها النزعاتُ السامية والاتجاهاتُ النبيلةُ الصادرة عن تعلقٍ شديد بالحق والخير والمحبة والسلام وما يصدر عنها من قيمٍ روحية. فالمسيحيون، بصورةٍ عامة، ظلوا حوالى ثلاثة قرون يستلهمون سيرته؛ فأنشأوا في كثيرٍ من بلدان العالم متحداتٍ فاضلة كانت أشبه بالجزر اغلسعيدة في بحارٍ تتلاطم فيها أمواج الشرور والأطماع والمظالم والمفاسد. لقد كانوا يحرصون على أن يعيشوا حياة متواضعة بسيطة صالحة تنشد الكمال الخلقي الذي رسمه سيد المجد غايةٌ لهم. ونجحوا في تحقيق ذلك إلى حد بعيد، بعد أن أخفقت المحاولات الفلسفية, ولا سيما الرواقية، في ترقية أخلاق الشعب، إلا في أوساطٍ قليلة.
لقد حافظوا على سمعتهم الطيبة بين الوثنيين واليهود، فامتنعوا عن قصد الملاهي الإباحية، وكذلك عن حضور الألعاب الهمجية الدموية؛ وعاش كثيرون منهم حياة تبتل مقتدين بمعلمهم العظيم وببولس الرسول من بعده، واشتهروا بعطفهم على البائسين والمحرومين واليائسين ومساعدتهم لهم. وبينما كان الوثنيون يئدون أطفالهم، أحيانًا كثيرة، كانوا هم يهتمون بتربية اللقطاء والحدب عليهم.
وكان لهم نظامٌ اجتماعي واقتصادي فاضل وعادل؛ فأسرهم كانت متحدة الأواصر، يشبعُ الوفاء والإخلاص والثقة والطمأنينة بين أفرادها.
وقد ساعدهم على صيانة المستوى الخلقي الراقي تجنبهم الزواغج بغير مسيحيات أو مسيحيين. كذلك كانوا يحلون مشكلاتهم فيما بينهم، ويحترم بعضهم بعضصا مثلما يحترمون رعاتهم والمقدمين فيهم الذين كانت حياتهم قدوةً صالحة لهم. وكانت كل جماعة قد أنشأت صندوقًا ماليًا مشتركًا لها، يستعينون به على المحتاجين فيهم، وعلى إغاثةِ البؤساء والمنكوبين حتى من الوثنيين. ومع ذلك لم يكونوا يزجون بأنفسهم في الصراعات السياسية والعسكرية القائمة في بلدانهم.
أما النساءُ المسيحيات فكن يحافظون على عفافهن وتواضعهن وطاعتهن لأزواجهن أو آبائهن، مثلما يحافظن على جمالهن الطبيعي بالامتناع عن التبرج الذي أخذت به الوثنيات. وقد تشكلت جمعيات من الأخوات العازبات تهتمُ بأعمال الإحسان والصدقات والرحمة. ولا شك في أن تلك الحياة الراقية لم تكن لتتحقق لهم رجالاً ونساءً لولا إيمانهم الوطيد بمصدر دينهم السماوي المثبت بالمعجزات التي صنعها السيد المسيح بالقوة الروحية التي زود بها، ولولا إيمانهم الراسخ برقابة الله لأعمالهم وأفكارهم، وانتظارهم الحسابَ ثوابًا أو عقابًا.
أما دعامة الموت فقد استمدت قوتها ومعناها من موت المسيح وقيامته وفق ما عرفهما وآمن بهما المسيحيون الأوائل. فتعزيزًا لإيمانهم بقيامة الموتى، وتسعيلاً لانتشار المسيحية، شاءت الحكمة الإلهية أن لا يعرفوا بـ"شخصيات" السيد المسيح التي يمكن أن تهبط من عوالها الفردوسية وتتخذ شبهة (أنظر "نشأة المسيحية" في العدد السابق)، بل أن يؤمنهوا بأن يسوع نفسه هو الذي مات على الصليب فداءً عنهم؛ فعليهم، إذًا، أن يموتوا من أجله إذا اضطرهم المضطهدون إلى ذلك، أو إذا خيروهم بين الموت أو نبذ إيمانهم. واستشهادهم يجب أن يقترن بابتهاجمهم، لأن القيامة ستعقبه، ولأنه سيفتح أمامهم أبواب السعادة الأبدية.
وبالرغم من الاضطهادات، المتواصلة حينًا والمتقطعة أحيانًا، التي عاناها المسيحيون منذ عهد نيرون (سنة 64م)حتىى قيام قسطنطين الكبير إمبراطورًا أوحد للدولة الرومانية سنة 324، بعد أن كانت سلطتُه مقتصرة على الغرب منذ سنة 313، فإنهم استطاعوا أن يضعوا، في عالمٍ أرهقته القوة الوحشية والظلمُ والطمعُ والفجور، أسس ثقافة جديدة قوامها حياةٌ خلفقية راقية نُسغُها المحبة والفضيلة، وجناحاها نظرةٌ إلى الحياة ترى فيها الدنيا مقر شقاء وفناء ومعبرصا إلى الآخرة، ونظرة إلى الموت ترى فيه يقظةً في عالم السعادة الأبدية.
وكان من مظاهر هذه الثقافة أدبٌ ديني مسيحي يدورُ معظمه حول تعظيم الإيمان وتمجيد الله والقيم السامية وإيضاح أُسس الدين الجديد ومبادئه. ففي القرن الأول وضع بولس الرسول أُسُسَ الفكر المسيحي في رسائله إلى جميع الكنائس الناشئة، مظهرًا أنه تتمة وتخط لمفاهيم العدالة والفضيلة لدى أفلاطون- من غير أن يسمى مصدرها وفق ما أجمع الباحثون اللاهوتيون عليه – التي كانت تعمُّ العالم الروماني المثقف. وفي القرن الثاني ظهر عدة لاهوتيين لعل جاستن مار Justin Martyr (نحو 100 – نحو 165) كان أبرزهم، فحاول التوفيق بين الفكر المسيحي، وخصوصًا وفق ما أظهره بولس الرسول، والفكر الأفلاطوني؛ حتى إنه اعتبر أن أفلاطون، كما إبراهيم وسقراط، "كان مسيحيًا قبل المسيح". أما في القرن الثالث فقد برز جيل من المفكرين المسيحيين الذين أظهروا غاية الجرأة في دفاعهم عن دين المحبة والحق والروحانية ضد المفكرين والفلاسفة الذين كانوا يطعنون فيه ويسخرون من مؤسسة وتعاليمه وأتباعه. وقد حاول المفكرون المسيحيون أن يظهروا تفوق الفكر المسيحي على الفكر الفلسفي اليوناني المادي بإيضاحهم أنه ينطوي على أفضل ما في الفلسفة الأفلاطونية من جوانب الخير والحق والعدل، فضلاً عن أنه فكر حي فاعل في حياة المسيحيين. وكان أبرز أولئك المفكرين على الإطلاق أوريجينوس Origen (نحو 185 – نحو 254)، أكبر آباء الكنيسة المسيحية بعد بولس الرسول، ومعلم المسيحية الأول في عصره. فقد كان متزاهدًا، متقشفًا، كثير الصوم، قليل النوم، متعففًا. وقد جعل الفلسفة المسيحية تتمة وتجاوزًا للفلسفة الأفلاطونية؛ فرأى أن الله هو الجوهر الروحي الأصلي للخلائق جميعًا، وأن المسيح هو القوة الكونية التي خلقها الله ليجعلها العقل المنظم المدبر للعالم؛ كذلك آمن بوجود النفوس قبل الولادة، وبالتقمص، وبالعوالم الكثيرة المتراتبة التي تجتازها النفوس قبل حصولها على السعادة الأبدية.
وهكذا ما إن نبلغُ أواخر القرن الثالث حتى تكون الحضارة المسيحية قد احتوت وورثت أفضل ما أطلعته الحضارة اليونانية الرومانية من قيم ومثل عليا، وأضحت صرحًا شاخمًا. وكان فضلُ أولئك المنافحين عن العقيدة المسيحية أنهم أعلوا أصواتهم في الدفاع عنها في أقسى مراحل اضطهادها.
جميع العوامل السابقة – إيمان المسيحيين الراسخ بعقيدتهم المبنية على خلود النفس والحياة الأبدية، والمعجزات الصحيحة، والخلقية العالية والسيرة النقية في أوساط تعج بالمفاسد والإغراءات، وكذلك عامل اتحادهم ونظامهم في مؤسسات دينية مطردة القوة ومستقلة في قلب الإمبراطورية الرومانية، فضلاً عن إيمانهم بعودة المسيح ونهاية العالم وعيش المؤمنين حياة سعيدة في "أورشليم جديدة" – كل ذلك يراه المؤرخ الإنكليزي الكبير إدوارد جيبون Gibbon E. أسبابًا قوية لتنامي المسيحية في القرن الثلاثة الأولى.
لكن هذا الجانب الإيجابي في المسيحية عززه أيضصا جانب سلبي في الدولة الرومانية. فعلى حد قول المؤرخ الكبير ديورانت Durant : "إن المسيحية قد تنامت ذلك التنامي الحثيث لأن روما كانت، عصرئدٍ، في دور الاحتضار. فالناس لم يفقدوا إيمانهم بالدولة لأن المسيحية أبعدت عواطفهم عنها، بل فقدوه لأن الدولة كانت تناصر الأثرياء على الفقراء، وتحارب لتستولي على العبيد، وتفرضُ الضرائب على الكادحين لتُعين المترفين، وكذلك لأنها عجزت عن حماية الشعب من المجاعات والأوبئة والغزو الأجنبي والفقرِ المدقع. فالناسُ لا يلامون، بعد ذلك، إذا تحولوا عن قيصر الداعي إلى الحرب إلى المسيح الداعي إلى الإسلام، وعن الوحشية التي يكادُ لا يصدقها العقل إلى الإحسان الذي لم يسبق له مثيل، وعن حياة خالية من الأمل والكرامة إلى دينٍ يؤاسيهم في فقرهم ويكرم إنسانيتهم".
والحقيقة أن العواغمل الايجابية والسلبية تدخل معًا في الخطة الإلهيةت التي ابتدأ تنفيذها بمولد المسيح واضطهاده من أجل أن تتم عملية الفداء، ثم تتابعت بتقتيل الشعب الذي اضطهده وتشريده وتدمير موطنه وفق نظام شامل لا يخطئ للعدالة الإلهية والاستحقاق الروحي (أنظر الحلقة السابقة)، ثم استنمت الخطة الإلهية نفسها في تنامي المسيحية التدريجي مستمدة قوة انتشارها من عوامل ذاتية إيجابية وخارجية سلبية.
بدايات الانحراف سلوكيًا وعقائديًا
إن بذورَ انحراف المسيحية عن خطها القويم سلوكيًا وعقائديًا بدأت تزرع منذ القرن الأول. فبولس الرسول يلمح إلى "الإخوةِ الكذابين" في رسالته الثانية إلى أهل كورنُثس (11:26). وفي أواخر القرن الأول، يوضح يوحنا في رسالته الأولى أن روح المسيح الدجال أخذت تتغلغلُ في فئة من المسيحيين، وأن على المؤمنين الصادقين أن يحذروا روحه، لأنها في نفوس المنافقين من المسيحيين تعشش. يقول: "وكما إنكم سمعتم ن المسيح الدجال يأتي، بيننا الآن مسحاءُ دجالون كثيرون...
منا خرجوا، ولكنهم لم يكونوا منا..." (18:2)
فالنفاقُ والجباغنة والفتور والغرور والكبرياء والطمع والبخل والأنانية وحب التسلط والنزعاتُ الشهوانية لم تمت في نفوس كثيرين، بل كانت مهومة حتى استيقظت ونشطت ونمت، مع كرور الزمن، بقدر ما غذتها النزعات والأفكار الدنيوية المنحطة في الأوساط الوثنية. فما إن نبلغُ أواسط القرن الثالث الميلادي حتى يقول سيبريان Cyprian (نحو 200 – 258)، أحد أساقفة الكنيسة الإفريقية (قرطاجة)، مصورصا حال المسيحيين في بلاده: "كل واحدٍ يصرفُ همه إلى زيادة ثروته. والتقوى انعدمت لدى الكهنة، وفسد الإيمان، وزالت المحبة من الأعمال، وانتفت القواعد من الحياة الخلقية... فالنساء يتبرجن مفسدات نقاء عيونهن التي أبدعها الله، وخاضبات شعورهن بأصباغ كاذبة. ومن أجل خداع القلوب البسيطة يلجأ إىل المكر والحيلة. فالمسيحيات يتزوجن بغير مسيحيين، والمسيحيون يقدمون المسيحيات، أعضاء المسيح، كالعاهرات إلى الوثنيين. ولا يكتفي المسيحيون بالقسم في كل مناسبة، بل يحلفون بالباطل أيضصا وهم لا يبدون إزاء رؤسائهم إلا كل ازدراء، وينفثون على القريب سم النميمة، ويجعلون الأحقاد تقسمهم شيعًا".
كذلك تكاثرت البدع. فمنذ القرن الثاني نشأت بدع تدور حول شخص يسوع وطبيعته وعلاقته بالله، حتى إن إيرينيوسIreneaus أحصى، سنة 187، عشرين شيعةً مختلفة من المسيحيين. وما إن نصلُ إلى سنة 384 حتى يحصى إبيفانيوسEpiphanius ثمانين شيعة.
ولا يكتفي سيبريان باتهام المسيحيين، لكنه يطعن أيضصا في سلوك الأساقفة زملائه الذين يعيشون في البذخ، ويحاولون التوفيق بين الله والعالم, والصلوات والشهوات، أمثال بولس السميساطي (260) الذي جمع إلى مهمته الأسقفية في إنطاكية وظيفة جابي الرسوم والضرائب، وكان من مخظيي زنوبيا، ملكة تدمر
وبعد أن كان المسيحيون يتعاملون كإخوة، بدأت كنيسة روما تظهر نفسها كأخت كبرى لها الحق في أن تنصح أو تؤنب أخواتها الكنائس الأخرى في بداية القرن الثاني؛ حتى إذا أطل القرن الثالث بدأ أسقف روما باسمه الخاص يحرم الكنائس الأخرى التي تخالفه بالرأي مثلما حدث مع فتكور الأول (نحو 190 – 202) الذي حرم متفردًا كنائس آسيا الصغرى لاختلافها معه في ما يتعلق بالاحتفال بأحد الأعياد؛ فكان أول أسقف عرف بغطرسة شديدة وبآرائه الاستبداية. وقد أحذث موقفه انقسامًا في الكنيسة. وخلفه زفيرينس Zephyrinus (نحو 202 – نحو 2017) الذي كان رجلاً ساذجًا غير مثقف؛ فرفع إلى رئاسصة الشمامسة كالستُس Callistus، الذي كان مطعونًا في أخلاقه، إذ إنه بدأ حياته عبدًا، ثم صار من رجال المال والمصارف، واختلس الأموال المودعة عنده؛ فحكم عليه بالأشغال الشاقة، ثم أطلق سراحُه. كذلك أثار شغبًا في أحد المجامع الدينية، فحكم عليه بالأشغال الشاقة في مناجم سردينية؛ لكنه هرب منها بحيلة. ولما مات زفيرينس. اختير كالستُس أُسقفًا أول لكنيسة روما؛ فأعلن هيبوليتُس Hippolitus وغيره من القساوسة أنه لا يصلح لمصبه، وأقاموا، سنة 218، كنيسة وبابوية غير كنيسته وبابويته. لكن كالستُس أعلن حرمان هيبوليتس، وثبت دعائم سلطة الكرسي الأسقفي الروماني على العالم المسيحي كله. وبذلك تحول اسم البابا من اسم فيه معنى الأبوة، كان يطلق على كل رجل دين مسيحي، إلى اسم يحمل معنى الرئاسة الاستبدادية المطلقة. هذه الحال التي آلت إليها البابوية دفعت ترتليانوس Tetullianus(نحو 155 – نحو 222)، أحد مفكري المسيحية الكبار، غلى أن يطلق على البابا لقب "راعي الزناة" Pastor moechorum. والجدير بالذكر أنه قبل أن ينتصف القرن الثالث، كانت البابوية قد بلغت في مكانتها ومواردها المالية كانت البابوية قد بلغت في مكانتها ومواردها المالية حدًا جعل الإمبراطور ديسيوس Decisu (249-251) يقسم أنه يفضل أن يكون في روما إمبراطور ثانٍ ينافسه على أن يكون فيها بابا. وحسدُه هذا للثروة البابوية وسلطتها الواسعة دفعه إلى إقرار أول اضطهاد منظم للمسيحيين؛ فأمر جميع المواطنين تبقديم ذبائح وثنية أمام مندوبين من الحكومة على أن يثبت ذلك في شهادات رسمية. وأدى هذا القرار إلى أن يفقد كثيرون من أساقفة روما وأورشليم وأنطاكيا حياتهم، وأن يعتقل كثيرون من المسيحيين. وسيعقب ذلك فترةُ رحمة إلهية تمتد من سنة 260 إلى 23 شباط 303 إذ يبدأ أسوأ اضطهاد عرفته المسيحية في تاريخها، ويستمر لغاةي عام 313 ، وذلك طوال عهدي الإمبراطورين ديو كليسيان Diocletian وغاليريوس Galerius، بحيث نسي المسيحيون المعمرون واستصغروا كل اضطهاد سابق، لأن اضطهادهم منذ عهد نيرون كان متقطعًا وغير رسمي، ومتعلقًا بالظروف وبحاكم كل منطقة؟
عند هذا الحد لا يسعُ المتبصر بالسببية الروحية ونظام العدالة الإلهية والاستحقاق الروحي إلا أن يتساءل: ثرى، ألم يعاقب المسيحيون، وخصوصًا رعاتهم،أنفسهم، بانحرافهم عن السلوك المثالي والقيم الروحية التي فرضتها عقيدتهم السماوية، فجروا عليهم ذلك الاضطهاد الرسمي الرهيب المنظم، في عهد ديسبوس، ثم في عهدي ديو كليسيان وغاليريوس، لأنهم لم يتعظوا ولم يستفيدوا من رحمة الله مدة ثلاث وأربعين سنة؟
الإنحرافُ الكبير في المسيحية
ألمعتُ آنفًا إلى أن اضطهاد المسيحيين العنيف استمر حتى سنة 313، ذلك بأن الإمبراطورين قسطنطين وليسينيوس Licinius (الذي كان متزوجًا قسطنطيًا، شقيقة قسطنطين من غير أم)، اللذين كانا يتقاسمان حكم الإمبراطورية الرومانية، أصدرا في العام المذكور اتفاق ميلان Milan الخاص بالتسامح الديني. ونعرف من المؤرخين أن هيلانه، والدة قسطنطين، اعتنقت المسيحية، وكذلك قسطنطيا؛ ويبدو أن الأولى أثرت في ابنها، والثانية في زوجها إلى حد ما. ولم يكن رعاة المسيحيين يطمعون، في ذلك الحين، بأكثر من ذلك. وبالرغم من قلة المسيحيين بالنسبة للوثنيين المقسمين إلى شيعٍ متعددة، فإن اتحاد معظمهم، وخصوصصا الخاضعين لبابا روما، وزرع رعاتهم في نفوسهم واجب الطاعة للسلطات السياسية قد اجتذبا اهتمام قسطنطين، فاستفاد منهم لتعبئة اثني عشر فيلقًا لقتال مكسنتيوس وليسينيوس، مثلما استفاد من تأييد نظام كهنوتي له يُناسبُ نظام الملكية المطلقة السلطان. فدعا، عام 325، إلى مجمع مسكوني مسيحي (يحضره الأساقفة جميعًا) في مدينة نيقيا Nicea. لكن النقد التاريخي لشخصية قسطنطين وسلوكه يظهرُ أنه استخدم المسيحية وسيلةً لا غاية، وبذلك جرها إلى التحالف مع الدولة الرومانية، بالرغم من فساد طرقها، وانحراف سلوكه، وإلى إدخال "أسرار" وطقوس لم تكن أصلاً في الواقع التاريخي المسيحي ولا مذكورة في العهد الجديد؛ منها عقيدةُ التثليث (إله واحد في ثلاثة آلهة متساوية). وبعد هدنةٍ بين الإمبراطورين، عاد القتالُ بينهما عام 324؛ وفي السنة نفسها التي انعقد فيها مجمعُ نيقيا قتلَ قسطنطين صهره بيديه خنقًا، بعد نفيه.
يقولُ د=يورانت: "اضطر قسطنطين إلى أن يتحسس كل خطوة يخطوها بحذر، لأن الوثنية كانت ما تزال الغالبة على العالم الذي يعيش فيه. لذلك ظل يستخدم ألفاظًا توحيدية يرضى بها كل وثني؛ وقام، بصبرٍ وأناة، في خلال الأعوام الأولى من بدء سلطانه الأوحد ] 324[، بجميع المراسيم التي يقتضيها منه منصب الكاهن الأكبر Pontifex Maximus، والتي توجبها عليه الطقوس التقليدية، وجدد بناء الهياكل الوثنية، وأمر بممارسة أساليب العرافة، واستخدم في تدشين القسطنطينية شعائر وثنية ومسيحية معًا، واستعمل رقى سحرية وثنية لحماية المحاصيل وشفاء الأمراض".
أما رؤيا الصليب الذي زعم أنه رآه مُرتسمًا في السماء، في 27/10/312، في يوم انتصاره على مكسنتيوس، فقد سبقها، قبل ثلاثة أعوام، رؤيا أخرى ادعى أنه في أثنائها ظهر له الإله أبولون. فضلاً عن ذلك فقد بقي سطحي المعرفة بالدين المسيحي، بل متشككًا، إذ إنه لم يتقبل المعمودية إلا قبيل وفاته؛ وقد يكون قبلها بضغط من أمه هيلانه وأخته قسطنطيا وبعض الأساقفة المقربين ليرضيهم. ومعظم المؤرخين الكبار يشكون في صحة معموديته كشكهم في رؤيا الصليب، لأن روايتهما حصرت بأسقف واحد كان يؤرخ وثائق الكثلكة هو يوسيبيوس Euebius الذي عاصر قسطنطين وكان متملقًا له، ومتناقض الآراء وفق ما رآه المحللون لكتبه التاريخية.
زد إلى ذلك أن سلوك قسطنطين لم يكن سلوك مسيحي مؤمن، بل هو سلوكٌ شائن حتى لدى مقارنته بسلوك الأباطرة الوثنيين الفلاسفة أمثال تراجان وهدريان وماركوس أوريليوس وغيرهم. فبعد تنصره المزعوم، قتل ابن مكسنتيوس وعدة أصدقاء وأعوان له، ثم حارب صهره ليسينيوس وانتهى بخنقه، وبعد عام واحد من ترؤس قسطنطين مجمع نيقيا (326)، قتل ابنه كريسيوس وأمر بقتل فوستا، زوجته الثانية وابنة مكسيميان.
وقد اتبع قسطنطين سياسة التوفيق بين الوثنية والمسيحية في معظم عهده: فقد شجع على بناء الكنائس كما شجع على تشييد الهياكل الوثنية؛ ومثلما نقش حرفي (XP) اليونانيين – وهما الحرفان الأولان من اسم المسيح باليونانية (خريستوس) على النقود، فقد نقش على الأوسمة صور جوبيتر وأبولون ومارس وهرقل. ومثلما كان يدخل الكنائس، فقد قبل أن يكرس باسمه هيكلٌ وثني وينصب فيه تمثال ذهبي له. وخلاصةُ القول إن قسطنطين الذي أرادت الكنيسةُ الكاثوليكية أن تجعله أعظم الحكام المسيحيين، والذي نصبته الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية قديسًا، لم يكن مسيحيصا لا في سلوكه ولا في عقيدته. وعهده الذي أنهى اضطهاد المسيحيين في الغرب، كان في الآن نفسه، بداية انحراف المسيحيين الكبير عقائديًا ومسلكيًا، وبداية انحراف المسيحيين الكبير عقائديًا ومسلكيًا، وبداة انخطاط الكنيسة المسيحية بصفتها قوة منظمة يجب أن تكون نقية الإيمان وقويمة العقيدة والسيرة، كما كان عهدهُ نذير شؤمٍ لانحلال روما القريب وتفككها.
وقصارى القول، وفق ما ذهب إليه ديورانت، "أن الرهبنة المسيحية قامت احتجاجًا على توفيق المسيحيين بين الروح والجسد، ذلك بأن قلائل من المسيحيين كانوا يرغبون في الابتعاد عن طاعة أية شهوة بشرية ناشدين الاستمرار في سلوك الطريق المسيحي القديم ومتأملين في الحياة الأبدية الخالدة" فقامت، أولاً، حركة الزهد الفردي وانتشرت الحياة المتقشفة المعتزلة حتى كثر النساكُ على الضفة الشرقية من النيل؛ فجمعهم باخوميوسPachomius الذي كان حنكةٍ إدارية، عام 325، في رهبنة جماعية بدير عند طابين في مصر. لكن السلطة الكنيسية قاومت حركة الرهبنة وقتًا ما، ثم رضيت بها، أخيرصا لتوزاون بها اهتمامها وفي شؤون الحكم. ولما مات باخوميوس، كان قد أسس 11 ديرصا احتوت على أكثر من 7000 راهب وراهبة. وكان ذلك أول عمل واقعي جماعي يشهدُ على انحراف المسيحية عن القيم الروحية الأصلية ويدين رجال الدين فيها.
ولم يقف الانحرافُ عند الخلقية والسلوك العام، فقد أقيم كثيرون من الشهداء وغير الشهداء قديسين، ونصبوا شفعاء لدى الله، وبدأ ادخارُ بقاياهم، بعد أن كان يكتفى بتكريم الشهداء في القرن الثلاثة الأولى، وصنعت صورٌ وأيقونات لهم لعبادتها. ووضعت عدة تواريخ كاذبة لاحتفالات ومناسبات دينية، لعل أهمها يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) تاريخًا لميلاد السيد المسيح؛ علمًا بأن هذا التاريخ كان مخصصًا عند الرومان للاحتفال بمنتصف الشتاء وانقلاب الشمس، وفي إيران للاحتفال بالإله ميترا، شمس الاستقامة. وفي الواقع التاريخي لم يكن معروفصا تاريخ ميلاد المسيح بدقة، لكن الأناجيل تُشيرُ إلى أن رعاة كانوا ينامون في الفلاة ويتناوبون السهر على قطعانهم (لوقا: 8:2) يومً مولده؛ وفي ذلك إشارة واضحة إلى أوسط الربيع أو أواخره.
كذلك بدأت المحاكمات يتلوها الاضطهاد لكل فئة مخالفة بالرأي في تفسير أي جانب من العقيدة التي أقرها مجمع نيقيا وما تبعه من مجامع. فحوكمت، في مجمع نيقيا نفسه، الآريوسية (نسبة إلى آريوس Arius، أسقف الإسكندرية) القائلة بوحدانية الله وتفرده بوجوده الأزلي الأبدي وثباته في عدم تغيره، وبأن السيد المسيح غير مساوٍ لله، واعتبرت هرطقة، ونفي القائلون بها وحوربت عقيدتهم. ذلك بالرغم من أن الأناجيل خالية من أي دليل يثبت أن يسوع المسيح مساغوٍ لله عز وجل. فحينما كان يسوع في جبل الزيتون يصلي، قُبيل القبض عليه، قال مخاطبًا اغلله تعالى: "يا أبي، إن شئت، فأبعد عني هذه الكأس؛ ولكن لتكن مشيئتك لا مشيئتي" (لوقا 42:22) . فمن العباتين السابقتين نستخلص بوضوح أن إرادة الله مفصلة عن إرادة يسوع، وأن الله هو إله. وإذا قال السيد المسيح لفيلبس: "ألا تؤمن بأني في الآب وأن الآب في؟ (يوحنا 10:14) فإنه قال وهو ما يزالُ في الموقف نفسه: "لن أترككم يتامى، بل أرجعُ إليكم... وفي ذلك اليوم تعرفون أني في أبي، وأنك أنتم في مثلما أنا فيكم" (يوحنا 20:14). إنه الانتماءُ في الجوهر الروحي والتكامُل. كذلك قال يسوع: "أنا ذاهبٌ وسأرجعُ إليكم، فإن كنتم تحبونني فرحتم بأني ذاهبٌ إلى الآب، لأن الآب أعظم مني" (يوحنا 28:14)؛ وفي هذا القول برهانٌ قاطع على عدم المساواةِ بين السيد المسيح والله عز وجل. وبعد قيامه المسيح من الموت وترائيه لمريم قال لها: "لا تلمسيني، لأني ما صعدتُ بعدُ إلى الأب، بل اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: "أنا صاعدٌ إلى أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم" (يوحنا 17:20) ؛ فساوى في أبوة الله والخضوع له بينه وبينهم. أما قولُ يوحنا في بداية أنجيله؛ "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله" فإنما هو محصور في الأزل، حينما كانت الأرواحُ كلها في ذات الله، قبل أن يبدأ التكوينُ المادي. وهكذا نرى أن الآريوسية كانت على صوابٍ في عقيدتها، وأن كنيسة روما التي ستعرفُ بالكنيسة الكاثوليكية كانت منحرفة، لأن الحقيقة الروحية هجرتها، بعد أن انحرفت في سلوكها وقيمها التي أصبحت تساوي قيم الحكام الدنيويين.
كذلك اضطهد نسطوريوس Nestorius، اُسقفُ القسطنطينية، مؤسس النسطورية، لأنه رأى في الإيمان الكاثوليك بأن "مريم العذراء هي أم الله" انحرافصا عن الحقيقة المسيحية الأصلية؛ فحرم من الكنيسة في مجمع أفسس سنة 431، ونفي. وفضلاً عن محاربة فرق دينية كثيرة اختلفت مع الكثلكة في تفسير بعض الجوانب العقائدية، حرمت كتبث اللاهوتي العظيم أوريجينوس وأتلفت.
وما إن نصل إلى عام 391 حتى يحرق الكهنة في الإسكندرية مكتبتها المحتوية على التراث الثقافي الإنساني العظيم، ولا سيما التراث اليوناني، بحجة أنها تعلم الوثنية؛ وعام 415 تُقتل هيباتيا Hypatia، مديرةُ المكتبة، ورئيسةُ مدرستها التي كان يقصدها أبناء الأثرياء والموظفين الكبار في الإسكندرية، فضلاً عن الفلاسفة أنفسهم من جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، ليسمعوها تتحدث عن الأفلاطونية الجديدة وعن أفلاطون. وكانت توصف بالتسامح الديني وتدافعُ عن تلاميذها من المسيحيين، وتمتاز بالحشمة الكاملة والتعفف التام حتى آخر حياتها. وصفاتها تلك مع بلاغتها وجمالها الرائع وجمعها علم الفلك والرياضيات إلى الفلسفة دفع بعض المؤرخين إلى أن يقولوا فيها: "إنها روح أفلاطون تجسدت في جسم أفروديت". ولم يكتف سيريل Cyril، بطريركُ الإسكندرية، بدفع غوغائه إلى قتلها غيظًا وحسدًا، بل قطعوا جثتها وجرورها في الشوارع، ثم أحرقوها! وبقتلها وإحراق مكتبة الإسكندرية خسر العالم المتحضر إرثًا ثقافثًا لا يقدر، وبدأت عصور الظلام تخيم على أوروبا.
إن الواقع التاريخي يبرهن أن الحياة المسيحية جعلت تتغير تدريجيًا بمجرد أن المؤسسات الكنسية أخذت تقوى وتعظم سلطاتها على رعاياها. وبعد تحالف السلطة الكنسية مع السلطة السياسية، بدأت دلائل الانحدار الروحي تشتد: فالاهتمامُ بتكديس الثروة وحب التسلط والجاه ومحالفة الأغنياء والنافذين واللامبالاة بالضعفاء والفقراء، علاوة على القمع العنيف لكل حركةٍ مخالفة بالرأي للبابوية – كل ذلك كان يظهر أكثر فأكثر في السلكة الكنيسية. هذه البذور الفاسدة التي زرعها المسيحيون عامة ورعاتهم خاصة في القرن الثالث ولا سيما الرابع سرعان ما سيحصدون جناها.
في العدد المقبل
السببية الروحية في مجرى الأحداث العامة(8)
تمادي كنيسةُ روما في الانحراف وتعاظُمُ الغضب الإلهي عليها
بقلم الدكتور غازي براكس
بينت سابقًا عواقب المعصية التي ارتكبها آدم وحواء في ماجريات الأحداث التي أصابت ذرايهما ثم نسل ،وع ومن تلاه من أنبياء حتى تدمير أورشليم وتدهور حضارة العبرانيين بدءًا من القرن السابع ق.م. بيد أن الهداية الروحية لم تزل من الأرض، بل انتقلت سيالاتها في القرن نفسه، في خطوط متوازي، إلى الهند والصين واليونان. فتمثلت في الهند بحُكماء "الأوبانيشاد" و"الباغافاض غيتا" كما في مهافيرا وبوذا الذي حارب البراهمة تعاليمه لأنها تعدعو إلى إزالة الحواجز بين الطبقات. وفي الصين ظهر لاوتسو وكنفوشيوس اللذان اعتنق الملايين تعاليمهما بالرغم من مقاومتها. كذلك ظهر في اليونان عدة حُكماء وهداة كان أبرزهم فيثاغورس وسقراط. فاضطهد الأول وحكم بالإعدام على الثاني. وكانت النتيجة أن اليونان فقدت عهدها الذهبي منذ ذلك الحين، لكن تعاليم سقراط ظل تأثيرها فاعلًا حتى اليوم من خلال كتابات تلميذه أفلاطون. وبعد أربعمئة سنة ظهر السيد المسيح في فلسطين، فاضطهده اليهود. وكانت النتيجة تشريدهم وتدمير بلادهم وبداية انتشار المسيحية وقيمها الروحية في العالم الروماني. غيبر أن المسيحيين، مؤسسات ومؤمنين، أخذوا بالانحراف عن تعاليم معلمهم، منجذبين إلى القيم الدنيوية والشهوات وقمع الحريات.
كان يمكن أن تصبح الآريوسية المؤمنة بوحدانية الله الكنيسة الكبرى وتسعى "الكنيسة الكاثوليكية الرومانية"، ذلك بأنها استمرتتغالب تيار التثليت ما يزيد على نصف قرن، وأوشكت أن تتغلب عليه؛ لكن المشيئة الإلهية كانت غير ذلك، لأن الأسباب الروحية لا بد من أن تولد نتائج محتومة. فمسيحيو روما الذين أتبعوا خط قسطنطين الموفق بين الدين والدنيا والتزموا مبادئ مجمع نيقيا المنحرفة، تمادوا في شذوذهم عن قيم المسيح الروحية، وانجذب معظمهم لمغريات الدنيا، فاستحقوا أن يحصدوا ما زرعوه. وهكذا هجرت الحضارةُ الروحيةُ العالم المسيحي عندما هجر اغلمسيحيون تعاليم سيد المجد. وفي أثناء هذه الهجرة التي استمرت حوالى اثني عشر قرنًا، بدءًا من القرن الرابع، كانت الطوائف المسيحية تقسمها وتثيرُ الفتن بينها المجادلات الدينية العقيمة، فتتناحرُ تناحُرًا شنيعًا. وكان البابوات يحولون سلطتهم الروحية تدريجيصا إلى سلطة دنيوية سياسية.
الدولة البابوية السياسية العسكرية
إن ملكوت المسيح روحي، لا سياسي على الإطلاق. وقد أكد يسوع هذه الحقيقة أمام بيلاطس الذي أحيل عليه لمحاكمته، فقال: "ما مملكتي من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم، لدافع عني أتباعي حتى لا أسلم إلى اليهود. لا، ليست مملكتي من هنا" (يوحنا: 18: 36). وفي موقف آخر، سأله الفريسيون: "ما رأيك؟ أيحل لنا أن ندفع الجزية إلى القيصر أم لا؟ فعرف يسوع مكرهم، فقال لهم: "يا مُراؤون! لماذا تحاولون أن تحرجوني؟ أروني نقد الجزية. فناولوه دينارًا. فقال لهم: "لمن هذه الصورة وهذا الاسم؟ فقالوا: "للقيصر. فقال لهم: "إذًا ادفعوا إلى القيصر ما للقيصر". فقال لهم: "إذًا ادفعوا إلى القيصر ما للقيصر، وإلى الله ما الله" (متى: 17:22 – 22). ففصل بين السلطة الدينية والحكم الدنيوي.
لكن مجرى الأحداث في كنيسة روما كان غير ذلك. فعام 554 اعترف الإمبراطور يوستنيانس الأول Justinian I بسلطة البابا الزمنية (السياسية)، تلك السلطة التي سرعان ما حولت ملكوت المسيح الروحي إلى مملكة أرضية، فراح بابا روما يبرزُ للناس زعيمًا سياسيصا أكثر منه راعيًا روحيًا. فما إن نبلغُ مطلع القرن السابع حتى يكون البابا غوريغوريوس الأول Gregory I (590 – 604) قد وضع قواعد لدولة بابوية ذات أراضٍ شاسعة ورعايا تحكمهم روحيًا ودنيويًا.
ولم يقف طمعُ البابوات الدنيوي عند حد؛ فسنة 756 وسع البابا إسطفان الثاني StephenII (752 – 757) رقعة الدولة البابوية وتبنتها نهائيًا دولةً سياسية. وإذا الدولة الدينية الدنيوية يشتد انحرافها مع الزمان، ويتفاقم تدخلها في قضايا السياسة الأوروبية والعالمية، حتى أخذت تحتل تدريجًا، في ميزان السياسة الدولية، المكانة التي كانت تشغلها الإمبراطورية، الرومانية. فما إن نبلغُ سنة 849 حتى يكون البابا لاون الرابع Leo IV (847 – 855) قد أنشأ أسطولاً خطير الشأن ليخوض به الحروب ضد أعدائه. وهكذا انقلبت البابوية على تعاليم السيد المسيح القائل: "هنيئصا لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون" (متى 9:5)، و"سمعتم أنه قيل: أحب قريبك وأبغض عدوك؛ أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم" (متى 43:5 – 44).
كذلك جعلوا يحالفون الأسر الإقطاعية، ويحوكون المؤامرات، ويثيرون الفتن والقلاقل بين الدول المسيحية نفسها. ولم يكن في تنصيبهم أي اعتبارٍ للفضيلة أو الحكمة. مثالُ ذلك أن يوحنا الثاني عشر John XII( 955 – 963)، كونت ده توسكولوم، ارتقى السدة البابوية في السادسة عشرة من عمره، واستسلم للإغراءات الدنيوية، وانهمك في الشؤون السياسية، وأوقدج الفتن والحروب؛ وبنوا التاسع Benoit IX (1032 – 1046) نصب بابا وعمره خمسة عشر عامًا؛ وكانت سيرته المنحرفة شبيهة بسيرة السابق.
وتدخل البابا أُربانُس الثاني Urban II(1088 – 1099) في شؤون إسبانيا وفرنسا وإنكلترا محالفًا أو مخاصمًا ملوكها. وأوفد الحروب الصليبية التي كانت مقنعة بالإيمان الديني والحرص على استعادة الأراضي المقدسة، في حين أن الحقيقة التاريخية تظهر الأسباب الكريهة لتلك الحروب، وبينها الطمع بمال الآخرين وممتلكاتهم، ومحاربة لا المسلمين فحسب، بل حتى اليهود والمسيحيين الذين ليسوا من الكاثوليك الأوروبيين. يقول جونسون Paul Johnson في كتابة البارز "تاريخ المسيحية": منذ البداية تعلم الصليبيون أن يبغضوا البيزنطيين بقدر بغضهم المسلمين. فعام 1204، هاجموا القسطنطينية واحتلوها إكرامًا لله والبابا والإمبراطورية. وفي كاتدرائية القديسة صوفيا مزقواغ الصور المعلقة، وحطموا القاطع الأيقوني الفاصل بين المذبح وبهرة الكنيسة، قطعًا قطعًا وضعوها في جيوبهم؛ وأقاموا امرأةً عاهرة فوق سدة البطريرك جعلت تغني أغنية وقحة. وقد داسوا الكتب والأيقونات المقدسة، واغتصبوا الراهبات، وشربوا النبيذ المعد للمذبح من الكؤوس المقدسة". وأرغم الباب غوريغوريوس التاسع (1227- 124) الملك فريدريك على استئناف حرب صليبية جديدة، وأنزل الحرم الكنسي فيه لأنه لم ينفذ أوامره فورًا، ثم رفع الحرم عنه بعد أن رد إليه المقطاعات التي أحتلها، ثم أنزل الحرمَ فيه مجددًا. و"عام 1365، تمت أخر الحملات الصليبية الدولية التي لم يكن لها من غاية إلا نهب مدينة الإسكندرية التي كان معظم سكانها مسيحيين. فقتل عديدون منهم مثلما قتل يهود ومسلمون كثيرون، بل حتى التجار اللاتين نهبت منازلهم ومخانهم (جونسون نفسه).
وكذلك منح البابا سكتُس الخامس Sixtus V (1585 – 159) كل فرنسي يثور ضد الملك هنري الرابع غفرانًا وهميًا للخطايا مدة تسع سنوات من العذاب المطري، وذلك بالرغم من الانتفاضة البروتستانتية على المتجارة البابوية بالغفرانات؛ ودفع إلى ملك إسبانيا، فيليب الثاني، مبالغ طائلة سنويًا من مال الكنيسة ليُساعدهَه في حربه ضد إنكلترا. وهكذا أشعلوا الحروب وارتكبوا المجازر مُنكرين مآربهم الشخصية ومطامعهم السياسية والاقتصادية بالأقنعة الدينية.
تناخُرُ البابوات وسلوكُهم الشائن
كان السيد المسيح سيد المجد الروحي لا الدنيوي. فلا المال غرة, وزلا عرشُ الأرض أجتذبه. ولا شهواتُ الجسد فتنته. فقد عاش متواضعًا، عفيفًا، متقشفًا، زاهدًا. من وصاياه: "لا تجمعوا لكم كنزًا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ كل شيء، وينقبُ اللصوصُ ويسرون؛ بل اجمعوا لكم كنوزًا في السماء حيث لا يُفسد السوسُ والصدأ أي شيء، ولا ينقبُ اللصوص ولا يسرقون. فيحثُ يكون كترك يكونُ قلبك" (متى 19:6 – 21)؛ "لا يقدرُ أحدٌ أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغضَ أحدهما ويحب الآخر، وإما أن يتبع أحدهما وينبذ الآخر. فأنتم لا تقدرون على أن تخدموا الله والمال" (متى 24:6).
إن كثيرين من البابوات ومعاونيهم من الأساقفة كانوا يسلكون السلوك الشائن الفاضح، ويتناحرون على المناصب الكنسية طمعًا بالسلطة والجاه والمال، ويرتكبون القبائح والمظالم الرهيبة باسم المسيح النفي. نذكرُ، على سبيل المثال، أن البابا إسطفانُس السادس Stephen VI( 896 – 897) أمر باستخراج جثة خصمه البابا فورموز Formous(891 – 896)؛ وبعد أن حاكمها مواجهة في ما سمي بـ"المجمع الجيفي"، قطع بعض الأصابع من يد الجثة جزاءً، وأمر برميها في مقابر الغرباء العمومية حيث التقطها الجمهور المذعور، وألقى بها في نهر التيبر (فغي كانون الثاني/ يناير 897). وقد قبض أنصار فورموز على إسطفان السادس وزجوا به في السجن، ثم خنقوه فيه. واعتلى لاون الخامس LeoV (903) السدة البابوية حوالى شهرين، ثم قبض عليه كاهنٌ اسمه كريستوفر Christopher فسجنه، واحتل العرش البابوي مكانه (904-903). وإذ انتخب، في الظرف نفسه، أنصارُ إسطفان السادس بابا معاكسًا آخر هو سرجيوس الثالث Sergius III (904 – 911)، فقد اعتقل هذا الأخيرُ منافسهُ كريستوفر، ثم أمر بقتله وقتل ضحيته البابا لاون الخامس في السجن نفسه.
وطوال ذل العهد الأسود كانت ثيودورا Theodora، زوجةُ ثيوفيلاكتُس Thephylactus زعيم الأرستقراطية الرومانية، وابنتاها العاهران ثيودورا وماروزيا Marozia، هنَّ المتحكمات بالجالسين على العرش البابو. وكان من جملة أحظياء هذه الأخيرة البابا يوحنا العاشر (914 – 928)، والبابا إسطفان السابع (929 – 931) اللذان سجنتهما، ثم أمرت بقتلهما بعد اختلافها معهما. وعلى أثر فتكها بالأخير، نصبت على العرش البابوي ابنها يوحنا الحادي عشر (931- 935). وإذا توفي زوجها، حاولت تنصيب عشيقها الحديد، هبوغ Hugh إمبراطورًا بمعونة ابنها البابا؛ فثار ألبريك الثاني Alberc II، ابنها الآخر، وزج بها وبأخيه البابا في السجن ثم قتلهما.
واغتصب بونيفاس السابع (984 – 985) العرش البابوي، بعد أن اعتقل البابا يوحنا الرابع عشر لكن بونيفاس سرعان ما قبض عليه فسُجن، ثم قتيل وجررت جثته في شوارع روما.
وقد تحولت الكنيسة الرومانية في عهد البابا سكستُس الرابع Sixtus IV (1471- 1484) إلى مؤسسة دنيوية فاسقة رهيبة يديرها كرادلة ينتمون إلى أسرة البابا، لا عمل لهم إلى نسج المؤامرات وإثارة الحروب واحتلال المدن والمقاطعات لتوسيع ممتلاتهم، وتبديد أموال الكنيسة على مصالحهم الشخصية. وقد مات الكردينال بيار ريارو P.Riaro، ابن شقيقة البابا مستنزف القوى من جراء استسلامه للرذائل. وكان أخوه أردأ سيرةً منه. ولكي يستطيع البابا أن ينهض بنفقات أنسبائه الباهظة، رفع أسعارَ الغُفرانات الوهمية للخطايا وأثمان الرتب الكنسية. ولعل في ما كتبه ستيفانو إنفسُّورا Stefano Infessura، أمين سر مجلس الشيوخ الروماني في معاصره البابا سكتُس الرابع ما يوضح تألم الشعب من حكم المفاسد والمظالم في الدولة البابوية. قال: "كان يومًا سعيدًا يوم مماته، إذ أظهر الربُّ الكلي القدرة قوته في إنقاذ الشعب المسيحي من مساوئ هذا الحاكم الفاسق الظالم الذي كان يجهل خوف الله، ويخلو من أي ميل لرعايةت المسيحيين، ولم تخالجه شفقةٌ ولا محبة، إنما كان بكليتهن مطية لشيطان الشهوانية الفاجرة وجشع المال وعشق البذخ والمطامع الباطلة.
وكان البابا إنوسنت الثامن Innocent VIII (1484 – 1492) والدًا لابني زنًى. وقد منح الكردينالية لابن أخيه، ولد زنًى أيضًا. وهو لم يعنَ إلا بمصلحته ومصالح أسرته المادية؛ وفي أيامه غاض الفاتيكان في بحر من الدعارة والمفاسد الخلقية. وقد أصدر أمرًا بأن كل من يقتل هرطوقيًا يرثُ ممتلكاته ويحصل على مغفرة ما اقترفه من خطايا. وقد شارك في الاضطهاد الكهنةُ والحكام.
وتابع البابا ألكسندر السادس (رودريغو بورجيا) Radrigo Borgia Alexander سيرة الرذيلة بالغًا أقصاها مثلما تابع تبديد أموال الكنيسة ليسد بها نفقات أُسرته على ملذاتها. وحاك المؤامرات، واغتصب الولايات والمقاطعات ليهبها أولاده. وقد أحرق الراهب الدومينيكي سافونارولاً Savonarola (1452 – 1498( حيًا لأنه انبرى يدعو الناس إلى التوبة منددًا بحياة الفساد التي تفاقم شرها في الأسرة البابوية والسلطة الكنسية. كذلك أحرق معه الراهبين الدومينيكيين سلفستر Sylvester ودومينيك Domenico
وقد عمد البابا يوليوس الثاني Julius II (1503 – 1513) الملعب بالرهيب لانهماكه الدائم في الحروب، ولاون العاشر Leox (1513 – 1521) إلى زيادة بيع صكوك الغفران الوهمي من الخطايا، خادعين السذج ليجمعا منهم ملايين الدنانير لبناء ضريحيهما الفخمين، وتزيين قصورهما وكنائسهما، والإنفاق على ملذاتهما.
"محاكمُ التفتيش" الجهنمية
من أقوال المسيح: "من قال لأخيه" "يا جاهل"، استوجب حكم المجلس؛ ومن قال له: يا أحمق، استعوجب نار جهنم"، (متى 1:7). كذلك: "لا تدينوا لئلا تدانوا" (متى 1:7).
لكن بابوات العصور الوسطى أقاموا "محاكم تفتيش" Inquisition لم يكن لها من المحاكم الحقيقية. سوى الاسم. فقد كانت وسيلة جهنمية لهم وللأساقفة والرهبانيات الإرهابية ومن ناصرهم من أصحاب السلطة السياسية للتخلص من خصومهم الدينيين والسياسيين، بل مخالفيهم في تأويل الكتاب المقدس، وللاستيلاء على أملاكهم. وكانت مُلاحقةُ هذه المحاكم موجهةً، أصلاً، ضد "الهرطقة"، أي المسيحيين الخارجين عن العقيدة الرومانية الكاثوليكية وفق تشكلها بعد مجمع نيقيا، عام 325. لكنها، في الواقع، تعدت هؤلاء لتشمل أيضًا اليهود والمسلمين بإسبانيا، والمتهمين بتعاطي "السحر" المزعوم، والأعداء السياسيين والفكريين في كل منطقة يُسيطر عليها النفوذ البابوي.
أما طرق المحاكمة وأصولها فقد كانت مأساة المآسي ومهزلة المهازل. فالأسقف أو رئيس المحكمة المحلية المكلف كان مطلق الصلاحية في اتهامه الناس. وكان يقبل شهادة المجرمين من لصوص وقتلة وشاهدي زور... ومع ذلك لم يكن مسموحًا للمتهم بمواجهة الذين شهدوا ضده أو بمعرفة أسمائهم. علاوةً على ذلك، حُرِّمَ على المحامين، بصورةٍ عامة، مساعدةُ المتهمين. وكان المتهمون يخضعون لأقسى أنواع العذاب ليعترفوا بالذنب الذي تريد المحكمة أن يعترفوا به؛ وهيهات أن يسلموا بعد اعترافهم. ومن فنون العذاب الضربُ المبرح بالسياط، والضغط على الأيدي والأرجُل حتى تحطم العظام، ورفع المتهم بآلة رافعة ثم صدمه بالأرض، والكي بالجمر إلخ. ذلك فضلاً عن الصيام الإكراهي وحرمان النوم والقيود الدائمة التي تمتد أحيانًا بضع سنوات.
أما الأحكامُ فكانت إحراق المتهم حيًا أو سجنه مؤبدًا، هذا إذا لم يمت من جراء التعغذيب والتنكيل. وكانت أملاكه تصادر، وتحرم عائلته من أي إرث. بل إن ما سموه بالـ"مكتب المقدس" كان يأمر بنبش جثث الذين يشك في هرطقتهم مكمن ماتوا دونما محاكمة، فتوضع عظامم وبقاياهم على المسامير وتجرر في الشوارع، ثم تحرق.
وقد بدأ اضطهادُ السلطة الكاثوليكية الجدي للمسيحين الذين يأبون التعامي عن القبائح والفضائح التي تحدث في قصور البابوات أو الذين لا يخضعون لأوامرهم ومبادئهم الدينية والسياسية، في أوائل القرن السابع للمسيح. لكن محاكم التفتيش الرهيبة ترقى نشأتها إلى أواخر القرن الثاني عشر. ففي سنة 1179، قرر البابا ألكسندر الثالث، في مجمع لاتران Latran، وجوب التصدي "للهراطقة" بقوة السلاح ومصادرة ممتلكاتهم، واستعبادهم. وفي 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1184، أصدر البابا لوسيوس الثالث Lucius III، في مجمع فيرونا Verona، دستورصا يُمكن اعتباره الأصل التأسيسي لمحاكم التفتيش الأسقفية.
واستخدمت السلطت البابوية عدة منظمات "رهبانية" لمساعدتها في مهمتها، من بينها الدومنيكان والفرنسيسكان والواعظون.
وفي القرنيني الثاني عشر والثالث عشر نشطت، في عدة مناطق من أوروبا، جماعات كثيرة ممن يؤمنون بأن العالم المادي كله شر، وعلى الإنسان أن يحرر نفسه من قيود المادة ليستطيع أن يستعيد طبيعته الخيرة ويتحد بالله الذي انفصل عنه. وقد لاحظوا انحراف الكنيسة الرومانية عن أهداف المسيح، فكانوا يتقشفون ممتنعين عن الجماع، وقد نظموا أنفسهم، وأقاموا لهم أسقفيات خاصة. فكان الكاثاريون Cathari، وهم من أبرزهم، الضحايا الأوائل لـ"محاكم التفتيش"، إذ أحرق حيا أو وُئد الألوف منهم في أوروبا، ولا سيما في فرنسا وإيطاليا وألمانيا بين سنة 1233 و1278. ثم توالت المجازر الرهيبة، وكان من أبشعها تلك التي حدثت في فرنسا، في عهد الملك فيليب له بل Philippe le Bel ، إذ أوقف، في 24 آب سنة 1307، أعضاءُ الجمعية المعروفة بـ "فرسان الهيكل" Le chevaliers du Temple" في جميع الأراضي الفرنسية، ثم أحرقوا أحياء، بعد أن قضى كثيرون منهم في السجون من التعذيب. كذلك في عهد فرانسوا الأول FrançoisI, قتل ألوفٌ من المسيحيين الفودوا Vaudois (جنوبي فرنسا) سنة 1545. على أن أرهبَ "ماكم التفتيش" هي تلك التي عرفتها إسبانيا، لا يما في عهد رئيس الدير الدومينيكي توركيمادا Torquemada، إذ قُضي على ألفي شخص في مدة أربعة عشر عامًا (1484 – 1498). وقد داومت "محاكم التفتيش" الكاثوليكية حتى القرن التاسع عشر على إرسال خصوم البابوية إلى المحرقة.
ولم تكتف البابوية والأجهزة التابعة لها باضطهاد العاديين، بل تعدتهم إلى اضطهاد المصلحين والمفكرين والعلماء، بحيث أظهرت نفسها أنها عدوةٌ لكل إصلاح سياسي واجتماعي أو تحرر فكري أو تقدم علمي. فمن العلماء الذين حاربتهم: كوبرنيك Copernicus (1473 – 1543)، وهو عالمٌ فلكي بولوني برهن على دوران الكواكب السيارة حول نفسها وحول الشمس، فحكمت البابوية على نظريته بالطلان، زاعمةً أنها ضد الحقائق الدينية. وغاليليه Galieli (1564-1642)، وهو عالمٌ إيطالي في الرياضيات والفيزياء والفلك؛ فقد أجبر وهو في السبعين من عمره على أن يركع أمام "محكمة التفتيش" الكاثوليكية، وينكر تأكيده لصحة نظرية كوبرنيك حتى ينجو من عقاب الموت بإحراقه حيًا؛ ففعل ما أكرهوه عليه وهو يقول: "ولكنها ]أي الأرض[ مع ذلك تدور" (E pur si muove). وقد أمضى بقية حياته في إقامة جبرية شبه سجين. كذلك أحرق الفيلسوف الإيطالي برونو G.Bruno حيًا، سنة 1600، بتهمة الهرطقة. وأحرق الفيلسوف الإيطالي الآخر فانييني Vanini حيًا أيضًا، سنة 1619، بتهمة السحر المزعوم والإلحاد. وكانت السلطة البابوية قد أصدرت اللائحة الأولى للـ"كتب المحظورة" Index Expurgatorius. وأتبعها، سنة 1564، بلائحة أوسع. ثم دأب "مجمع الحظر" التابع لها على تحريم كل كتاب لا يروقها منذ سنة 1571 حتى سنة 1917. ثم أخذ يقومُ بهذه المهمة ما سموه بالـ"مكتب المقدس".
وكان عددُ ضحايا "محاكم التفتيش" عظيمًا. فوفق شهادة جون أنطونيو لورنته /Llorente، الذي كان يشغل منصب أمين سر محكمة التفتيش في مدريد في أثناء سنوات الثورة الفرنسية (1789- 1791)، بلغ عددهم في إسبانيا وحدها حوالى ثلاثمئة وخمسين ألفًا، بينهم 31912 شخصًا أحرقوا أحياء. أما المتهمات بالسحر فقدر عددهن بثلاثمئة ألف، بينهن مئتا ألف في ألمانيا وحدها.
دحضُ مزاعمِ البابوية لخلافة بطرس الرسول
إستند البابوات، بعد مجمع نيقيا في ادعائهم خلافة بطرس الرسول ثم خلافة المسيح نفسه، إلى قول سيد المجد لبطرس الرسول: "أنت حجر، وعلى هذا الحجر سأبني كنيستي (جماعتي)... وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما تربطه في الأرض يكون مربوطًا في السماء، وما تحله في الأرض يكونُ محلولًا في السماء" (متى 16: 18- 19).
لكن الموقف الداهشي المستند إلى الوحي يدحض ادعاء الخلافة، وله تفسير خاص لمعنى "الحجر" لا مجال لتفصيله في هذا البحث:
أولاً، كان المسيح يخاطب بطرس قصرًا، بل يخاطب السيال الروحي الأعلى فيه. وبرهان ذلك أنه، بعد أن أعلم المسيحُ تلاميذه أنه سيضطهد ويعذب، "انفرد به بطرس وأخذ يعاتبه فيقول: لا سمح الله، يا سيد! لن تلقى هذا المصير! فقال لبطرس: ابتعد عني، يا شيطان! أنت عقبة في طريقي، لأن أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار الله" (متى 22:16 – 23). والواقع التاريخي أكد ذلك، إذ أنكر بطرس معرفته للمسيح ثلاث مرات. ولو تجرأ وأكد معرفته له وشهد لمصلحته، لكان سيرُ المحاكمة تغير، وفق ما أكد لي مؤسس الداهشية. أما غفران الخطايا فلا يكون نظريا، بل يتأكد بشفاء إعجازي من علةٍ تكونُ نتيجة لخطايا اقترفها المعلول في حياته الحالية أو السابقة، وهو هبة لم يقصرها المسيح على بطرس الرسول. فوفق المفهوم الداهشي ظهرت شخصية المسيح العلوية لتلاميذه، بعد الصلب، لأن الموت لا يقوى عليها، وكانوا مجتمعين في غرفةٍ مقفلة الأبواب، فقال لهم بعد أن نفخ في وجوههم: "خذوا الروح القدس. من غفرتم له خطاياه تغفر له، ومن منعتم عنه الغفران يمنعُ عنه" (يوحنا 19:20 – 23). وهذا يؤكد أن الروح القدس هو الذي يغفر الخطايا (بصنُع معجزات شفائية مثلما فعل المسيح) لا البابواتُ ولا الكهنة، ولا أي إنسان آخر. ومع ذلك لم يخبر عن أحد منهم أنه صنع معجزة إلا بطرس الذي زوده المسيح بقوة روحية يعرف الداهشيون كنهها، وبولس الذي رافقه يسوع متخفيًا وكان يصنعُ المعجزات، فتنسب لبولس.
ثانيًا، في الموقف الآنف ذكره خاطب المسيح تلاميذه قائلاً: "مَن أراد أن يتبعني، فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يخسرها، ولكن الذي يخسر حياته في سبيلي يجدها. وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟" (متى 16:24-26) فإذا تفحصنا سير البابوات، في القرن الوسطى، لوجدنا أكثرها على نقيض تام مما يريده المسيح؛ إذ كانوا يحوكون المؤامرات بعضهم ضد بعض، ويقترفون الجرائم، ويوقدون الحروب، وينغمسون بالشهوات من أجل ربح العالم ومغرياته واقتناء الثروات الطائلة. فأي إنكار للنفس في تلك السير؟!
ثالثاً، كيف يدجعي البابوات حق خلافتهم لطرس الرسول، وهو لم يدع حق الرئاسة في التشريع للكنيسة وإدارتها، ولا عين خليفة له. فبولس الرسول ظل متفردًا في تصرفه ونشر التعاليم المسيحية وتأسيس الكنائس بروما وغيرها، حتى إنه أنبَ بطرس علنصا في رسالته إلى غلاطية لأن بطرس كان ميالاً إلى قصر التبشير على اليهود دون بسطه إلى الرومان مثلما فعل بولس (11:2 – 14). وهذا رأيٌ يتفق عليه كثيرٌ من مؤرخي الدين المسيحي حتى الكاثوليك بينهم.
رابعًا، خلال القرون الثلاثة الأولى لم يكن أسقف روما وحده المعترف به رأسًا للكنيسة، فقد كان ثمة نوع من الاستقلالية في القرنين الأولين ونزاعٌ على السلطة في القرن الثالث. أما كيف ولماذا سيطرت كنيسة روما، وبعدها كيسو القسطنطينية (بعد نقل العاصمة الرومانية إليها) على سائر الكنائس، فأسبابُ ذلك معظمها سياس، فضلاً عن كثرة الشهداء الذين سقطوا في عاصمة الإمبراطورية.
العقاب الإلهي الرهيب
بعد مؤتمر نيقيا كرس البابوات أنفسهم خلفاء لطرس الرسول، بل للمسيح نفسه، بل جعلوا أنفسهم خلفاء لله تعالى، وأخذوا يحلمون، مع كرور الأعوام، بدمج السلطة الدينية بالسلطة السياسية بحيث تصبح الإمبراطورية الرومانية العظيمة تحت سلطانهم. لكنهم لم يكونوا يعلمون ماذا تخبئ الأقدار التي صاغوها بأعمالهم الدنيوية وشهواتهم الجسدية من عقاب رهيب. فعام 395 مات ثيودوسيوس Theodosius، بعد أن كان قد أعلن المسيحية الكاثوليكية دين الدولة الرسمي، عام 380، وحظر وقمع كل ما عداها. وإذا بروما التي انتصرت فيها المسيحية المنحرفة سياسيًا وخلقيًا ودينيًا معدة لغزوها وخرابها. فجازاها الله بتسليطه عليها البرابرة الذين كانوا قد اعتقوا المسيحية الآريوسية القائلة بوحدانية الله؛ فاجتاحها القوط الغربيون سنة 410. وما كانوا ليدخلوها لو لم تستحق العقاب الإلهي، ولو لم تتهيأ للغزاة السبل من ضعف حكامها وشعبها الخلقي، ووهن اقتصادها، وفوضى سياستها، واليأس الذي بدأ يتسرب إلى نفوس قاطنيها. وتبعت القوط موجات بربرية أخرى اجتاحت مدن الشرق والغرب حيث كان للرومان سلطان. وكانت أشرس تلك الحملات حملةُ الهون Hun التي قادها أتيلا Attila، الملقب بـ"غضب الله، في أواسط القرن الخامس. وبعد موت ثيودوسيوس لم يبق من الإمبراطورية الرومانية إلا قسمها الشرقي الذي اقتصر عليه اسم بيزنطيا، بعد أن كان يشمل الإمبراطورية كلها. وسرعان ما مشت بيزنطيا على خُطى روما في الانقسامات الدينية والمفاسد الخلقية؛ لكن سيرها نحو الهاوية كان أبطأ، بحيث إن مشيئة الله قضت عليها بالزوال تدريجًا، بتقطيع أوصالها شيئًا فشيئًا.
ثم حلت الضربة الإلهية الثانية. فبعد حوالى عامين من وفاة الرسول العربي الكريم، انطلقت جحافلُ العرب المسلمين شمالاً ليحتلوا منطقة واسعة من بريزنطيا، تشمل سوريا بما فيها دمشق وفلسطين بما فيها أورشليم (638). وبعد احتلالهم بلاد الفرس، غزوا مصر واحتلوا الإسندرية (642) حيث ناصر الأقباط المسيحيون العرب ضد الكنيسة اليونانية الكاثوليكية. وفي الشرق تقدم العرب على طول الشاكئ إلى ليبيا (647)، ثم إلى قبرص (649) ورودس (654) وصقلية (652). وهكذا خسرت بيزنطيا وسلطتها الكنسية مدنها كلها على ساحل البحر المتوسط. لكن موجات الفتوح العربية لم تقف عند هذا الحد، بل تقدمت إلى أرمينيا (653). وعام 683، وصل العرب إلى المحيط الأطلسي في شمال إفريقيا. ثم تبع فتحُ إسبانيا عام 711، وأقيمت الإمارةُ الأموية في قرطبة سنة 756. زد إلى ذلك احتلال ديارٍ كثيرة داخل آسيا لم تصل إليها جيوشُ الرومان في أوج سؤددهم. إن العدالة الإلهية أخذت مجراها، فاقتصت شر اقتصاص من المسيحيين البيزنطيين ورعاتهم الدينيين، لأنهم خرجوا عن تعاليم سيد المجد الذي ادعوا أنهم خلفاء له، وكان خروجهم بسلوكهم المنحرف عن القيم الروحية كما بالتزامهم تعاليم جديدة أدخلت على وحدانية الله! ومثلما سمحت العدالةُ الإلهية بأن يتسلط البرابرة الآريوسيون القائلون بوحدانية الله على قسم كبير من الإمبراطورية الرومانية، عادت فسمحت بأن يتسلط المسلمون القائلون بوحدانية الله على قسم كبير من الإمبراطورية البيزنطية. ثم حدث الإنشقاق الكبير بين كنيستي الشرق والغرب عام 1054، بعد أن اختلفنا في أمور تتعلق بالعقيدة والممارسة الكهنوتية. وحرمت كل منهما الأخرى معتبرة إياها منحرفة. وهكذا ضعفت المؤسسة المسيحية بالانشقاق والتنازع.
وبعد تهديد السلاجفة الأتراك لبيزنطيا، بدأت الحملاتُ الصليبية. لكن ماذا كانت نتائجها؟ إنتهت الحملة الصليبية الثانية بهزيمة شنعاء في أواسط القرن الثاني عشر. وسنة 1187، أباد صلاح الدين الأيوبي معظم الجيش الأوروبي في معركة حطين. وفي 2 تشرين الأول من العام نفسه استعاد مدينة القدس ومعظم المعاقل الأوروبية الأخرى. وفي الحملة الثالثة اضطر ريتشارد (قلبُ الأسد)، بعد عجزه عن فتح القدس، إلى إبرام معاهدة سلام لخمس سنوات سمح فيها صلاح الدين للحجاج المسيحيين بزيارة الأماكن المقدسة. وعام 1212، جرت حملةُ الصبيان التي عباتها حماستُهم المتهورة وطاعتهم العمياء للبابا، فقضى فيها أو فُقِدَ أو استعبد الآلافُ منهم. والحملتان الخامسة والسابعة على مصر أخفقتا. أما الحملت الثامنة فقادها الملك لويس من جنوبي فرنسا، وحط بجنوده في تونس لاسباب غير واضحة؛ فقضى هو وابنه ومعظم جنوده بالأمراض الفتاكة.
وعمَّ وباءُ الموت الأسود أوروبا بين 1347 – 1400 مبيدًا حوالى ثلث شعوبها، غير عافٌ عن الملوك وأسرهم أو رجال الدين، حتى أصبحت أوروبا مقبرةً جماعية. وستكونُ الضربةُ اللاحقة، لا الأخيرة، الانتفاضة الإصلاحية البروتستانتية.
أكد مؤسس الداهشية أن الحقيقة اغلروحية هي في ذات الله تعالى، ويستحيل أن يدركها إنسان مهما بلغ سموه؛ فا دعاء احتكار الحقيقة المطلقة باطل. كذلك أكد أن التعاليم الدينية تُعطى البشر وفقًا لمستويات مداركهم وطبيعة بيئاتهم في الأزمنة التي تُبعثُ فيها الأديان؛ فكل مؤمن يحاسبُ وفق تعاليم دينه. وشدد على أهميةت العقل الحر مستنكرًا الطاعة العمياء، مؤكدًا أن من يخونُ عقله يخون خالقه، لأن العقل قبس منه، موضحًا أن ممارسة القيم الروحية هي الجوهرُ في كل دين، رافضًا الإرهاب ردًا على أي اعتداء، معتبرًا أن الوسيلة جزء من الغاية، فإذا فسدت، أفسدت الغاية معها. وبعد ستين عامًا فصل هذه المبادئ د. تشارلز كمبول، أستاذ تاريخ الأديان المقارنة في كتابه البارز "عندما يُصبحُ اغلدين شرًا".
"من أراد أن يتبعني، فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يخسرها، ولكن الذي يخسر حياته في سبيلي يجدها. وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟"
السببية الروحية في مجرى الأحداث العامة (9)
الإسلام: صاحبُ الرسالة وعقيدته
البعثة الإسلامية وصاحبها
في العقيدة الداهشية أن الأنبياء والهُداةَ الروحيين تحييهم سيالاتٌ روحية مختلفة الدرجات؛ وهذا يتفق مع الآية القائلة (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) (الإسراء55). لكن تلك السيالات تعودُ جميعها إلى كيانٍ روحي واحد. فكلما يجفُ نسغُ الحياة في المؤمنين التابعين لغصن الهداية الممتد إلى الأرض من الشجرة الروحية الإلهية، يمتد بديلاً عنه غُصنُ هدايةٍ آخر لقومٍ آخرين. وهذا المبدأ يؤكده القرآن الكريم بآيتين مترابطتين ترابط السبب بالنتيجة: "الأولى (ولكل أمة أجلٌ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون) (الأعراف 34)، والثانية (ولكل أمة رسولٌ، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) (يونس 47).
ولد محمد يتيمًا سنة 570/ 571 م على ما يرجح المؤرخون. وماغ إن بلغ السادسة حتى ماتت أمة؛ وبعد سنتين، توفي جده عبد المطلب الذي كان يكفله، فرعاه عمه أبو طالب. لكن اليتيم الذي كانت حاله أقرب إلى العسر منها إلى اليُسر، مع انتمائه إلى أسرة عريقة النسب، سرعان ما اختبر عيشة العرب باديهم وحاضرهم. فعمل في صباه برعي غنم ذويه وغنم أهل مكة، وكان يفتخر بعمله. فأحبهن كل من عرفه، وسموه "الأمين".
وفي الخامسة والعشرين من عمره بدأ عمله في التجارة لخديجة بنت خويلد، ذات المخال والشرف. فأعجبت بذكائه وأمانته وحميد خصاله، وأحبته. وسرعان ما تزوجا؛ علمًا بأنها كانت تزيده خمسة عشرَ عامًا، وقد تزوجت مرتين. فولدت له القاسم وعبد الله اللذين ماتا طفلين قبل انبعاث الدعوة؛ كذلك ولدت له من البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وفاطمة. لكن محمدًا لم يلبث أن اعق عبدًا كانت خديجة قد اشترته وتبناه، وهو زيد بن حارثة الذي أصبح يدعى زيد بن محمد.
كل ذلك والعهد عهد الجاهلية، عهد الفوضى الخلقية وانعدام الوازع الاجتماعي والشرائع المدنية وتحمل المسؤولية؛ عهد العصبية القبلية والشائرية والطبع الفخور بالـ"أنا" التي أدى تضخمها إلى الافتخار بالآباء والأجداد، ونصره الأخ أو القريب أكان ظالمًا أم مظلومًا، وإيثار المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. كل تلك الخصائص السلبية للجاهلية وما يستتبعها من اعتداءات غير مسؤولة على الآخرين في أجسادهم وممتلكاتهم كانت تطبع العرب بصورةٍ عامة والبدو منهم بصورة خاصة.
سنة 610م، فيما كان ملكوتُ المسيح الروحي الحق قد بدأ بالأفول من الأرض متحولاً إلى مملكة سياسية عسكرية دنيوية في روما، بعد انهيار مجد الإمبراطوريو وتجزيئها، وبينما كان الدين المسيحي قد انحرف عن منبعه النقي متفرعًا إلى بدعٍ شغلتها المنازعات والمجادلات العقيمة في بيزنطيا التي أخذ الضعف يدبُّ في أوصالها، كان الوحي الإلهي يتنزلُ على محمد بن عبد الله في شبه جزيرة العرب. وهكذا انفتحت كوةٌ جديدة من السماء، وانهمر جدول ماء حي يخصبُ الصحراء العربية بحضارة أقفرت منها بلادُ العمران آيات وحي كريمة نزلها روح جبريل متقطعة، مدى ثلاث وعشرين سنة، فتكون منها القرآن الكريم كتابصا مقدسصا مصدقًا لما قبله من التواراة والإنجيل، ومقومًا وموضحًا ما حرفه المبتدعون، ومهدمًا ومسفهًا معتقدات الوثنيين والمشركين، وداعيًا إلى تنزيه الله وعبادته ربًا أوحد للعالمين، وناهيًا عن المنكر، ومرغبًا في الخير والمعروف.
ذلك الأمين الصادق، بعد أن أتاهُ الوحي لمامًا في العام الأول من التنزيل في غار حراء (شمال شرقي مكة) حيث كان يتحنث، انقطع عنه زمنًا قارب السنوات الثلاث حتى ساوره القلقُ والخوفُ من أن يكون رب السماء قد خذله؛ لكن الروح الملائكي عاوده، بعد طول غياب، مكلفًا إياه تبليغ الرسالة الروحية الجديدة التي شرعت تعاليمها بالنزول: (يا أيها المثر، قم فأنذر) (المدثر 1 – 2). هذا الحدث الروحي الذي بدا همسة في غار، وانتهى دويًا راعدًا في المعمور والأقفار، ما كان ليحدث لو لم تكن وراءه أسباب روحية تدفعه وتطوره ابتغاء الوصول إلى هدف رسمته اليد الإلهية. فكأن البيئة المشابهة لعوسجة تثمر ثمرًا طيبًا، أو الظلمة يطلع قلبها شمسًا نورها يؤثر في معظم الأحداث التي مت في التاريخ بعد طلوعها؛ وتلك هي المعجزة!
كان النبي الكريم في الأربعين من عمره لما أطلق دعوته. وكانت السيدة خديجة أولى المؤمنات، وعل، ابن عمه أبي طالب، ابن العاشرة، أول المؤمين؛ فكانا يخرجان إلى شعاب الجبل القريب فيختليان ويصليان. وبعد علي آمن زيد بن حارثة الذي تبناه الرسول الكريم. وبعد الآثنين آمن أبو بكر الذي كان في الثامنة والثلاثين من عمره، وقد سمي بالصديق من أجل أسبقيته بين الرجال؛ وعغلى يديه أسلم عثمان بن عفان (34 سنة)، وعبد الرحمن بن عوف (30 سنة)، وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، ابن عمة الرسول (كل منهم 10 سنوات). هؤلاء وجماعة من المستضعفين والعبيد والموالي، مثل عمار بن ياسر وبلال الحبشي كانوا النواة التي بنيت عليها الجماعة الإسلامية الأولى.
إن دور الصبية القبلية بالنسبة للبعثة الإسلامية كان مزدوجًا. من جنة مكنت خصومها من محاصرتها، فلم يتجاوز عدد من أسلموا، في المرحلة المكية التي امتدت 13 سنة، 154 شخصًا، منهم 83 مؤمنًا هاجروا إلى الحبشة؛ ومن جهة أخرى أمنت العصبية القبلة حماية صاحب الدعوة وشيوخ القبائل والعشائر فمن أسلموا مع ذويهم
لكن القرآن الكريم دعا إلى الانتقال من الرابطة القبلية والعشائرية إلى الرابطةت العقائدية الروحية رابطة "الأمة" (أي الجماعة ذات القصد الروحي الواحد والاتجاه السلوكي الواحد): (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون) (آل عمران 104). وفي هذا التبديل الخلقي الاجتماعي العقائدي تحطيم للقيود التي أثقلت كاهل العرب، باديهم وحاضرهم, مدى قرون, فجعلهم طبقات: أسياداً وموالي وعبيداً, أغنياء وصعاليك, أمجاداً ووضعاء, ذوي حسب يفتخر به, وذوي نسب يهان؛ وهي تصنيفات بينها حواجز أشبه بتلك التي كانت قائمة بين الطبقات الهندية, إذ ظهر بوذا وحاول تحطيمها. وهذا التحطيم للقيود الاجتماعية المزمنة جعل مشركي قريش يزعمون أن اتباع الفقراء للديد الجديد انتقاص من قيمته وصدقيته. لكن هذه الثورة السلمية في منطقة انتشر فيها الشرك والوثنية كان لا بد من أن تلقى مقاومة عنيدة, لأنها شكلت خطراً على قواعظ وعادات وأعراف وامتيازات اقتصادية واجتماعية, فضلا عن دينية, رسختها القرون. ولذلك أوحي إلى الرسول العربي الهجرة إلى المدينة حيث ستعظم قوته وتكتمل رسالته.
كان النبي الكريم إمامًا عظيم الخلق والشخصية، وكان للـ "أمة" الإسلامية فيه (أسوة حسنة) (الأحزاب 21). إمام لطيف لا يتعالى على أبتاعه، بل يتضع لهم ويشاورهم في أموره، وسيد يشعر مواليه وخدمه أنهم غير أذلاء، بل هم بمنزلة الأبناء، إذ هو لا يحملهم أكثر مما يطبقون، بل يرحمهم ويجاملهم ويضاحكهم. وقد أكد القرآن الكريم مزاياه هذه بعدة آيات؛ منها (واخفض جناحك لمن أتبعك من المؤمنين) (الشعراء 215)؛ كذلك (ولو كنت فظا غليظ القلب، لانفصوا من حولك، فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) (آل عمران 159).
وكان بوسعه أن ينعم بعيشة الملوك المترفة؛ لكنه آثر عيشة الفقراء المتقشفة، فلم يطلب ملذات الحس، بل ابتغى نعيم الروح، وزهد في نعمة العيش مع أنها بين يديه. وكثيرًا ما كان يرقع ثيابه أو حذاءه بنفسه، أو يوقد النار، أو يوقد النار، أو يمسح الأرض، أو يحلب عنزة أسرته، أو يتسوق ما يحتاج إليه.
وكان يزور المرضى، وينضم إلى أي موكب جنازةٍ يلتقيه، ويلبي الدعوة إلى الطعام حتى إن تكن من عبد، بل كان لا يكلف العبد عمل شيء له بإمكانه عمله إذا كان لديه متسعٌ من الوقت. وبالرغم من المداخيل التي كانت ترده، فإنه كان ينفق القليل على أسرته، وأقل على نفسه، والأكثر على الإحسان.
وإلى ذلك كان أبًا كريمًا عطوفًا؛ كما كان صديقًا متسامحًا، طيب المعاملة لزوجاته، رفيقًا معهن، أنيسًا. وقد بقي لا زوجة له سوى خديجة خمسًا وعشرين سنة. وبعد وفاتها، وهو في الخمسين من عمره، تزوج سودة بنت زمعة، ثم هاجر إلى المدينة وهو في الثالثة والخمسين، فاتخذ له تباعًا عدة نساء آثر بينهن إحدى عشرة، ذهبت الأصول التاريخية إلى أن حجرة كل منهن كانت من اللبن وسعف النخل، لا تتعدى مساحتها 14 قدمًا مربعًا، بعلو 8 أقدام، في أرضها حصيرة عليها فراش ومساند، وعلى الباب ستار من شعر أو جلد؛ وقد عُرفن مع خديجة بـ"أمهات المؤمنين". ولم يكن اختيار النبي الكريم لزوجاته، وفق رأي العقاد، بدافع الشهوة، بل كان الاختيار كله "على حسب حاجتهن إلى الإيواء الشريف، أو على حسب المصلحة الكبرى التي تقضي باتصال الرحم بينه وبين سادات العرب وأساطين الجزيرة من أصدقائه وأعدائه؛ ولا استثناء في هذه الخصلة لزوجة واحدة". ويؤكد الشيخ خالد محمد خالد أنه، بالرغم من أن تعدد الزوجات في العصور القديمة لم يكن يثير استهجانًا أو مساءلة، فوراء زيجات الرسول كان هدفُ الإيواء والرعاية والعزاء لنساءٍ مفجوعاتٍ بموت أزواجهن (كحفصة وسودة وصفية)، أو بسبب طلاقهن لعدم التفاهم بينهن وبين أزواجهن (شأن أم حبيبة لاعتناق زوجها النصرانية وهما في الحبشة، وزينب امرأة زيد). وهذا الإيواء الرعوي أكدته الآية القرآنية القائلة (وتؤوي إليك من تشاء) (الأحزاب 51). والجدير بالذكر أن زوجات النبي خيرن بين الدنيا والتقوى، ففضلن العيش في الشظف حتى أيام أفاء الله على المسلمين مغانم؛ وقد نزلت آيةٌ في ذلك (يا أيها النبي، قل لأزواجكَ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلاً وإن كنتن تُردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا).
(الأحزاب 28 – 29). بل إن شظف العيش امتد إلى بيت بنت الرسول (فاطمة الزهراء) التي كانت تساكن زوجهنا الإمام عليًا. فكانت إذا سألت أباها العطاء، أجابها: "لا أعظيك وأدعُ فقراء المسلمين"، ثم يضمها إذ يرى الدمع يترقرق في عينيها، ويطلب إليها أن تسبح الله وتحمده وتكبره كثيرًا.
مبادئ الإسلام الخلقية في السلم والقتال
من الأيام الكريمة: }وأرسل الله إليكم[ (رسولاً يتلو عليكم آياتِ الله مبيناتعٍ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) (الطلاق 11). من هذه الآية يمكن أن نستنتج أن الجاهليين كانوا يعيشون في ظلمةٍ مجازية حقيقية، اجتماعية و عقلية وخلقية. فلا رابط روحي يجمعهم لتشكيل أمة ذات مبادئ واضحة واتجاه معروف، ولا مستوى عقلي يرفعهم لاستشراف بعض حقائق الغيبيات وإنقاذهم من مصير مظلم، ولا أخلاق نبيلة تردعهم عن المنكرات والظلم والعدوان أو تدفعهم إلى الشفقة على الضعفاء والفقراء، وكظم الغضب والعفو عن المسيئين. فإذا الإسلام يحضُ على الرحمة والإحسان والعدل جاعلاً إياها فضائل يجبُ أن يتحلى بها المسلم، مثلما ينهى عن الظلم والعدوان والرذيلة بجميع أنواعها حاثًا المؤمنين على التحاشي عنها: (ألم يجدك يتيمصا فآوى، ووجك ضالاً فهدى، ووجدك عائلاً فأغنى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر) (الضحى 6 – 9)؛ كذلك (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) (النحل 90)؛ و(الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس... والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم... أولئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهم وجناتٌ...) (آل عمران 134 – 136).
وإذْ كان الأعداءُ حول صاحب الرسالة الروحية الجديدة أكثر من الأصدقاء، وقد هبوا لمحاربته، دونما مبدأ أو نظام يحدد قوانين القتال، كان لا بد من الرسول الكريم أن يدافع عن نفسه وعن المؤمنين برسالته. فمنحه الله موهبة القيادة العسكرية والحنكة السياسية، فإذا هو قائد عسكري بطل لا تتدنى مزاياه القيادية عما يتمتع به كبار القادة؛ وسياسي حصيفٌ، ثابقُ البصيرة، وإداريٌّ رشيد حكيم. في تبشيره بالدين الجديد، احترم حرية رأي الآخرين، وخصوصًا أهل الكتاب من نصارى ويهود، فلم يلزم أحدًا باعتناق دينه الجديد، وفي قتاله لم يباشر القتال دونما سبب جوهري وراءه إيعازٌ روحي. ذلك كان موقف الرسول العربي والقرآن الكريم في الجوهر والمبدأ، وفق ما تعلمه الداهشية، ذلك بأن البشر مختلفو المستويات في مداركهم ونزعاتهم، ولا تنفعهم الهداية إلا إذا استوعبوها ولاءمت ما هم فيه من استعدادات، ولذا نزلت أديان مختلفة الشرائع والأنبياء والهداة الروحيين، مع أنها موحدة الجوهر، في أقوامٍ مختلفين مدى التاريخ. وقد أكد القرآن المجيد هذا المبدأ الداهشي بقوله (لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا، ولو شاء الله لجعلكم أمةً واحدة...) (المائدة+ 48)، كما أكد مبدأ احترام دين الآخرين ومبدأ القتال من أجل الدفاع عن النفس فقط بآياتٍ مكية ومدينة؛ من المكية (إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الهل يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) (القصص 56) (قل: يا أيها الكافرون، لا أعبدُ ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد... لكم دينكم، ولي دين(ديني) (الكافرون 1-6)، و(ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن) (النحل 125)؛ ومن المدنية (لا إكراه في الدين) (البقرة 256) و(قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين) (البقرة 256) و(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (البقرة 190).
هذه النزعات الإنسانية التي تحلى بها الإسلام أكدها محققو "السيرة النبوية" لابن هشام، فقالوا في مقدمة "السيرة": "إن سيرة النبي (ص) تنطق بأعظم المبادئ الخالدة التي سبقت مبادئ البشر جميعًا، وسبقت ما يسمى بمبادئ حقوق الإنسان؛ ومبدأ المساواة بين بني البشر، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، وهي بهذا تحارب التفرقة العنصرية بين بني الإنسان جميعًا؛ وأرست، أيضًا، مبدأ احترام العلم والعلماء، والارتقاء بشأن العقل في ظل المبادئ الإسلامية الحميدة. وعلمتنا معنى الشورى، وزرعت في أذهاننا الصورة الحقيقية للعدل والرحمة والحب والإخاء والتضحية من أجل الحق والصمودفي وجه الطغاة المتكبرين".
إن القرآن الكريم لم يخلُ من آياتٍ تدعو إلى القتال، لكنها مقيدة بظروفٍ معينة ذات أسبابٍ روحية. أولى تلك الآيات القائلة: (أذن للذين يقاتلون بأنهم (بسبب أنهم) ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله؛ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعُ وبيعٌ وصلوات (كنائس اليهود، والكلمة عبرية) ومساجدُ يذكر فيها اسم الله كثيرًا...) (الحج 39 – 41). ففي هذه الآية التي نزلت في المدينة، بعد تمادي أعداء النبي الكريم في اضطهاد أتباعه بل في التربص به لإمساكه أو قتله، أعطي الذين "ظلموا" و"أخرجوا من ديارهم بغير حق" بسبب إيمانهم بالله،, إذنًا بالدفاع عن النفس. وهذا الإذن عام مرتبط بسبب روحي يعم الأديان كلها، وهو ضرورةُ الذود عن الإيمان الحق سواءٌ كان في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو غيرها من الأديان التي أشير إليها بـ"صوامع".
ففي اللحظة التي كان الشر يتربص بالرسول العربي على بابه وهو في مكة، أوحي إليه أن يغادرها إلى يثرب، لأن الساعة قد أتت للانتقال إلى مرحلة ثانية من الدعوة، ذلك بأن أبا جهل كان مع اصبة من أعداء الرسول يترقبونه في عتمة الليل للانقضاض عليه وهو نائم، فأوعز الرسول إلى علي في أن ينام على فراشه، ويغطي جسده ووجهه ببرده الأخضر، ثم خرج فالتقط حفنةً من التراب وجعل يذروه على رأس كل من المتربصين به وهو يتلو آياتٍ قرآنية حتى وصل إلى الآية القائلة (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) (يس5). ومضى في طريقه إلى يثرب وهم لا يرونه. ولم ينتبهوا إلى ما كانوا عليه إلا بعد أن مر رجل لا يعرفونه، فسألهم عن التراب الذي على رؤوسهم، وإذ تحسسوه، أكد لهم أن من ينظرونه قد غادر البيت وهم لا يرونه. فكيف حدث ذلك؟ إن هذا الحادث العجيب يستحيل فهمه إلا من خلال الإيضاحات الداهشية المؤيدة بمئات البراهين الإعجازية. فكثيرًا ما كان الروح الملائكي، عند احتلاله مؤسس الداهشية، يضعُ سيالاً روحيًا على شيء ما، كصخرة أو خبرٍ في صحيفة، فيراه بعض الزائرين ولا يراه غيرهم، أو كوضعه سيالاً روحيًا على شخص ما كالدكتور داهش نفسه أيام اضطهاده فيراه أهل البيت الذي كان فيه ولا يراه من يبحثون عنه من زبانية السلطة، أو وضعه سيالاً على آذار بعض الزائرين فلا يسمعون ما يود أن يقوله زائرٌ من غير أن يسمعه الآخرين. كذلك لم يستطع أعداءُ الرسول أن يؤذوا عليًا لأن برد النبي الكريم وضع فيه سيالٌ روحي أيضًا يمنع المهاجمين من إيذاء المتثر به. هذه العداوة المستهدفة قتل الرسول والمؤمنين به اتستوجبت الدفاع الوقائي عن النفس باستباق الأذى الداهم، لأن النيات الخبيثة كانت مصممة على الإيذاء. وهذا التصميم واضحٌ في آيتين من القرآن الكريم. الأولى مكية تظهر التصميم القاتل حتى قبل الهجرة: (أم تقولون شاعرٌ نتربص به ريب المنون. قل تربصوا، فإني معكم من المتربصين) (الطور 30 – 31). والثانية نزلت بعد الهجرة: (وإذ يمكر بك الذيك نفروا ليثبتوك (يقيدوك) أو يقتلوك أو يخرجوك ويمركون، والله خيرُ الماكرين) (الأنفال 30).
لكن في مرحلة متأخرة من البعثة الإسلامية، وبالرغم من وجود آيةٍ تؤكد حفظ الله تعالى لكل ما سبق إنزاله من آياتً، وذلك بقوله سبحانه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر 9)، فقد ضمن القرآن فيما بعد آياتٍ اعتبرها كثيرون من الفقهاء ناسخة لما يناقضها ولا سيما في ما خص قتل المشركين وأهل الكتاب حتى إن لم يباشروا الاعتداء على المسلمين؛ منها (فإذا انسلخ الأشهرُ الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم...) (التوبة 5)، كذلك (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة 29). والفقهاء المسلمون مختلفةن في شرح ذلك. ولن أدخل في هذا الأمر لأنه لا يمت إلى الغاية من بحثي هذا بصلة.
ومن جملة ما شاع من أساليب العنف، بعد وفاة النبي الكريم، ما سمي بـ"حد الردة"، وهو يقضي بتقل من يرتد عن الإسلام بعد اعتناقه، وذلك استنادًا إلى حديث يقول فيه "من بدل دينه فاقتلوه". وقد اختلف المجتهدون في ذلك. وكان الأخير بينهم المفكر الإسلامي البارز طه جابر العلواني (الذي حاز درجة دكتواره في أصول الفقه من جامعة الأزهر، ودرس المادة نفسها في جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض). ففي كتابه "لا إكراه في الدين" الذي أصدره مؤخرًا يؤكد أن القرآن الكريم خال من آية إشارة إلى حد الردة. والحديثُ المنقول إنما هو رد فعل من الرسول لما ورد في الآية الكريمة من سورة عُمران (وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم..) (72 – 73). وفي القرآن الكريم كما في "السيرة النبوية" إشارات إلى طائفة من اليهود كانت تخطط لاختراق المسلمين، ولا سيما المستضعفين منهم، بغية إشاعة البلبلة في صفوف المؤمنين وإذاعة أن الدين الجديد غير سليم ولاغ صادق. ويوضح الدكتور علواني أن" من" في الحديث النبوي تفيد العموم، و"دين" لفظة نكرة تُضاف إلى ضمير وتعفيد العموم أيضًا؛ فالحديث يعني أي شخص وأي دين، سواء أكان الانتقال من الإسلام أم اليهودية أم المسحيية إلى غيرها أو بالعكس. فالقصد حفظ الأديان من النفاق والتخريب. وفي حديث لمحطة "العربية" التلفازية أكد الدكتور علواني أن عهد الرسول خلا من أية عقوبة لمرتدين، وقال: "في عهد النبي ارتد أناسٌ بعد حادثة "الإسراء"، ولم يعاقبهم الرسول. وقد يقال هذا حصل في العهد المكي. ولكن في العهد المدني أيضًا دخل منافقون إلى الإسلام، ونافقوا، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي سمي "زعيم المنافقين".
وعرض الصحابة على الرسول قتله؛ فرفض ذلك، كما صلى عليه عندما توفي. ولو كان عليه حد لكان قتله". وسنرى في بحث مقبل أن حديث الرسول وظف واستخدم سياسيًا لخدمة السلطة.
وفاة الرسول الكريم
خاص المسلمون في عهد الرسول عدة معارك ضد أعدائهم فصلت أحداثها كتبُ التاريخ؛ وهي لا تدخل في خطة هذه الدراسة. وبعد أن آتاهُ النصر الأخير، شد رحاله مع المؤمنين إلى مكة، ونزل الوحي عليه وهو في عرفات معلنًا للمؤمنين (اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي) (المائدة 3). وما هي إلا بضعة أشهر حتى يقترب أجل الرسول. فالسببُ الروحي لمجيئه إلى الأرض هو أداء رسالة روحية؛ وما دامت الرسالةُ قد أكملت، فحياته قد استتمت غايتها. والجدير بالذكر أن النبي الكريم قد تأثر من الاضطراب الدائم في سنواته الأخيرة، فكان حزينًا، منطويًا على نفسه، يزور المقابر في الليل ويخاطب الأموات معلنًا أن عيشتهم أفضلُ من عيشة الأحياء. من تلك الزيارات ما أثبته ابنُ هشام نقلاً عن ابن إسحاق عن آخرين قائلاً إن الرسول انطلق مع مولاه أبي مويهبة إلى المقابر، فلما وقف فيها، قال: "السلامُ عليكم، يا أهل المقابر، ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناسُ فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبعُ آخرها أولها، الآخرةُ شر من الأولى". (ج 4، ص 254). وكانت تساوره حمى شديدةُ الارتفاع. ولم يستطع المؤرخون من ناقلي سيرته أن يكشفوا عن سبب واضح أكيد لمزاجه الكئيب وصحته؛ حتى إذا حان يوم 7/8 حزيران سنة 632 ميلادية دخل المسجد ونعى نفسه للمسلمين بطريقة مبطنة، فعرف أبو بكر ما يقصد وبكى. وفي حديث نُقل عن عائشة أنه قال لها: "إن الله لم يقبض نبيًا حتى يخيره"؛ فلما حضرته الوفاة كانت آخر كلمة سمعتها: "بل ]اخترتُ[ الرفيق الأعلى". ("سيرة ابن هشام"، ج 4، ص 265).
العقيدةُ والفضائل الإسلامية
أكد القرآن الكريم أن "الإسلام" يشمل الأديان السابقة المعروفة في شبه جزيرة العرب جميعًا، بمعنى إسلام أمر المؤمن وحياته لله والاتضاع له تعالى، وأن على المؤمنين بالدين الجديد الإيمان بالأنبياء السابقين والامتناع عن استفزازهم المؤمنين بهم في الجدال. وهذا التوحيد الإسلامي للأديان يتفق مع مبدأ وحدتها الجوهرية في الداهشية. من الآيات المؤكدة ذلك: (ولا يتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنُ إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأُنزِلَ إليككم، وإلهنا وإلهكم واحدٌ، ونحن له مسلمون) (العنكبوت 46). كذلك (قل آمنا بالله وما أُنزلَ علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون) آل عمران 84)؛ كذلك (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، مَن آمنَ بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة 62)؛ والآيتان الأخيرتان من سورتين مدنيتين، أي في عهد بدأ المسلمون فيه احتكاكهم باليهود والنصارى.
وأكد القرآن الكريم أن عيسى ابن مريم هو "كلمةُ الله ورسولُه" (النساء 171)، وقد صنعُ المعجزات مذ1 كان في المهد (مريم 30، آل عمران 46 و49، المائدة 110)، وأن مريم رفعها الله فولدته وهي عذراء. ورد في سورة آل عمران (وإذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمي) (42).
يختم توماس كارلايل فصله عن "البطل نبيًا" في كتابه الشهير "الأبطال، عبادة البطل، والبطولة في التاريخ" بقوله: "كان ذلك للأمة العربية بمنزلة الخروج من الظلمات إلى النور، خروج به انتفضت تلك الأمة حيةً بعد همودها. شعبٌ فقير من الرعاة يجول في بواديه منذ خلق العالم خامل الذكر، بعث إليه نبي – بطل بكلمةٍ يمكنهم أن يؤمنوا بها: وإذا الخامل الذكر يصبح ذا شهرة عالمية، والصغير ينمو بحجم العالم. وبعد قرنٍ واحد، تمتد العربية ] شبه جزيرة العرب[ إلى غرناطة من جانب، وإلى دلهي من جانب آخر وهي تلتمع بالبطولة والمجد والعبقرية إلى عصور مديدة فوق قطاع كبير من العالم. الإيمان عظيم، ومبعث للحياة. إن تاريخ أمة ما يغدو مثمرصا، عظيمًا ومبعث للحياة. إن تاريبخ أمة ما يغدو مثمرصا، عظيمًا، يسمو بالنفس، حالما يداخلها الإيمان. أولئك العرب، محمد الرجل، وذلك القرن الواحد – أليس هذا أشبه بشرارة هبطت من عل، شرارة واحدة هبطت على عالم من الرمل كان يبدو أدكن غفلاً، فإذا الرمل باورد متفجر، يوهجُ الفضاء من دلهي إلى غرناطة! لقد قلتُ إن الرجل العظيم كان دائمًا كشهاب من السماء، وسائر الناس في انتظاره كالوقود؛ فما إن يسقط حتى يلتهبوا".
وبلا ريب، كان تأثير النبي العربي في المسيرة الحضارية إلى عدة قرون بالغًا، إذ إنه، شأن كل نبي وهاد إلهي، يحمل رسالةً روحية إلى العالم غيرت مجرى التاريخ وأخصبته. ومن يتبصر في ظروف البيئة العربية الاجتماعية والاقتصادية والدينية قبيل الدعوة الإسلامية يستحل عليه أن يؤكد أن عربيًا سيتمكن من قلب الأوضاع السائدة وجبه مئات الألوف من أعدائه، ثم ضمهم إلى "أمة" تبنى رابطتها على العقيدة الدينية وما تنطوي عليه من معتقدات غيبية جديدة وسلوك قويم ومواقف شريف تجاه الآخرين. يستحيل ذلك لأنه لا يخضع للمألوف ولا للقوانين السائدة، بل يخضع لقانون إلهي هو السببية الروحية. هذه السببية يمكن رؤيتها، في ضوء التعاليم الداهشية، ذات شعبتين تؤديان إلى نتيجتين: الأولى منح العرب رحمة قد تساعد كثيرين منهم في أن يسموا بسيالاتهم الروحية المنطوية على مداركهم ونزعاتهم، وبالتالي في إخراجهم من الظلمات إلى النور؛ وهذا ما حصل في عهد النبي الكريم ومعظم عهد الخلفاء الراشدين. الثانية تأديبُ اليهود والنصارى ممن حولهم لخروجهم عن العقيدة الصحيحة وما تستوجبه من سلوكٍ قويم، وإطلاق حضارة جديدة مبنية على القيم الروحية والعقلية. وهذا ما سيشكلُ مادة للبحث في سيأتي من هذه الدراسة".
السببية الروحية في مجرى الأحداث العامة (10)
قيامُ الحكم الراشدي والفتوح التأديبية
بقلم الدكتور غازي براكْس
يقول العقاد في كتابه "عبقرية محمد": "محمد في نفسه عظيم بالغُ العظمة وفاقًا لكل مقياسٍ صحيح يُقاس به العظيم عند بني الإنسان في عصورِ الحضارة. فما مكانُ هذه العظمة في التاريخ؟ ما مكانُها في العالم وأحداثه الباقية على تعاقُبِ العصور؟
"مكانها في التاريخ أن التاريخ كله بعد محمد متصل به مرهونٌ بعمله، وأن حادثًا واحدًا من أحداثه الباقية لم يكن ليقع في الدنيا كما وقع لولا ظهور محمد وظهورُ عمله.
"فلا فتوح الشرق والغرب، ولا حركات أوروبا في العصور الوسطى، ولا الحروب الصليبية، ولا نهضةث العلوم بعد تلك الحروب، ولا كشفُ القارة الأمريكية، ولا مساجلةُ الصراع بين الأوروبيين والإفريقيين، ولا الثورةُ الفرنسية وما تلاها من ثورات، ولا الحربث العظمى التي نشهدها في هذه الأيام، ولا حادثةٌ قومية أو عالمية... كانت واقعةً في الدنيا كما وقعت لولا ذلك اليتيمُ الذي وُلِدَ في شبه الجزيرة العربية...
ما قاله العقاد يُنبئ عن إدراك للأسباب الروحية التي تقولب مفاصل التاريخ، وتسمُ الأحداث بعدها بطابعٍ ما كان ليظهر لولاها. وهو ما ذهبت إليه النظرةُ الداهشية. ففي ضوئها يكونُ للرسالات والهدايات الروحية الكبرى تأثيرٌ في الأحداث ذو مدى واسع المجال وطويل الأمد، يمتدُ عصورصا بعد عصور، بحيثُ لا يماثله أي تأثيرٍ آخر، سياسيًا كان أم اقتصاديًا أم عسكريًا أم غير ذلك. فما من إمبراطورية بقيت، ولا من نظامٍ سياسي أو اقتصادي استمر أكثر من بضعة عقود أو قرون.
الحكم الراشدي القدوة
من أبرز التأثيرات التي أحدثها ظهورُ الإسلام قيامُ بضعة حُكامٍ صالحين ندر أمثالهم في التاريخ البشري. فالخلفاء الراشدون الأربعة الذين خلفوا النبي مباشرة في حكم الدولة الإس لامية استلهموا القيم الروحية التي آمنوا بها في ممارسة سلطتهم، واجتمعت في شخصياتهم مزايا وتهيات في حُكمهم (632 – 661م) صفاتٌ وشروط لم تتكرر في أي حاكم أو أي عهد في الإسلام طوال أربعة عشر قرنًا إلا في الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (717 – 720م) الملقب بـ "خامس الخلفاء الراشدين". فكان أولئك الخمسة يحكمون بين الناس، حقًا، بشريعة القرآن مستلهمين الآية الكريمة (فاحكمْ بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا) (المائدة 48). أما سيرهم فقد نسجوها على منوال سيرة الرسول جهد ما استطاعوا مع بعض تقصيرٍ من قبل عثمان لعله يرد إلى عمره وماضيه قبل الإسلام؛ فتواضعوا للمسلمين وللمحكومين عامةً، وجعلوا العدالة والحق شعارهم، ومصلحة المحكومين وحريتهم هدفهم، وعاش أربعةٌ منهم عيشة الكفاف بل الشظف أحيانًا، مع أن خيرات الدنيا كانت بين أيديهم. وإذا شابت حُكمَ عثمان وعلي أزماتٌ سياسية شلت نجاحه، فهي لم تفسد صلاحهما الشخصي.
فأبو بكر قال في خطبته على أثر مبايعته بخلافة النبي: "أيها الناس، قد وليتُ عليكم ولستُ بخيركم. فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأتُ فقوموني. ألا إن الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله...
أطيعوني ما أطعتُ الله ورسوله؛ فإذا عصيتُ، فلا طاعةَ لي عليكم..." وكانت حياته وسياسته تجسيدًا لفحوى خطبته. فقد اتبع النظام الذي سنه النبي في إدارة شؤون الدولة. ولم يكن بحاجة إلى أكثر من معاونين: عمر للقضاء، وأبي عبيدة للمال. ومع ذلك حكمك بالعدل، فكان يتقصى أخبار الولاة، ويسألث الرعية عما يتشكون منه، فينصفُ كل مظلوم. وأمن الدولة من أعدائها الداخليين والخارجيين. ففي الداخل أوجب الطاعة على المرتدين الغادرين، الناكثين بالوعد، الخائنين للعهد، الرافضين للزكاة، فحاربهم وأخضعهم. وقضى على الأنبياء الكذبة، مظهرًا أنه يستطيع أن يكون الحاكم الحازم الحاسم، على لينه وعطفه على الأسرى وتسامحه مع رؤوس المرتدين.
وقد أسلم على يدي أبي بكر رهط من أعيان العرب. وكان يدفعُ الأثمان الغالية لابتياع العبيد الذين أسلموا كي ينقذهم من قسوة أسيادهم؛ منهم بلال بن رباح مؤذن الرسول.
وكان أبو بكر عفيف النفس، زاهدًا بالدنيا طوال خلافته. مما يروى عنه أنه غدا ذات يومٍ إلى السوق وعلى ساعده ثياب؛ فرآه عمر فسأله عن وجهته وعما يريد. ولما عرف، قال له: "تصنعُ ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟" فأجابه: "فمن أين أطعم عيالي؟" فأشار عليه أن يترافقا إلى أبي عبيدة، أمين بيت المال، ليفرض له ما يكفي نفسه وعياله. وبعد أن تكاثرت أعمالُ الحكم، نقل مركز السلطة إلى المدينة، وجعل يعين نفسه بالتجارة حيثما استطاع. فلما شعر بدنو أجله، أوصى بأن يرد إلى الخزينة ما أخذه منها من ماله وممتلكاته؛ وقال لعائشة: "إذا أنا مُتُّ، فردي إليهم صحفتهم وعبدهم ولقحتهم ] ناقتهم الحلوب[ ورحالهم ودثارةَ ما فوقي اتقيتُ بها البرد، ودثارة ما تحتي اتقيتُ بها نز الأرض، كان حشوها قطع السعف".
أما عمر بن الخطاب فكان جندي الإسلام الأمثل في شجاعته وصراحته وحزمه وخشونته وغيرته ومروءته ونظامه وطاعته، وفي تقديره الواجب وحب الإنجاز في حدود التبعات، وكذلك في شعوره الشديد بالمسؤولية الروحية بصفته إنسانًا وكونه حاكمًا. ولذا كان ينتبهُ لكل صغيرة أو كبيرة في ديار الإسلام لإيمانه بأن الله سيحاسبه عنها. وقد تمخضت مزاياه هذه بجرأة نادرة على الولاة، إذ كان يقرعهم وينذرهم إذا أهملوا واجباتهم بعض الشيء، أو أسرفوا في عقوباتهم؛ وقد رصد الرقباء لهم، وحظر عليهم مظاهر الأبهة والخيلاء التي تباعد بينهم وبين رعاياهم، وجعل الكفاءة والحرص على الواجب أساسًا في تعيينهم؛ وكان يحصى أموالهم قبل ولايتهم ليحاسبهم بها على ما زادوه بعد الولاية.
بيد أن أبرز صفاته الحميدة كان العدل والرحمة اللذين حفلت حياته بشواهد عليهما. منها أنه صادف شيخًا أعمى يسألُ عند باب منزل؛ فإذ علم أنه يهودي، سأله: "ما ألجأك إلى ما أرى؟" فأجاب: "أسأل الجزية والحاجة والسن". فقاده عمر إلى منزله، فأعطاه ما يكفيه يومه؛ وبعث برسالة إلى خازن بيت المال يقول فيها: "انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. إنما الصدقاتُ للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب". ورفع الجزية عنه وعن أمثاله.
ومن أمثلة عدله أيضًا أنه أيام كان عمرو بن العاص واليًا على مصر، جرى سباق للخيل اشترك فيه ابنه ونازعه أحد المصريين السبق. فاختلفا في مَن يكونُ الرابح. هاج ابنُ الوالي فضربَ المصري قائلاً له: أنا ابنُ الأكرمين. فحضر المصري إلى الخليفة رافعًا إليه شكواه. فاستدعى عمر الوالي وابنه، وأهاب بالمصري، أمام جمع من الناس، أن يضرب ضاربه قائلاً له: "اضرب ابن الأكرمين!" ثم أوعز إليه بأن يضرب الوالي نفسه، لأنه لو كان عادلاً رحيمًا لما تجرأ ابنه على ضرب الأبرياء. وصاح بوجه عمرو بن العاص ساخطًا: "بِمَ استعبدتُم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟".
وبالرغم من أن خالد بن الوليد كان أشهر قادة الإسلام في عصره، فقد حاكمه في مجلس عام مثلما يحاكمُ أصغرُ الجنود، ثم عزله وأعاد إلى بيت المال قسمًا مما يملك، وذلك لاقترافه بعض المآخذ وإنفاقه من المال العام على وجهٍ غير صحيح
وكان عمر يساوي بين أبنائه وسائر المسلمين حتى في أشد العقوبات. وما شكا إليه مظلوم من أهل الذمة (النصارى واليهود) واليًا مهما يكن شأنه إلا أنصفه منه. ولم يتخذ أي قرار يضيقُ على حرياتهم إلا ما كان ضروريًا من أجل صيانة أمن الدولة وسلامة العقيدة الدينية.
وأما عثمان بن عفان فقد اختاره مجلس تستشاري اقامه عمر قبيل وفاته. اشتهر بالدعة والحياء والرفق والمروءة، ولكن بالدرجة الأولى بالكرم والإحسان. فقد كان أسخى الأغنياء وأغنى الأسخياء. وقد بذلك في سبيل الرسالة الإسلامية، في الحرب والسلم، ما لم يبذله أحد. وثراؤه العظيم أبعده عن الزهد والتقشف، لكنه لم ينتقص من صلاحه ونزعته الروحية ومقته لسفك الدماء.
لكن إن يكن عثمان حاكمًا صالحًا، فإنه لم يكن حاكمًا ناجحًا. وهذا سيؤدي إلى ما لا تحمدُ عقباه في أواخر حياته وبعد موته. وتفصيلُ ذلك سأدعُه إلى الحلقة الثالثة من هذا البحث.
وأما عليّ بن أبي طالب فلم تتفتح بصيرته إلا على الإسلام، فهو لم يعرف عبادة الأصنام. ولذا تجلى صدقث الدين الجديد وروعته وعظمته في إيمانه وعمله وعلمه وفقهه، حتى قال الرسولُ الكريم: "أنا مدينةُ العلم وعليٌّ بابُها؛ مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه". فلا عجب، بعد ذلك، إن استنصحه الخلفاء الثلاثة واستفتوه، وإن نشط تيار في المسلمين يشايعه. حتى إذا قتل عثمان كانت مبايعة علي تلبيةً لنقمة كثيرين من المطالبين بالعودة إىل سنة النبي وسنة أبي بكر وعمر؛ بل وحد فيه المظلومون والمحرومون والشاكون من مختلف الفئات ضالتهم، فتألبوا حوله. وسرعان ما اقتدى بعمره، فعزل الولاة الذين حامت الشبهات حولهم، فألب عليه جميع من انتفعوا أو يريدن أن ينتفعوا من الدنيا. فزاد هذا الأمر المعضلات الناشئة تعقيدًا (يفضل ذلك في الحلقة المقبلة).
فضلاً عن الشجاعة التي لا تضاهي التي كان يتمتع بها علي، كان أبعد الناس عن الظلم؛ بل أن صدره لم يكن حقدًا حتى على أعدائه، ولم يشهر سيفًا، وهو الذي يتمتع بقوة وصلاحبة بالغتين، إلا سبق فدعا إلى السلام. أما مروءته حتى مع خصومه فكانت مضرب الأمثال. فقد نهى جنوده أن يقتلوا مدبرصا أو يجهزوا على جريح، أو يفضحوا سترصا، أو يغصبوا مالاً. وكثيراً ما عفا عن أعدائه، وصلى على قتلاهم مثلما يصلي على قتلاه. ولما حال جندُ معاوية بينه وبين الماء وعطش جنوده، منعوه عنهم وأرادوا أن يهلكوهم عطشًا، فحمل عليهم وأجلاهم عنه، ثم سمح لهم أن يشربوا من الماء مثلما يشربُ جنده. وبعد أن انتصر في موقعه الجمل وظفر بعائشة التي كانت معتليةً هودجها تحرضُ المسلمين على قتاله، أرسلها إلى ديارها مكرمة مخفورة بالنساء المعممات المتقلدات السيوف اللواتي ظنتهن عائشة رجالاً.
ولم يكن علي يحتال لاسترضاء الناس، بل كان يصارحهم ما في نفسه التي لم تعرف الرياء. وحبه الصدق منعه من اللجوء إلى الحيلة في الحرب، والخدعة في السياسة، والمكر في تصريف الأمور؛ وصفاء نفسه وسريرته زاد صلاحه، لكنه حال دون نجاحه في الحكم. لقد أخلص علي للرسول العربي كل الإخلاص في حياته، وأخلص لتعاليمه بعد موته، فسار سيرته، وكان أزهد الخلفاء بالدنيا ولذاتها. فإن زدنا على ذلك علمه وفقهه وبلاغته، كان من الصائب أن نسميه الإمام الحق، بعد النبي الكريم. وقد تجلى إدراكه شروط الإمامة الحقة بقوله: "مَن نصب نفسه للناسِ إمامًا، فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره... وليكُن تأديبُه بسيرته قبل تأديبه بلسانه؛ ومعلم نفسه ومؤدبها أحقُّ بالإجلال من مُعلم الناس ومؤدبهم".
بمقتل علي (40 هـ/ 661م) يكونُ عهد الخلفاء الراشدين الأربعة قد انقضى. عهد، على امتداده أقل من أربعين سنة، أحدث تأثيرًا بالغًا ليس في العرب فحسب، بل في قاراتٍ ثلاث أيضًا. لكن قبل الخوض في هذا الأمر، تجدر الإشارة إلى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، حفيد عاصم بن عمر بن الخطاب من جهة أمه. فهو آخر الحكام الصالحين في تاريخ الإسلام. فقد استخلفه الخليفة الأموي السابع، سليمان بن عبد الملك (615 – 717م)، وله من العمر خمسة وثلاثون عامًا، لما اشتهر به من نزاهة وعدل في أثناء ولايته على المدينة ثم الحجاز. فلما قرئ كتاب الاستخلاف عفيه، أرعشته المسؤولية المفاجئة؛ فصعد المنبر، في اليوم التالين وخطب في الناس قائلاً: "... أما بعد، فقد ابتليت بهذا الأمر على غير رأي مني فيه، وعلى غير مشورة من المسلمين... وإني أخلعُ بيعة من بايعني، فاختاروا لأنفسكم". ذلك في وقتٍ كان فيه الأمراء والأعيانُ جميعًا يتنافسون على الخلافة. لكن عمر لم يفرغ من نطق عبارته الأخيرة حتى انطلقت أصواتُ المؤمني: "بل إياك نختار، يا أمير المؤمنين". وأجهش عمر بالبكاء. وفجأةً حدث الانقلابُ الروحي في نفسه! فكأنما حلت فيه، في تلك اللحظة، السيالاتُ الروحية التي كانت تُحيي جده عمر بن الخطاب، أو كأنما استيقظت فيه بعد هجعة، فأراد أن يجعل الحكم قوة، فيصل عهده بعهد الخلفاء الراشدين، على ما تغير من الناس والزمان؛ قدوة لا تشمل شخص الخليفة فحسب، بل أهل بيته، وولاة الدولة ومعاونيهم وموظفيهم أيضًا!
فبعد أن عاش عمر بن عبد العزيم شبابه يأكل من المطاعم أشهاها، ويرتدي من الثياب أفخرها وأغلاها، ويمتطي من الجياد أطهمها وأبهاها، ويتأنق في كل ما يقول ويعمل، منفقًا ألوف الدنانير في العام الواحد – بعد عيشة البذخ والترف تلك ، تخلى عن كل أبهةٍ وعظيمة، ورفض أطايب الحياة ليعيش في تقشفٍ وشظف، وصرف الجواري اللواتي قدمن إليه، كلا إلى بلدها وذويها، واستجعى امرأته فاطمة وأعلمها قراره بأنه سيمتنعُ عن كل علاقة زوجية معها، وأعطاها حقها في اختيار مستقبلها؛ لكنها لأزمته حتى النهاية. فكان في سيرته هذه محاكيًا لبوذا وسابقًا لغاندي. ولم يكتف الخليفة بذلك، بل تخلى عن جميع أملاكه وأمواله لخزينة الدولة، وباع حلله ومراكبه ومتاعه وحلل زوجته وأولاده، ووضع أثمانها في بيت مال المسلمين، مكتفيًا لنفسه ولكل منهم بثوبين خشنين، وله ولأسرته بمئتي دينار في العام هي غلة قطعة من الأرض استبقاها من دنياه كلها لمعيشته. تلك كانت خلاصة لحياته الخاصة.
أما حياته العامة فملأى بالفضائل؛ فقد جلس للناس على حصيرٍ فوق الأرض، وقال لهم في خطبة: "إني لستُ بقاضٍ، إنما أنا منفذ... ولستُ بمبتدع، إنما أنا متع... ولست بخيركم، إنما أنا رجل منكم، غير أني أثلكم حملاً".
وفي اليوم الأول من حكمه أمر باستدعاء جيش المسلمين الذي كان يحاصر القسطنطينية، وقد بدأـت المجاعةُ والأمراضُ تفتكُ فيه. وعزل الولاة المتجبرين وطالبهم الحساب. وألغى المخصصات المالية كلها حتى للأمراء ولذويه وأقربائه، وجردهم من الإقطاعات الزراعية، وردها إلى بيت المال. وعندما قيل له: "يا أمير المؤمنين، ألا تخاف غوائل قومك؟"
أجاب: "أبيومٍ سوى يوم القيامة تخوفونني؟".
ذات يومٍ، طلب إليه الموافقة على صرف مبلغٍ كبيرٍ من المال لكسوة الكعبة؛ فأجاب: "إني أرى أن أجعل هذا المال في أكباد جائعة، فإنها أولى به من الكعبة".
وقد أحاط عمر بن عبد العزيز نفسه بمجلس شورى من الأخبار، وشجع الناس على نقد ولاتهم إن أخطأوا، بل سن جوائز لمن يكشفُ عن خطأ ويهدي إلى الصواب.
وأطلق الحريات الاعتقادية حتى للخوارج، فكان يُقارعُهم بالحجة، ويرفضُ أن يقارعهم بالسيف، حتى أغمدوا جميعًا سيوفهم في عهده. لكن إطلاقه الحرية لم يمنعه من أن يحرم الحرام، فحظر لعن الإمام علي بن أبي "الب من على المنابر، بعد أن أصبح سنةً في الحكمِ الأموي.
فحظر لعن الإمام علي بن أبي طالب من على المنابر، بعد أن أصبح سنةً في الحكم الأموي.
وجعل عُمرُ بن عبد العزيز للأموال العامة حرمةً وجلالاً، فألغى جميعَ الضرائب التي اعتبرها مُجحفةً بحقِّ الشعب؛ وأنشأ دورَ الضيافة للمسافرين في طول البلاد وعرضها؛ ورفع مستوى الأجور الضعيفة؛ وكفل حاجاتِ العلماء والفقهاء ليتفرغوا لعلمهم؛ وأوصى لكل أعمى بقائد يقودُه، ولكل مريضٍ عاجز أو مريضين بخادم، وذلك على حساب الدولة؛ وأمر بإحصاء المديونين العاجزين، فقضى عنهم ديونهم؛ وافتدى أسرى المسلمين وأغدقَ الهبات عليهم؛ وكفل اليتامى الذين لا مُعيل لهم؛ وفرض لكل مولودٍ راتبه وعطاءه بمجرد ولادته؛ وحظر الجمع بين راتبين مهما تكن الأسباب. وقد شمل عدله ورحمته الإنسان والحيوان حتى كاد الفقر والظلم ينقطعان.
وقد وحد المجتمع الإسلامي مزيلاً منه العصبيات والعدوات، وإن يكن لوقت قصير؛ وحمى حقوق أهل الذمة؛ وأوقف الأعمال العسكرية الخارجية مستعيضًا عنها بمكاتبه الملوك والحكام ودعوتهم إلى الإسلام؛ فأسلم كثيرون منهم متأثرين بحياته القدوة التي أذابها الجهد والتقشف، فقضى بعد سنتين وخمسة أشهر وبضعةِ أيام من الحكم. وهو لم يتم الثامنة والثلاثين.
الفتوحُ الإسلامية وتأديبُ الدول المنحرفة عن تعاليم الهدايات الروحية الأصلية
ليس من حادثٍ يقعُ في العالم إلا وراءه سببٌ روحي؛ هذا ما تعلمُه الداهشية. وظهورُ الإسلام كان خيرًا لقومٍ وعقابًا لومٍ آخرين، على الأقل في زمان معين. فما إن تولى أبو بكر الخلافة حتى سير جيشًا إلى العراق بقيادة خالد بن الوليد، فطعن الإمبراطورية الفارسية في خاصرتها باحتلاله ثلاث مُدنٍ رئيسة: الأبلة (البصرة فيما بعد)، والمدائن، والحيرة التي دانت له دونما اقتتال. ثم سار مُسرعًا إلى سوريا حيث كانت فلسطين ميدانًا لعمليات عسكرية تقوم بها ثلاثةُ جيوشٍ من المسلمين بتهيبٍ وتردد، فوحدها تحت إمرته، وكر على الجنود البيزنطيين المسيحيين فهزمهم.
واستتم عُمَر بن الخطاب فتح سوريا، وأمعن الدخول في فارس، وأنفذ عمرو بن العاص إلى مصر فبلغ الإسكندرية. ثم تابع المسلمون، في عهد عثمان، تقدمهم متوغلين في فارس، وأرمينيا وأذربيجان وإفريقيا الشمالية محتلين النوبة (السودان) وطرابلس الغرب والقيروان، هازمين الروم البيزنطيين. بل إن المقاتلين المسلمين وثبوا إلى البحر فاحتلوا قبرص، وبعد ثلاثة أعوام هزموا أسطولاً للروم البيزنطيين قُبالة شاطئ الإسكندرية ("معركة ذات الصواري)، وسيطروا علىا كثيرٍ من سبل الملاحة. وهنكذا ثبتت هيبة الدولة الإسلامية ووسعت نخومها شرقًا إلى الهند والصين، وشمالاً إلى ما وراء بحر الخزر (قزوين)، وغربًا إلى أبواب القسطنطينية وتخوم الأندلُس، وجنوبًا إلى السودان والحبشة في حوالى أربعة وعشرين سنة.
وبالرغم من فراغ العالم الإسلامي، بعد عمر بن عبد العزيز، من خليفةٍ صالح، فإن "دار الإسلام" ظلت تتسعُ، بإذن إلهي، حتى شملت معظم إفريقيا والأندلسَ والقسطنطينية نفسها عام 1453، بعد أن اعتنق الأتراكُ الإسلام، وامتدت إلى إندونيسيا وبعض روسيا.
ويبدو جليًا من القرآن أن ما من مصيبةٍ إلى وراءها أسبابٌ روحية يمكن إيجازها بالانحراف عن التقوى والإيمان الصحيح، والانجراف إلى الفُسق والظلم والبطر وغيره من الموبقات. وإذا حقت المصيبة على أناسٍ في زمنٍ عادي، فبالأحرى في زمن يظهرُ فيه الرسلُ والهداةُ الروحيون، لأنهم جميعًا منبثقون من مصدرٍ روحي واحد. من آيات الكتاب الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (الإسراء 14)؛ (وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً، وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مُهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون)(القصص 58 – 59)؛ كذلك (وما كان ربك ليُهلكَ القرى بظلم وأهلها مصلحون) (هود 117)؛ (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان، فكفرت بأنعمِ الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) (النحل 112).
ومن الضرورة أن يفهم الباحثُ عن الحقيقة أن الله تعالى ليس هو الذي يظلمُ الناس، بل هم يظلمون أنفسهم، وبأعمالهم يسببون المصائب لهم والعقوبات. وقد أكد القرآنُ هذه الحقيقة تأكيدًا حاسمًا في عدة آيات؛ منها: (فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا، ومنهم من أخذته الصيحةُ، ومنهم من خسفنا به الأرض؛ ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) (العنكبوت 40)، و(ظهر الفسادُ في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (الروم 41)؛ كذلك (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير) (الشورةى 30). وهذا الأمر يلتبس فهمه على كثيرين من المؤمنين والباحثين، فيتساءلون: وما ذنبُ الأطفال والنساء والأبرياء الذين يقتلون في الحروب أو الكوارث الطبيعية، ما دام (الله لا يظلمُ مثقال ذرة) (النساء 40)؟ والجوابُ لم يوضح في عقيدة روحية ما مثلما وضح في التعاليم الداهشية التي تؤكد أن الحياة نهر لا ينقطع جريانُه بين الأزلِ والأبد، وأن الإنسان في حياته الراهنة هو نتيجة لحياة سابقة. فالولدُ امتدادٌ نفسي وراثي لأبويه وجديه، بل أجداده، وما يقعُ عليه من مصائب يكون قد استحقها بما كسبت يداه أو أيديهم في حياة سابقة، إن لم يكن في الحالية. وتفصيلُ هذا الأمر يقتضي دراسة معمقة خاصة. ما قدمتع ينطبق على الناس جميعًا ممن خرجوا عن جوهر أديانهم فتاجروا بها، ووفقوا فيها بين الدنيا والله ولم يطبقوا منها إلا طقوسصا وشعائر لا تمت إلى الجوهر بصةل. لكنه ينطبق خصوصًا على المسيحيين المنحرفين عن تعاليم سيد المجد في حال استطاقنا الدلالات القرآنية. فالنصارى (وكذلك اليهود) كانوا يستعلون على غيرهم من المؤمنين مدعين أنهم مختارو الله، وقد سلطهم على سائر الأمم. فإذا الآياتُ القرآنية تكذبهم لانحرافهم عن جوهر تعاليمهم الروحية. مما ورد في ذلك: (وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاءُ، ويعذبر من يشاء. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير) (المائدة 18)؛ كذلك (ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظًا مما ذكروا به، فأعرينا بينهم العداوةَ والبغضاء إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) (المائدة 14). وفي هذه الآية نبوءة للانشقاقات والحروب التي ستحدث بين المسيحيين، لا سيما بين المكثلكة والبروتستانتية، بدءصا من القرن السادس عشر.
وإذا كان القرآن الكريم يؤثر النصارى على اليهود في مقارنته بين الملتين (المائدة 82), فإنه يحملُ على كثيرين من الأخبار والرهبان المسيحيين الذين استغلوا الرهبانية التي أرادها الله طريقًا للظفر برضوانه، فحولوها للاتجاه بالدين والفُسق، وجعلوا يبتزون أموال الناس كانزين الفضة والذهب ومسخرين الدين والمؤمين لمصالحهم الخاصة: (ثم قفينا على آثارهم برُسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفةً ورحمةً ورهبانيةً ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثيرٌ منهم فاسقون) (الحديد 26)؛ إن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة 34). فضلاً عن فضح القرآن الكريم سلوك كثيرين من رعاة الكنيسة الشائن، فإنه حمل على تحريفهم التعاليم المسيحية الأصلية في عدة أمور اختلقوها وأدخلوها في العقيدة لأنها كانت تلائمُ الظروف السياسية والدينية في الإمبراطورية الرومانية الوثنية قبل ضعفها وتجزيئتها من جهة، وتلائمهم مقويةً نفوذهم ورافعةً من شأنهم تجاه رعاياهم من جهة أخرى (وقد أوضحتُ ذلك في حلقة سابقة).
أولاً، مخالفةُ الزاعمين بأن المسيحَ هو الله عز وجل (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيحُ: يا بني إسرائيل، ابعدوا الله ربي وربكم؛ إنه من يشركُ بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومأواهُ النارُ، وما للظالمين من أنصار) (المائدة 72).
ثانيًا، مخالفة القرآن القائلين بأن الله تعالى أقنوم من أصل ثلاثة أقانيم متساوية (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثُ ثلاثة، وما من إلبا إلا إله واحد...) (المادئة 73). وكذلك (يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق؛ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه؛ فآمنوا بالله ورسُله، ولا تقولوا ثلاثة؛ انتهوا خيرًا لكم. إنما اغلله إله واحدًا سبحانه أن يكون له ولدٌ، له ما في السموات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا) (النساء 171). وبهذا المفهومز القرآني الذي يجعل المسيح "روحًا من الله" تفهم الداهشية بنوة المسيح، لكنها ترفض المساواة بين المسيح والله تعالى.
ثالثًا، مخالفة القرآن قول المسيحية إن المسيح ابن مريم صلب (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا أتباع الظن، وما قتلوه يقينا) (النساء 157). وقد أتيح لي أن أوضح، في محاضرةٍ ألقيتها في الجامعة الأمريكية ببيروت (12 أيار 1970 حقيقة الأمر، مدعومة بالبرهان المادي الملموس؛ فإنني، شأن كثيرين من الداهشيين، تأكد لي وجودُ ست شخصيات لمؤسس الداهشية؛ أي ستة امتدادات روحية كائنة في عوالم علوية كانت تتجسد أحيانًا فُرادى أو مجتمعة، في مكان واحد أو في أمكنة مختلفة، في وقت واحد، أو أزمنة مختلفة، إذ ليس للمكان ولا للزمان سلطة عليها؛ فنجالسها ونؤاكلها ونحادثها دقائق أو ساعات، ثم تختفي من بيننا فجأة عائدةً إلى عوالم العلوية؛ وكثيرًا ما تترك آثارًا باقية، كرسائل روحية موحاة أو غيرها. وفي أثناء حملة الاضطهاد التي شنها الرئيس اللبناني الأسبق بشاره الخوري على مؤسس الداهشية، قامت إحدى شخصياته العلوية بتضحية افتداءٍ للداهشيين الذين كان أبرزهم ما يزالون في السجون معرضين للقتل، بينهم الأدبية والفنانةُ الكبيرة ماري حداد (شقيقة زوجة الرئيس الخوري)، فتجسدت الشخصيةُ في آذربيجان في إيران والثورةُ فيها قائمة، فقبض عليها وأعدمت بالرصاص (1/7/1947). وصدر عن السفارة الإيرانية بيان رسمي بمصرع الدكتور داهش، ونُشرت صورُ مصرعه في الصحف. وهذا الأمر طمأن الرئيس اللبناني بأن مؤسس الداهشية قد قتل. مثيلُ هذه الشخصية العلوية هو ما صلب للسيد المسيح. ولذا قال القرآن (وما قتلوه وما صلبوه، لكن شبه لهم)، لأن ما تجسد وصلب هو شبهُه تمامًا ولأن التجسد هو تجسد كائنٍ من عالم لا يخضعُ لقانون الموت الأرضي، فقد قام المسيحُ من الموت مثلما قام الدكتور داهش من الموت. وهذا القضية تحتاج تفصيلاً لا مجال له في هذا البحث.
رابعًا، دحضُ شفاعات القديسيين الذين ملأت الكثلكة كنائسها بأيقوناتهم، واستثمرت سذاجة المؤمنين ببيعهم ذخائر لهم وهمية (واتقوا يومًا لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئًا، ولا يقبل منها شفاعةٌ ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون) (البقرة 48)؛ كذلك (الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما... ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون) (السجدة 4).
إن عقاب المسيحيين على انحرافهم سلوكًا وعقيدة تنبه له حتى علماءُ الدين المسيحيون. حسبي أن أذكر منهم الأستاذ جورج بوش (شقيق الجد الأكبر للرئيس الأميركي)، إذ إنه بالرغم من عدم إيمانه بالوحي الإسلامي، حار في تعليل الفتوح المذهلة بسرعتها وامتدادها التي حققها الإسلام، فقال: "إن ما حققه بني الإسلام لا يمكن تفسيره إلا بأن الله كان يخصه برعايةٍ خاصة؛ فالنجاح الذي حققه محمد لا يتناسب مع إمكاناته، ولا يمكن تفسيره بحسابات بشرية معقولة؛ لاغ مناصَ إذًا من القول إنه كان يعمل في ظل ماية الله ورعايته". ذلك بأن أحداث العالم داخلة في قدرة الله وعنايته، والمسيحين بانحرافهم الشديد، وجبت معاقبتهم معاقبة صارمة.
