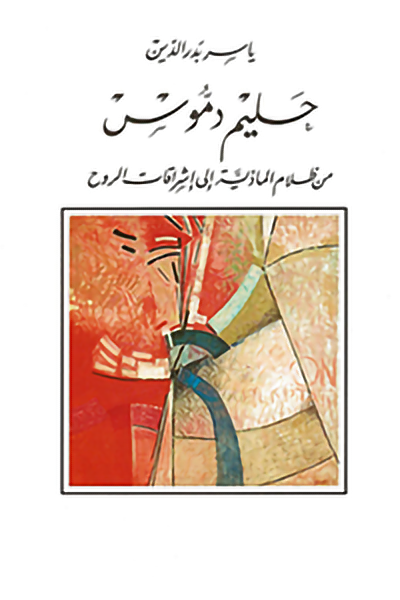
تمهيد
يعيشُ على ضفاف النجوم، يَغتذي من بريقها، ويستحمُّ في زُرقةِ مائها وسمائها. نغمٌ إلهيٌّ تزدحمُ فيه الأحاسيس، وإذا نطق به القلمُ فخيوطٌ من الضوءِ المتقطر من عيون الحبيب.
إنه الحالة الجمالية التي يعيشها الوجود، والناقل الأمين للمشاعر التي تعصى على النقل. ملاذنا في سورة الألم، حلوهِ ومُرِّه. أليفُ النفوس المُرهَفة؛ تأنسُ به في المُلمات، وتفيءُ إليه من هواجر الحياة، حين يحتدم الشوق وتطفُرُ العبرات، وتختلجُ القلوبُ بدماءِ الأحزان.
يُتمتِمهُ ثغرُ الطفولة وشفاهُ الجراح، وتكتُبهُ عيونُ الأقاح، وأجفانُ البنفسجات المُختبئة بين الصخور. كائنٌ ضوئيٌّ يتقمصُ الفجر حينًا، وحينًا يُرافقُ القمر، ويُشرقُ مع شمسِ حزيران على براري الصحو والدفء وأعذب الكلام. يتنفسُ مع الصباح، ويكتئبُ مع المساء، ويرتَسمُ على صفحة الأفق بدماء الغروب وألوانِ وروده وبُرودِه، ويرقُّ في صلاة الينابيع الناسكة المزهوة بنقائها واقترابها من السماء. إنَّه الشِعرُ عمد حليم جموس بدمه، وأعطاهُ سره، وبثه لواعِجَه، وأسلم إليه قياده، فأعطاه الحليم نفسه، وفتح له قلبه، وضفره بضلوعه وولوعه جسر محبة وتضحية وجمال وفداء، فأوصله ووصل به إلى قلوب الناس لا بل إلى شغاف السماء.
ففي زحلة، مدينة شاعرة، عروس غيداء يغرها الثناء، مزهوة بعناقيدها المذهبة والموردة وبنهرها الذائع الصيت الذي لا يكف عن إطلاق الأناشيد وتبادل قصائد المديح والثناء مع الشعراء، ولد حليم دموس عام 1888 وفي فمه قصيدة، وعاش محاصرًا بالقريض. والدُه شاعرٌ، ورفاقه شعراء، ومدينته شاعرة، وكل من حوله يكتبُ الشعر.
لقد أحببتُ هذا الشاعر حبَّ الطفل لأمه وأبيه. وحبه تملكنا كالقدر، ونقش اسمه فيم خيلتنا وأفئدتنا منذ الصغر. إن أهمية الشاعر، في نظري، تكمن في قدرته على اجتذاب المشاعر واجتلاب القلوب. حسبي، في هذا الحديث، أن أنقل ما أُحسُّ به نح حليم جموس، أن أعلن حبي له من غير إهمالي موضوعية البحث.
حليم دموس، كما يُشبه نفسه في غير قصيدة، نسر. يحتاط الأرض فتختلج بين جناحيه! نسر شعر ومواقف بحجم الأرض؛ لكن الأرض ذاهبةٌ غاربة، وأشعاره ومواقفه خالدة.
حليم دموش! كم لهذا الاسم من وقع في النفوس البريئة! عذب عذوبة الطفولة! وكم له على الطفولة منجميل! لقد امتزج اسم هذا الشاعر في حياتنا ونحن لا نعرفه. عاش في ذاكرتنا، ورافق كُتبنا ودفاترنا ونشأتنا خطوةً خطوة، وصفوفنا صفًا صفًا. وكبرنا فرأيناهُ يكبَرُ معنا، وبذورُ المحبة والجمال التي زرعها في أفئدتنا وأرضنا صغارًا، رأيناها تنبتُ شجرًا مباركًا. أتبعها، بعد حين، بشجر جميل ظليل ليس من هذه الأرض، كشجرة يونس التي نبتت من غير زرع. فقد صلب عود شعره، وغنج التفافُ غصونه، ولطُفَ اهتزازُها، وعذُبَ امتزاجُ ألوانِه؛ فعلمنا أنه كان يشرب من منهل سحري إلهيٍّ، ويعودُ فيسقي شِعرَه من قلبه ويُطعمُه نفسه. عرفنا السرَّ، بل عرفنا سره. كان يشربُ من منهل الداهشية العذب، ويثملُ من خمرتها السماوية. إذًا حليم دمُّوس قبل اعتناقه الداهشية هو غيرُه بعد اعتناقها. والفرقُ كبيرٌ بين الرجلين!
ولطالما اعترفَ حليم دمُّوس بالتغيُّرِ الجوهري الذي اعتراه، فيقول:
"كنتُ ماديًّا محضًا فأصبحتُ روحانيًا محضًا". كذلك أصدقاؤه وعارفوه يعترفون بأن حليم دموس الذي خرج من منزل الرسالة الداهشية ليس هو نفسه الذي دخل إليه. لقد تمت" ولادته الجديدة"، مثلما يُشير إلى ذلك السيد المسيح. فبين غمضة عين وانتباهتها، تغيرت مسيرتُه، وانقلبت سيرةُ حياته وسيرُ قلمه من ظلام المادية إلى إشراقات الروح وتجلياتها النورانية الآسرة. وقد ندم على حياته السابقة للداهشية ندمًا بلغ حد التوبة وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ندِمَ على سنين قضاها في اللهو والعبث والسعي الحثيث نحو الشهرة والكسب المادي وعبادةِ الذات. وأدرك عن اقتناع أن سفينته كانت تُسيّرها رياحُ الأنا والغرور. ويحمدُ الله تعالى حمدًا عظيمًا إذْ أنعم عليه بالهداية بعدَ الضلال والأمن بعدَ الخوف، والطمأنينة بعد القلق والضياع الرهيب. فسيَّرت رياحُ الحنانِ والرحمة أشرعتَه، وأوصلتِ السفينةَ إلى شواطئ الأمان.
إنِّي لمعتذرٌ، واللهِ من قلمٍ
يجري على الطِرسِ مثل العارض الهتِنِ
فكم مدحتُ به قومًا بلا خُلقٍ
فكنتُ أنثرُ أزهاري على الدِمَنِ
شهرة حليم دمّوس الداهشية
كان حليم دمُّوس شديدَ الاعتزاز بعقيدته الجديدة ومؤسسها، الدكتور داهش، الذي لازمَهُ طوالَ ما تبقى لهُ من حياته (1942-1957)، مُكرسًا كل وقته لشرح الرسالة الروحية الجديدة والتغني بها شعرًا ونثرًا، وتوضيح مبادئها ومُرتكزاتها ودوافعها النبيلة الخيرة، والدفاع عنها من خلال ردوده على المفكرين، ولا سيما الكتابُ والصحفيون المشترون من قِبَل السُلطة الحاكمةِ بالنار، والتي لم تألُ جُهدًا ولم تدخر وسيلةً، وهي السلطة الآمرةُ المؤمرة، من اجل تشويه سمعة رجل الروح الطاهر، والنيل من مبادئه.
لقد عاش حليم دموس، في المرحلة الداهشية، مُنصرفًا عن الدنيا بما تحويه من مُتعٍ ومغريات، ناسكًا لعقيدته، عاشقًا لجمالها الإلهي، ثملاً بخمرتها الروحية. لقد ملأ بها دنيا العرب، وشغل الناس فأوصل شعرهُ الداهشي إلى كل الأسماع، وفتن الخاصة والعامة والصغار والكبار. وكان حديث الناس اليومي في مجالسهم ومدارسهم ومنازلهم وأعمالهم. وكان اعتقاله ومحاكمته بتهم مختلقة باطلة سببًا إضافيًا لتألقه وذيوع شهرته في شتى البقاع والأصقاع من هذا الوطن الحزين.
حليم دموس والنقد
إن مَن يقرأُ حليم دموس بعد 1942 لن يجدَ صعوبةً في اكتشاف هويته الداهشية. فقد أعلن الحليمُ انتماءه على رؤوس الأشهاد، ورفعَهُ نارًا على علَمٍ. وبشَّرَ بالخوارقِ المُذهلة كل قطرٍ ومِصرٍ عربيّ. لكنه لم يلقَ من الناس سوى آذانٍ صمَّاء، ومن زُملائِه الكُتَّاب والصحافيين والشعراء سوى الإهمال من بعضهم، والملامَة والظلامة من بعضهم الآخر. والغريبُ في الأمر أن النقاد أهملوا كليًا شخيته الداهشية، واقتصروا على تناول شخصيته الأولى التي لا تمثله ولا تكشف إلا جزءًا ضئيلاً من قامته الأدبية الفارعة، وقليلاً قليلاً من كنوزه ورموزه. لقد اقتصروا في كتاباتهم على الشخصية التي أنكرها الحليمُ وأعلنَ براءتَهُ منها؛ فقد سادت المرحلة الداهشية حياةَ حليم دمُّوس بحيثُ لا يمكنُ أي قلم إنكارها أو إغفالها. لقد غيَّرت ملامحَ وجهه، وأعادت تكوينَ أعصابِه ومشاعره ونظراته، حتى غيَّرت اسمه، فصارَ يُدعى حسان حليم دموس. ومع كل هذا، أنكرَ النقاد داهشيته.
لا يخفى ما في هذا الموقف من إساءةٍ، ليس إلى الشاعر وحسب، بل بالدرجة الأولى إلى النقاد أنفسهم، وإلى الحقيقة الأدبية والأدب عامة. فتعمد إغفال صفةٍ بارزةٍ جدًا في شخصية أديب يُخرجُ القلم المتجني من دائرة الموضوعية، ويضعُه في خانة النقد غير المسؤول، ويسمُه بالافتراء.
قد يحصلُ في معرض النقد أن يُعرض الدارسُ عن سمة عادية في المؤلف أو غير بارزة، وذلك تبعًا لميول هذا الناقد وأهوائه التي – للأسف – ما زالت في أكثر الأحيان تُملي على القلم ما تشاء، وتُسيِّرُه في الوجهةِ التي تُريد. أمَّا أن يُغفِلَ الناقدُ السِماتَ الأساسية المُميِّزة لصاحب الأثر الأدبي أو الفني، فهذا، لا شك، أمرٌ جلل يخرجُ عن المعقول ويرقى إلى مستوى سوءِ النية؛ بل هو افتئاتٌ وانحياز وخيانة لرسالة الأدب وهروب ذليل من وجه الحق والحقيقة. والمفارقة العجيبة أ، حليم دموس يعلن هويته ويرسم نفسه بريشته، والنقاد يصرون على تغيير هذهالهوية، وتشويه الصورة قائلين له: لا هذا لستَ أنت، بل أ،تَ كما نُريدُ لك نحنُ أ، تكون. فما هو هذا النقدُ الذي اجترأ فاجتزأ حليم دمُّوس، وأهمل حياته الداهشية؟
أذكُر، في هذا المجال، بعضَ الكُتَّابِ والشعراء الذين حرصوا على أن يكتبوا سيرهم الذاتية بأقلامهم خشية أن تشوههم أقلامُ الناقدين بعد موتهم. يقولُ الشاعرُ القرويُّ رشيد سليم الخوري:
"غدًا ينفسحُ مجالُ النقد والتشريح، وتتعثر الأقلام بين الحقائق والأوهام. وليس أعرفُ بي مني. فما أولاني بأن أُزوِّدَ الراغبينَ بما يكفيهم عناءَ البحثِ ورَيْبَ الظنِّ، ومذاهبَ التأويل"(1)
ويقول نزار قباني في سيرته الذاتية "قصتي مع الشعر".
"اُريدُ أ، أكتبَ قصتي مع الشعر قبل أن يكتبها أحدٌ غيري. أُريدُ أن أكشفَ الستائرَ عن نفسي بنفسي، قبل أ، يقصني النقادُ ويفضلوني على هواهُم، قبل أن يخترعوني من جديد. ثلاثةُ أرباع الشعراء من فرجيل إلى شكسبير، إلى دانتي، إلى المتنبي، من اختراع النقاد، أو من شغلهم وتطريزهم على الأقل"(2).
فهل يصدق ظن هذين الشاعرين فتحقق الأيامُ أحلامهما، أم إن محاولاتهما سوف تذهب أدراجَ الأعاصير؟ لقد أتاهم الجواب من نقاد حليم دموس. فقد ثبت أنه من المستحيل على نقادنا، وجلهم من أنصاف المثقفين، أن يكونوا من المنصفين فيضعوا أهواءهم جانبًا ويعطوا ما لقيصر وما لله لله. ونحنُ من خلال تجربتنا ومُواكبتنا للحركة الأدبية في النصف الثاني من القرن الفائت، نعرفُ جيدًا كيف تتلاعب الأهواءُ بأقلام النقاد فيكون من آثارها، لا شيء سوى المديح لِمَن يُحبن، والقدحِ والتجريح لمن يكرهون. وما ران من صمتٍ وخيَّم من سكون في إبان اضطهاد الدولة اللبنانية للدكتور داهش والداهشيين خيرُ دليل؛ فلم ينطق بكلمة الحقِّ قلم، وقد وقف الناسُ كافةً، ولا سيَّما الساسةُ والكُتَّاب والصحافيون والأدباء والشعراء أمام الجورِ الفاضحِ والظُلم الفادح والعَسفِ المهين كأنَّ على رؤوسهم وأقلامهم الطيور.
ولن استرسلَ في الحديث عن مهازل النقد ومخازي الصحافة، حسبي أن اقطف بعض ما كتب في هذا الصدد، رئيسُ تحرير مجلة "الآداب" ومؤسس "دار الآداب"، الدكتور سهيل إدريس(3):
"نريدُ الناقدَ الذي يعتبر النقد رسالةً مقدسة تجاه القارئ لا تملقا ولا تضليلا ولا شفاءً لِغُلَّة، ولا تنفيسًا عن حَسَد...
أما أولئك الذين يتناولون النتاج بالنقد، فلا يفهمون من النقد إلا أحد أمرين: إما هجوم، وإما ثناء. أما أنه تقويمٌ وتربية وذوقٌ ودعوةٌ إلى الاختيار، فليسَ شيءٌ من ذلك يعنيهم".
"لا بُدَّ من أن نؤكد اليوم ما قاله طه حسين، منذ ربع قرن، من أن الصحافة تلعبُ دورًا كبيرًا في إفساد الأدب... وينطبق هذا أشدَّ ما ينطبق اليوم على الصحافة اللبنانية... ذلك أن معظم الذين يُشرفون على الصفحات الأدبية والفنية والثقافية بصورة عامة جهلةٌ ومغرورون، أو مبتدئون لا يملكون من مقومات الأدب إلا عدَّةً هزيلة".
"ولن تحتاج إلى وقتٍ كبير، ولا إلى جُهدٍ خاص لتكشف أن معظم محرري الصفحات الأدبية لا يحسنون كتابة العربية، وقلما تخلو كتاباتهم من أخطاء في الصرف والنحو... وه لا يتورعون مع ذلك من تجريح كتابات المؤلفين الذين يتميزون بسلام اللغة ورشاقة العبارة ونصاعة الأسلوب.
إن انعدام روح المسؤولية أصبح الصفة الطاغية لمعظم ما توردُه صحفنا اليومية والأسبوعية نقدًا لكتاب أو تحليلاً لدراسة أو تعليقًا على مؤتمرٍ أو ندوة...".
لقد تجنَّبَ الناقدون التعرُّض لحليم دمُّوس بشكلٍ عام خشية أن يواجهوا شعرَهُ الداهشي. ومن اضطر منهم إلى التحدث عنه، باعتباره ظاهرةً في العصر لا يمكنُ إغفالُها، أهملَ المرحلةَ الداهشية من حياته.
وهذا الإهمالُ يَسمُ صاحبَهُ بالقُصورِ واللاموضوعية، واتخاذ المواقف والأحكام المسبقة التي تتعارض مع رسالة الناقد التي يُفترض بها أن تكون مقدسة. الأمر الذي يفتحُ البابَ واسعًا أمام التساؤلات، فلماذا يقف الناقد هذا الموقف الذي يسيءُ إليه، فيحكمُ على نفسه بالتَحُّيز اتباع الهوى واللاموضوعية والافتراء؟ ولماذا يخاف من التحدث عن عقيدةٍ جديدة؟ وهل هناك موضوعٌ محرم على الأقلام؟ أليس كل شيءٍ قابلاً للكلام؟
إن عظمة حليم دموش تكمن في شخصيته الفذة، ومواقفه السليمة الحازمة، وتواضعه الجم، وعقله النير المنفتح المنصف الذي يرفض الخطأ ويقبل الصحيح ويتبع الحق أنى وجده. ولولا هذه الصفات لما رضي بالتنازل عن مجده الدنيوي الذي بناه منذ حداثته، ليجبهَ كل الناسِ ويبتعد عن كل مَن يرفضُ توجُّهَه الجديد ولو كانوا أهل بيته، ويُقارعَ الحكام، ويدخل إلى المحاكم والسجون، ويحوِّلَ قلمَهُ من شعر المديح والرثاء والمجاملات إلى شعر النُّسك والتعبد والفضيلة والروحانيات.
إن عظمة حليم دمُّوس تكمن في تواضعه وصدقه. لقد رأى أن ما جاء به الدكتور داهش حقًا، فصدق وآمن وعمل بما يقتضيه هذا الإيمان. وكثيرون سواهُ رأوا ما رآه، لكنهم لم يفعلوا ما فعل، فأغضوا وأعرضوا فحملوا أنفسهم التبعات؛ ففي الإغضاء عن الحق وإنكار الحقيقة إثمٌ كبير. ونحن نؤكد للذين ظلموا حليم دموس فأهملوه أو اجتزأوهُ بسبب عقيدته، أن محاولاتهم كانت غير ذات جدوى، وكانوا كَمن يحاول إهمال الحقيقة أو اجتزاء عبير الورود وإطفاء نور الشمس، وأن حليم دموس وعقيدته ومؤسس عقيدته سوف يكبرون مع الأيام ويتألقون، في حين يصغر المفترون ويتضاءلون.
العهد الأول
إن مرور شاعر كبير كحليم دموس في هذه الدنيا ليس بالأمر العادي البسيط، فهو قد يحدث تغييرًا في ملامح وجهها ومسيرة حياتها؛ إذ إن هذا الشاعر لا يأتي مسالمًا أو يزور مسايرًا ومجاملاً، بل يأتي مسائلاً ومحاسبًا وناقدًا ومغيرًا. قد يشرب من زلالها ويطرب لجمالها؛ لكنه لن يسكت على ظلما وانحرافها وتهتكها وانغماسها بالشرور وعشقها للمعصية. سيحاسبها على كل حركة ونأمة... لكنها لن تستسلم... وينفجر الصراع.
بناءً على ذلك كانت حياة حليم دموس كثيرة الإثارة، تشبه إلى حد بعيد حياة الغرابة، لا سيما حين التقت حياةَ رجُلِ الرُوح المُعجز، فمالت إليها وألفتها وامتزجت بها، وشهدت صُنعَ الخوارق، وبشرت بها. وكان لنا من لقاءِ الحياتين أطيبُ الجنى: خيرٌ وخبزٌ وكتبُ شعرٍ ونثر، وزقاقٌ من خمرةِ السماء، وشجرُ محبةٍ ما زال ينمو ويكبرُ ويُرخي ظلالهُ على يباس هذه الغبراء. حياةُ حليم دموس حكايةٌ طويلة من العطاء وانضال والفداء والتضحية، تزدحم فيها الأحداث كما تزدحم في عرائس واديه العناقيد. عاشها الحليم ببراءة الطفل وحكمة الشيخ ولهفة العاشق وزُهدِ الناسك وعفة الثلج والزهر والطيوب.
لن أدخل في تفاصيل حياة حليم دموس رغم اعتقادي أن حياة الشاعر شأن عام، وخصوصياته ملك الجميع لما قد تشكله من نقاط ضوءٍ ونوافذ يمكنُ الإطلالُ منها على شخصه وأدبه. سأكتفي بإضاءة بعض الشموع، فالضوء الكثير كالظلمة الكثيفة، كلاهما يفسد الرؤية، ولا سيما إذا تعلق الأمرُ بالشعر، حيث يعذب الهمسُ، ويغني الإيجازُ والتلميح عن الإطالة والتصريح. وحسبي أن أذكر من حياته الخاصة ما له صلةٌ بحياة أدبه.
حليم دمُّوس صبيٌّ بين ثلاثة أشقَّاء هم فارس وميخايل وجورج، وشقيقتين هما سليمة ونجلا. والدهُ ابراهيم دموس رجل طيب مهذب يميل طبعه إلى الهدوء وإنشاء علاقات الود مع الآخرين، وهو شاعرُ معنى. ووالدته سيدة نعمة عبود. هكذا نرى أن لشاعرية حليم وأخلاقه الرفيعة جذورًا ي عائلته. وقد ظهرت عليه ملامح النبوغ منذ الصغر، وشهادة طفولته المميزة وصباه النابه معترفٌ بها من قبل معلميه، وممهورةٌ بتوقيع الشيخ ابراهيم اليازجي، وذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس الكلية الشرقية (بزحلة)، بولس الكفوري، قال فيها: "قد وقفت على ما انتقده أحد تلامذتكم النُجباء، حليم أفندي دمُّوس، على ما مرَّ به في بعض أجزاء "الضياء" فسرَّني ذلك غايةَ السرور. أكثرَ الله من أمثالهِ عندكُم...(5).
إلى البرازيل
وكأن زحلة ولبنان لا يتسعان لطموحه، فقد سافر الحليم إلى البرازيل عام 1905، ملتحقًا بإخوته. لكن الشعر يبقى دائمًا المسيطر ولو كانت أهداف الرحلة تجارية؛ فقد نظم أُولى قصائده من على ظهر الباخرة التي أقلته، وعنوانها "من بحر إلى بحر في بحر". ولدى وصوله إلى كورومبا، عاصمة ولاية ماتوغروسو، كان أول عملٍ قام به هو تعلم اللغة البرتغالية حيث ترجم أشعار كازمير دي أبراوا إلى العربية. وأخذ ينشر مترجماته وقصائده العربية الخاصة وفي خضم الأدب والشعر والمترجمات والنشر، نسي الحليمُ طموحه التجاري وأسس جمعية أدبية.
ومن ناحيةٍ أخرى، ظلت خيوط الذكريات والحنين تشده إلى النهر والوادي وملاعب الطفولة والأهل والأصدقاء، وأصوات لغة الضاد المنبعثة من أفواه الكتب والناس والمجلات والجرائد وأناشيد الظلال والينابيع، تلك الأصوات التي كان يفتقدها في رطانة المهاجر؛ كل ذلك جعلهُ يختصر غربتهُ في البرازيل التي لم تزد على ثلاث سنوات.
الزواج
بعد رجوعه من المهجر، تزوج الحليم بهيفاء تبشراني. ويبدو أنه كان مترددًا في الإقدام على هذا الزواج تتجاذبُه ذراعا لا ونعم؛ حُبُّه الرومانسي يشدُّه نحو الحبيبة، وعقله الراجحُ الذي يحدُسُ بالفشل ويدركُ طبيعة الزواج وتبعاته يقول له: لا
وقبل أن اتابع المسير مع الشاعر، تستوقفني قصيدةُ عزلٍ قالها للحبيبة قبل الزواج؛ منها:
أوَّاهُ! لو أنَّ شِعري
طيفٌ سَرى في الَمنامِ
لَزارَ جفنَكِ يَروي
عنِّي حديثَ غرامي
أوَّاهُ! كم أـمنى أن لا أتحدث عن هذين البيتين حتى لا أخدش رهافة الإيقاع أو أجرح النغم المتصاعد من بين حروفهما كالصلاة! كأن إلهة الحب سكبَت في قلم الشاعر بعض دمها فتحول إلى شعر كالطفولة رقة وعذوبة وعفوية وصدقًا وبراءة. كأنه صاعدٌ من غير شفاه، ومكتوبٌ على الورقة من غير قلم. كأنه الدفقة الأولى لنبع ينبجسُ من أعماق الروح في أقاصي النجوم.
وبعد الزواج، سكتت قيثارةُ غزلياته، ثم عادت بعد حين لتُعلمنا أن عازفها حبيسُ الندم.
كثرت شقوهُ الوَرى من قديمٍ
وتوالَتْ على النفوسِ الرزايا
والبلايا عديدةٌ في البرايا
غير أنَّ النِساءَ أصلُ البلايا
السجن
وللحديث عن السجونِ في حياةِ حليم دموس شجون وشؤون؛ فكأنه كان يؤدي ديونًا تراكمت عليه منذ عهدٍ قديم. لقد أودع السجن، وكادت التهمة تربطه بحبل المشنقة لولا تدخل العناية التي شاءت أن تدخر أنغامه إلى حين... إلى أ، تبثها من قيثارة الروح ضمن جوقة رسالة المحبة والهداية والجمال. لقد سجن الحليم وكاد يشنق من دون أن يعلمَ من أجلِ ماذا، ومن دونِ أن يقترف أي ذنب سوى الغناء. وخلاصةُ الحكاية الغريبة أن ابن عمه، شبل دموس الذي كان يتعاطى العمل السياسي، كتبَ مقالةً ضد الدولة العثمانية قبل أن يُغادرة البلاد. ولَّما لم يعثرُ له الأتراكُ على أثر، قبضوا على حليم وسجنوهُ وقدَّموه للمحاكمة، والحكم معروفٌ سلفًا وهو الإعدام. وكان بين حضور المحاكمة حسين بك الأحدب، الذي استاء من هذا السلوك الخشن للأتراك، وكان مقتنعًا ببراءة الحليم، فعمل على مساعدته وإنقاذه.
لحظات جحيم رهيبة عاشها الحليم. سجن وظلم ورجالُ سياسة وقانون وأدجب يلتف حبل مشنقةٍ على أعناقهم، الواحدُ تلوَ الآخر، حبلُ مشنقة جمال السفاح!
شاعرٌ رقيق عذب بريءٌ كل البراءة، نقي كل النقاء، يساقُ كالأثمة إلى المحكمة ثم إلى السجن ثم إلى قاب قوسين من المشنقة وينجو من حبلها بأعجوبة!... حادثة كأ،ها من فصول الخرافة أو قصة تمثل على مسرح في الجحيم. ما جرى كان يصعب إقناع الشاعر بأنه لا ينتمي إلى عالم أحلامه. هل يمر كل هذا من دون أن يترك أثرًا في نفسية الحليم وأدبه!
لقد شكلت هذه الحادثة، متزامنة مع أهوال الحرب العالمية الأولى، صدمةً عنيفة للشاعر ادخلته في صدفة أحزانه، وأباحته لهواجسه وتأملاته، وألقت به كالغصن الكسير فيم هب الذهول. ولم يكتف القدر بهذا القدر من المعاناة يسكبها في قلب الشارع المشرع أساسًا على العذاب، بل فجعه بموت ولده الثاني، شوقي. فرثاهُ ورثى نفسه في هذه الحياة الجحيم، وبكاهُ بعينين أصبحتا لا تريان في هذا العالم إلا القتام. كأن غيومًا جكناء احتشدت في جفنيه وقلبه الذي أذابه الألم الكبير ليجعل صاحبه الشاعر الكبير. فكانت قصيدته لولده الثالث يوم ولادته تنبضُ بالحكمة والفهم العميق للحياة والزُهدِ فيها. فكأنَّه الشيخُ المجرب الطاعن في الفلسفة والحكمة، وهو ما يزال في الثلاثين:
لا أُهنيكَ بالحياةِ فإني
قد قتلتُ الأيامَ، يا طفلُ، خُبرا
فرأيتُ الحياةَ لمًا سريعًا
ذاق منه الأنامُ حلوًا ومرًا
لا أهنيكَ بالطفولةِ أخشى
من اذاها وأنتَ لم تاتِ نُكرَا
لا أُهنيكَ بالشباب ففيهِ
نارٌ حبٍّ تُذيبُ قلبكَ قسرًا
لا أُهنيكَ بالكهولةِ إنَّ الـ
ــكهلَ يلقى مع الكهولةِ قهرا
لا أُهنَّيكَ بالمشيبِ ففيه
يسكنُ الشيخُ وهو في الحيِّ قبرَا
